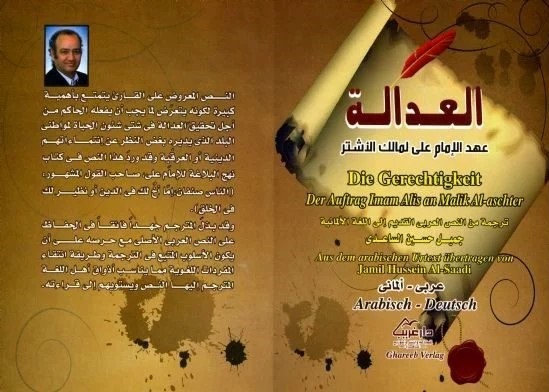قضايا
التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الفكر السياسي الإسلامي (3)
 ننتقل للجزء الثالث من حديثنا عن التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الفكر السياسي الإسلامي فنقول: يمكن أن نفسر كيف اتجه نظام الحكم فى الإسلام على عهد أبى جعفر المنصور فى مستهل الخلافة العباسية إلى صورة الملكية المطلقة، بعد الصورة الأولية "الأبوية" التى كانت على عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وبعد المحاولة المخفقة التى بذلها الأمويون فى دمشق، خصوصـًا ابتداءً من حــكم الوليــد، لإيجاد نظام إسلامى على غرار نظام الدولة البيزنطية، تلك الجارة التى لم يكن بد من التأثر بها: أولًا بحكم الجوار، وثانيًا بسبب التراث الإداري والتشريعي الذى خلفته وهى تولى هاربة أمام الجحافل العربية الإسلامية الظافرة فى البلاد التى كانت تبسط من قبل سلطانها عليها. وكان أمام أبى جعفر المنصور ومن خلفه من الخلفاء حتى عصر المأمون نموذجان بارزان للملكية المطلقة على أنقاضهما قامت الدولة الإسلامية، وهما: النظام البيزنطى، والنظام الساسانى والإيراني عامة. وكان طبيعيًا أن تتجه الأنظار أول الأمر إلى النظام الإيراني: أولًا لأن الذين قاموا بالثورة من أجل إيجاد الدولة العباسية كانوا من الفرس، فكان طبيعيا أن يكون للنفوذ الفارسي المكانة الأولى في التأثيرات الأجنبية في ذلك الحين؛ وثانيًا لأن الخلافة العباسية قامت في نفس البقعة التي كانت حاضرة الأمة الفارسية .
ننتقل للجزء الثالث من حديثنا عن التفسير السوسيولوجي لنشأة وتطور الفكر السياسي الإسلامي فنقول: يمكن أن نفسر كيف اتجه نظام الحكم فى الإسلام على عهد أبى جعفر المنصور فى مستهل الخلافة العباسية إلى صورة الملكية المطلقة، بعد الصورة الأولية "الأبوية" التى كانت على عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وبعد المحاولة المخفقة التى بذلها الأمويون فى دمشق، خصوصـًا ابتداءً من حــكم الوليــد، لإيجاد نظام إسلامى على غرار نظام الدولة البيزنطية، تلك الجارة التى لم يكن بد من التأثر بها: أولًا بحكم الجوار، وثانيًا بسبب التراث الإداري والتشريعي الذى خلفته وهى تولى هاربة أمام الجحافل العربية الإسلامية الظافرة فى البلاد التى كانت تبسط من قبل سلطانها عليها. وكان أمام أبى جعفر المنصور ومن خلفه من الخلفاء حتى عصر المأمون نموذجان بارزان للملكية المطلقة على أنقاضهما قامت الدولة الإسلامية، وهما: النظام البيزنطى، والنظام الساسانى والإيراني عامة. وكان طبيعيًا أن تتجه الأنظار أول الأمر إلى النظام الإيراني: أولًا لأن الذين قاموا بالثورة من أجل إيجاد الدولة العباسية كانوا من الفرس، فكان طبيعيا أن يكون للنفوذ الفارسي المكانة الأولى في التأثيرات الأجنبية في ذلك الحين؛ وثانيًا لأن الخلافة العباسية قامت في نفس البقعة التي كانت حاضرة الأمة الفارسية .
ومن هنا اتجه المتفقون والمفكرون السياسيون خلال العصر العباسي الأول إلى التراث السياسي الإيراني يستلهمونه أو ينقلون عنه المؤلفات التي يسترشد بها أولو الأمر في سياسة تدبير الملك وتدبير أمر الرعية، فقام "ابن المقفع" يترجم "كليلة ودمنة"، و"سير ملوك العجم"، فضلا عما ألفه من رسائل، مثل " الأدب الكبير " و " الأدب الصغير " وما إليهما. وكذلك أمثال ابن المقفع، كإسحق بن يزيد الذي نقل كتاب "سيرة الفرس"، المعروف بـ" اختيار نامة"، والحسن بن سهل الذي ترجم "جاويدان خرد "وعشرات غيرهم من الذين عنوا بنقل التراث الفارسي السياسي إلى اللغة العربية في أوائل عهد الخلافة العباسية .
وكان هدفهم من هذا كله تقرير قواعد نظام الحكم الجديد وبناء فلسفته السياسية، فأصبح الُكتاب حينما يعددون خصائص الأجناس ومفاخر الشعوب، إبان خصومة "الشعوبية" المشهورة في القرنين الثاني والثالث الهجريين يخصون الفرس بالتفوق في السياسة، حتى قالوا في هذا المعرض :" للفرس السياسة والآداب والحدود والرسوم، وللروم العلم والحكمة، وللهند الفكر والروية والخفة، والسحر والأناة؛ وللترك الشجاعة والإقدام "... واستقر آنذاك عند الناس أن الفرس هم أصحاب السياسة والسبب في هذا راجع إلى اتجاه الُكتاب العالمين بالفارسية وهم المقربون عند الخلفاء العباسيين الأوائل حتى عهد هارون الرشيد، إلى التراث الفارسي وحده .
وهكذا أصبحت القضية المحورية لدي خلفاء العصر العباسي الأوائل : هي قضية الموازنة بين عصبيات الأمة من جهة وبين (دعوة)، و(دولة) من جهة أخرى: دعوة تعتمد الجهاد لتحقيق الأمة في العالم؛ ودولة تريد قطعة محددة من الأرض تستطيع ضبطها بشروطها وعصبياتها، على أن يكون الإسلام هو السائد على هذه القطعة المحددة من الأرض؛ وهذا الأمر أثمر عن خروج المغرب العربي من قبضة الخلافة العباسية في عصرها الأول.
وإذا انتقلنا إلى العصر العباسي الثاني فقد شهد تفكك المشرق ذاته منذ منتصف القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي؛ فظهر الصفاريون بعد الطاهريين في خراسان عام 254هـ، وظهر السامانيون في بخاري قبلهم عام 250هـ، وظهر الطولونيون في مصر 254هـ، ثم بعدهم الإخشيديون عام 323هـ؛ وظهر الزيديون في اليمن 246هـ؛ والحمدانيون في الموصل وحلب عام 317هـ. ثم البويهيون في فارس والعراق، وقد تمكنت هذه الدولة بعد استقرارها في فارس – من السيطرة على مركز الخلافة، وإخضاع الخلافة العباسية لنفوذها المباشر، وذلك في عام 334هـ/946م. وإلي جانب هذه الولايات الإقليمية الكبيرة ؛ ظهرت إمارات صغيرة، تركزت حول بعض المدن الكبيرة، كما حدث في منطقة الجزيرة الفراتية وشمالي الشام، إذ خضعت هذه المناطق وغيرها لحكم بعض القبائل المتمردة .
هذا وقد وصل التفكك السياسي للعالم الإسلامي إبان العصر العباسي الثاني مداه بإعلان الفاطميين لخلافة فاطمية في المغرب العربي حتى استقرت في مصر والشام وإعلان الأمراء الأمويين عن خلافة أموية في الأندلس هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فقد شهد العصر العباسي الثاني أيضًا تقهقرا عباسيا أمام الدولة البيزنطية التي كانت تمر بدور من أدوار اليقظة أدي إلى عودتها إلى قوتها مرة أخرى في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال سقطت حلب في أيدي البيزنطيين عام 358هـ -969م، بعد اتفاقهم مع قائد مسلم أراد أن يكون صاحب الأمر والنهي فيها يستأثر بأمرها دون سعد الدولة بن سيف الدولة الحمداني. وكان اتفاقا مجحفا نص على تسليم هذا القائد حلب للبيزنطيين مقابل وعدهم له بأن يبقوا عليه حاكمًا من قبلهم. وكانت شروطهم التي أملوها عليه وقبلها صاغرا والتي ما وضعوها إلا ليثبتوا أن أيديهم هي العليًا وليست يد المسلمين حتى لو كان عاملها مسلما، هي أن يدفع المسلمون في حلب الجزية للروم وأن يعفي المسيحيون فيه من دفع أي مال للمسلمين.
وثمة نقطة أخرى جديرة بالإشارة هنا شهدتها هذه الحقبة وهي أن مرحلة انتقالية مهدت لظهور دولة المماليك في مصر والشام والحجاز؛ وهذه المرحلة الانتقالية تمثلت منذ أواخر القرن الخامس الهجري، عندما بدأت صفحة الصراع الإسلامي – المسيحي تأخذ منحني شديد الخطورة. وتمثلت خطورتها في أن الطرف غير الإسلامي فيه لم يكن هو الخصم الذي اعتاد المسلمون منازلته على مدار القرون الخمس الماضية، والذي أصابه الكبر والوهن (الدولة البيزنطية) كما أصابهم، ولكنه الآن خصم جديد له مطامع وحدت أركانه وجمعت شتاته تحت علم الصليب، فجاء ليواجه خصما منفصلة أعضاؤه منقسمة على بعضها البعض .
ويكفي للدلالة على مدى الخطورة التي شكلها الزحف الصليبي أن نمعن التفكير في معني إعفاء البابا الأسبان المسيحيين من الاشتراك في الحملة الصليبية ولكن من الوجهة الغربية (الأندلس). فالمد الصليبي على المشرق سبقه وزانه حركة استرداد مسيحي في المغرب، وهكذا توحدت أوربا المسيحية على العالم الإسلامي المفكك وهو في غفلة .
وإذا كان السلاجقة قد نجحوا في هزيمة حملة الجياع، وهي فئة في أول حملة صليبة على المشرق عام 1096م، تكونت من عشرات الآلاف من الجياع والفقراء والمغامرين، وكانت حملة شعبية غير منظمة فسهلت هزيمتها، فإن الأمر لم يكن بهذه السهولة مع الحملة الثانية، وهي حملة الأمراء أو الحملة النظامية التي شرعت في الزحف نحو المشرق في نفس الشهر التي هُزمت فيه حملة الجياع، وأهمية هذه الحملة أنها وضعت أسس التحالف والتعاون البيزنطي الصليبي ضد الطرف الإسلامي، فحملة الجياع أثناء مرورها بأراضي الإمبراطورية البيزنطية قامت بأعمال سلب ونهب جعلت الإمبراطور البيزنطي يندم على الدعوة التي وجهها لأوربا لطلب المساعدة، ولم يكن جنود الحملة النظامية أفضل حالا من الجوعى في الحملة الأولى، ولكن كان يمكن على الأقل بالنسبة للإمبراطور البيزنطي أن يتفاهم مع أمرائهم على صيغة للتعاون، فكان أن تم الاتفاق بينهم على أن أي أراضٍ يستعيدها الصليبيون مما فقدتها الإمبراطورية البيزنطية لصالح الدولة السلجوقية قبل "معركة ملاذكرد" ، فإنها تعاد إلى الإمبراطورية البيزنطية، أما فيما عدا ذلك فهو ملك لهم يقيمون عليه إماراتهم .
وكان إتمام هذا الاتفاق بين البيزنطيين والصليبين بمثابة توحد لأوربا الكاثوليكية مع أوربا الأرثوذكسية للهجوم على العالم الإسلامي، ولقد أثمر هذا الاتفاق آثاره؛ حيث ضمنت الدولة البيزنطية استعادة الأراضي التي فقدتها لصالح السلاجقة، وضمن أمراء أوربا إقامة دويلات خاصة بهم في الشام الذي أصبح المسرح الأساسي لأحداث الصراع بين المسيحيين والمسلمين.
وقد أخذ هذا الصراع شكلًا عجيبًا من العلاقات فيما بين المسلمين والصليبيين، فمرة يتحالف المسلمون مع الصليبين ضد بعضهم البعض من أجل أن يحتفظ بعضهم بكيان هش (دولة) ومرة أخرى يتحالفون فيما بينهم ضد الصليبين عندما يظهر لهم خطرهم مستشريًا، وهكذا كانت تدور المعارك بين المسلمين والصليبين سجالًا، أحيانًا ينتصر المسلمون وأحيانا ينهزمون، وكانوا عادة ما ينتصرون بتوحدهم في حلف جزئي، وأما هزيمتهم فكانت في معظم الأحيان لتفرقهم. ورغم بعض النجاحات الإسلامية التي كان بعضها محدود الآثار وبعضها الآخر ذا آثار عميقة، ولكن لم يقدر له أن يتوحد ليشكل حركة تحريرية كبري للغزو الصليبي .
ولذلك ظلت موازين القوى بين المسلمين والصليبيين دون تغير كبير، فالصليبيون يحتلون أجزاء متفرقة من الأقاليم تفصل بينها إمارات ومدن إسلامية والمسلمون يشنون على الصليبيين الغارات من آن لآخر يُهزمون أحيانًا، وينتصرون أحيانًا أخرى، ويحررون بعض المدن ليستردها الصليبيون مرة أخرى عندما تتغير علاقات التحالف بين المسلمين إلى التنازع والتنافر.
وإذا كان الفكر السياسي الإسلامي يتساءل خلال القرون الأولى من الهجرة عن كيفية تحقيق الأمة الإسلامية (التي تحققت فعلًا) هو الشغل الشاغل لخلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس الأوائل. فإن تحولا جذريًا طرأ على هذا السؤال، وبالتحديد خلال منتصف القرن السادس الهجري، ليكون السؤال: ما السبيل لتوحيد أمة الإسلام؟ أو كيف يمكن أن تتوحد أمة الإسلام أمام خطر الصليبين الماحق؟.
لقد كانت إجابة "عماد الدين زنكي"، في الشام واضحة وحاسمة إزاء الإجابة عن هذا السؤال، وذلك بأن رأي أن استقراء خبرة التاريخ السياسي الإسلامي، توضح أن وحدة المسلمين لن تتحقق إلا إذا فُرضت فرضًا وبالقوة. فكان لزاما عليه أن يقضي على الإمارات الصغيرة المجاورة للمستعمرات الصليبية والتي كانت دائمًا بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير، كما كانت العقبة الكئود لأي توحد سياسي بين قوى المسلمين. وقد تم لعماد الدين زنكي ما أراد؛ حيث نجح في أن يؤسس دولة في الموصل وأن يضم حلب، ثم رفع الجهاد ضد الصليبين، لكنه اصطدم بحالة التمزق السياسي التي كانت سائدة في المنطقة، فرأى ضرورة تجميع القوى الإسلامية، وحشد طاقاتها قبل القيام بأي خطوة إيجابية لمواجهة العدوان الصليبي، فنهض يعمل على ضم هذه القوى المشتتة. وبعد أن خطا خطوات واسعة في هذا السبيل، ونجح في ضم شمالي بلاد الشام إلى إمارة الموصل، نهض ليتصدى للصليبين، ونجح في تحقيق أهم إنجازاته التي بدأ فيها صفحة جديدة في ميزان القوى بين المسلمين والصليبين في المنطقة، وهي استعادة إمارة الرها من أيديهم. وكان لهذا النصر أهميته؛ حيث أثبت قدرة المسلمين على مجابهة الخطر الصليبي، بالإضافة إلى أنه أمَّنَ حرية الاتصال بين الموصل وحلب .
وقد تبعه ابنه نور الدين زنكي (511-569هـ)، الذي ظهر كشخصية فذة؛ فقد بدأ من حيث انتهى والده، وبذل جهدًا مضنيًا في سبيل إثارة الأمة وبعث روح الجهاد والتضحية بين جميع أفرادها في مناطق الشرق الأدنى الإسلامي. ونجح "نور الدين" في اكتساب ثقة العامة وجمع كلمتهم وبعد أن وحد قسمي بلاد الشام، الشمالي المتمثل بحلب، والجنوبي المتمثل بدمشق، وبسط هيمنته على الموصل؛ انطلق يجاهد الصليبيين، ويتصدى لتوسعهم على حساب المسلمين. ولعل أهم إنجازاته هي تحقيق الوحدة الإسلامية وجهاد الصليبين، وإسقاطه الدولة الفاطمية في مصر، وإعادة هذه البلد إلى حظيرة الخلافة العباسية والمذهب السني.
وهنا أخذ المسرح السياسي يتهيأ لـ" صلاح الدين الأيوبي" (532-589هـ)، ذلك القائد التاريخي الفذ في تاريخ الإسلام السياسي الذي نجح في تحقيق ما خاف منه الصليبيون دائمًا وحاولوا منعه، وهو توحيد جبهات مصر، والشام، والعراق ضدهم (لقد كان شعار صلاح الدين نبي واحد، تعاليم واحدة، أمة واحدة، ولتحقيق هذا كان ضربه لاعتبارات الزعامة والسلطة عرض الحائط. فكان له ما أراد عن طريق خطة سياسية واضحة المعالم ووعي سياسي سليم) فكال لأعداء الإسلام والضربات الموجعة التي انتهت باسترداد بيت المقدس؛ وظل يكيل الضربات لما تبقي من مستعمرات صليبية حتى لقي ربه مجاهدًا في سبيله، واستمر خلفاؤه في المحافظة على انتصاراته حينا وعقد معاهدات مع الصليبين أحيانًا أخرى، وبين كر وفر كانت موقعة المنصورة التي تصدي لها الملك الصالح "نجم الدين أيوب" (603-647هـ)، وانتهت بأسر "لويس التاسع عشر".
ولم يهنأ العالم الإسلامي بهذه الانتصارات حتى أتته ضربة المغول المدمرة فقضت على مركز الخلافة العباسية في بغداد، وواصلت الزحف على دمشق وباتت على أعتاب مصر. فما كان من مماليك نجم الدين أيوب إلا مواجهة المغول في عين جالوت فدمروهم وطردوا فلولهم من الشام.
وكان لمعركة عين جالوت أثر عظيم في تغيير موازين القوة بين القوى العظمى المتصارعة في منطقة الشام، فقد تسببت خسارة المغول في المعركة من تحجيم قوتهم، فلم يستطع القائد المغولي"هولاكو" (ت:1265م) الذي كان مستقراً في" تبريز"، من التفكير بإعادة احتلال الشام مرةً أخرى، وفوق هذا وذاك فقد تمكنوا من طرد الصليبين أيضًا من بلاد الشام ومصر، وتابعوهم إلى قبرص، فأخضعوا الجزيرة لسيطرتهم، ثم تعقبوهم إلى جزيرة رودس، ولولا الدعم الأوربي الصليبي الكبير للحقت رودس جزيرة قبرص في تبعيتها للمماليك .
وخضعت بلاد الحجاز للمماليك، وهي مهوى أفئدة المسلمين في كل مكان، حيث بيت الله الحرام، ومهبط الوحي، ومنطلق الدعوة، ومدينة الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهذا ما جعل لهذه الدولة مكانة خاصة في سائر بلاد المسلمين إضافة إلى لفٌها خلفاء بني العباس وابنائهم، وإعادة الخلافة بعد سقوطها، وهذا ما زاد من مركز دولة المماليك وهيبتها .
رابعًاً : التفسير الاجتماعي وتطور منهجية الفكر السياسي الإسلامي.
إذا كان الواقع السياسي العام في العصر العباسي وتراكماته التي أوصلتنا إلى الواقع السياسي في القرنين الثامن والتاسع الهجريين، فإن هذا الواقع قد انعكس بدوره على الفكر السياسي الإسلامي، وآية ذلك أن الكتابات السياسية التي ظهرت في تلك الحقبة الهجرية المتطاولة قد ارتبطت بهذا الواقع.
1- فمثلًا سنجد أن فترة الخلافة العباسية الأوائل (والتي يرجع التراث السياسي الإسلامي لمعظمها)، وخصوصًا فترة العباسيين الأول، فترة التراجم الكبرى، وفترة بيت الحكمة، وسنجد أن نوع الكتابات السياسية فيها يدور حول السلوك المثالي السياسي وارتباطه بالأخلاق – سلوك أمة متسعة الأرجاء، عظيمة الهيبة، تضم العديد من الشعوب، وتخضع لقيادة واحدة، ومن ثم اتخاذ هذا السلوك منطلقا لتقديم النصائح للخلافة في كيفية إدارة الأمة .
ويمكن توضيح ذلك بشيء من التفصيل: في هذا العصر قامت حركة التأليف والترجمة والتدوين على قدم وساق، وجميع ما خلفه المسلمون الأوائل يرجع تقريبًا لهذا العصر، أو إلى أصول وضعت في هذا العصر، وكان العباسيون يهتمون قبل كل شيء بتركيز دعائم ملكهم: لهذا كانت حرية الرأي على مبلغ احترامهم وعظم مكانتها في الإسلام – مستظلة إلى حد ما بلواء العباسيين؛ وقد كان للعباسيين خصوم من العرب يمثلهم بنو أمية الذين استطاعوا ابتناء ملك واسع ومجد عريض في الأندلس، يماثل إن لم يفق ملك بني عباس ومجدهم في الشرق ؛ وخصومهم من غير العرب يتزعمهم ويثيرهم ابناء عمومتهم العلويون؛ وفي ظلال الحكم العباسي تنبهت القوميات الغافية، وتحركت الأطماع في نفوس كثيرين من ابناء الأمجاد الأولى التي غلبها الإسلام؛ ولهذا رأى العباسيون أن من حقهم أن يشرفوا على توجيه البحوث ومراقبة الإنتاج الفكري في ملكهم، فعني مفكرو الإسلام في عهدهم من علوم اليونان والفرس وغيرهم من الفنون التي كانت غير معروفة لهم، وكانوا يصرفون عنايتهم إلى هذه العلوم على قدر ما يرون لها من فائدة وعلى حسب ما تمس الحاجة؛ فأقبلوا على العلوم الرياضية والطبيعية والفلسفة والمنطق بمجامع قلوبهم . وللحديث بقية !!
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل - جامعة أسيوط