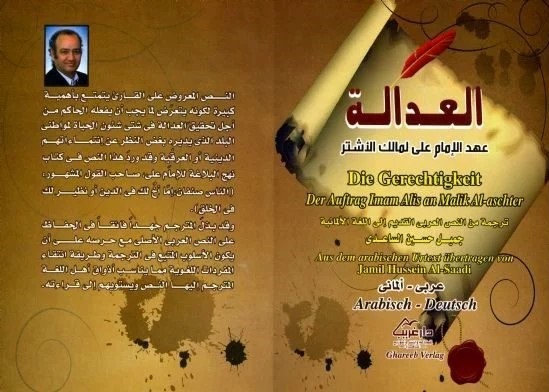قضايا
من الخلافة الراشدة إلى الآداب السلطانية (2)
 نعود ونكمل حديثنا من الخلافة الراشدة إلي الآداب السلطانية وفي هذا يمكن القول : لقد لقيت أفكار ابن ابي الربيع صدي في القرن الرابع الهجري لدى "أبو نصر الفارابي، الفيلسوف المشهور الذي لُقِّب بالمعلم الثاني، المتوفى 339 هـ/950م، وقد ألَّف كتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة"، الذي يعالج فيه تنظيمَ الدولة بطريقة فلسفيَّة استغرقتْ معُظمَ كتابه، وكان يهدف إلى الوصول إلى غاية الغايات، وهي "السعادة"؛ ولكنَّنا نجده في الثُّلُث الأخير منه يبيِّن الشروط التي ينبغي أن تتوفَّر في رئيس الدولة أو الإمام، وإذا عزت هذه الشروط في واحد، فلا بأسَ من اختيار اثنين أو أكثر، يكمل بعضُهم بعضًا، ويمثِّل الفارابيُّ اتجاهَ الفلاسفة الإسلاميِّين في التفكير السياسي؛ حيث "يحلق بفكره في سماء المثاليات، فقامت فلسفته على أساس البحث النظري أو الخيالي أو المجرد، نتيجة الشعور بعدم الاقتناع أو بعدم الرضا بالأوضاع القائمة، والرغبة في إقامة نظام مثالي يتلافي عيوب النظام الموجود ويحقق المزايا المنشودة ".
نعود ونكمل حديثنا من الخلافة الراشدة إلي الآداب السلطانية وفي هذا يمكن القول : لقد لقيت أفكار ابن ابي الربيع صدي في القرن الرابع الهجري لدى "أبو نصر الفارابي، الفيلسوف المشهور الذي لُقِّب بالمعلم الثاني، المتوفى 339 هـ/950م، وقد ألَّف كتاب "آراء أهل المدينة الفاضلة"، الذي يعالج فيه تنظيمَ الدولة بطريقة فلسفيَّة استغرقتْ معُظمَ كتابه، وكان يهدف إلى الوصول إلى غاية الغايات، وهي "السعادة"؛ ولكنَّنا نجده في الثُّلُث الأخير منه يبيِّن الشروط التي ينبغي أن تتوفَّر في رئيس الدولة أو الإمام، وإذا عزت هذه الشروط في واحد، فلا بأسَ من اختيار اثنين أو أكثر، يكمل بعضُهم بعضًا، ويمثِّل الفارابيُّ اتجاهَ الفلاسفة الإسلاميِّين في التفكير السياسي؛ حيث "يحلق بفكره في سماء المثاليات، فقامت فلسفته على أساس البحث النظري أو الخيالي أو المجرد، نتيجة الشعور بعدم الاقتناع أو بعدم الرضا بالأوضاع القائمة، والرغبة في إقامة نظام مثالي يتلافي عيوب النظام الموجود ويحقق المزايا المنشودة ".
ولتحقيق هذه الغاية راح "الفارابي" يقرأ المؤلفات السياسية لكل من "أفلاطون" و"أرسطو" التي قد تُرجمت في أيامه، واهتم الفارابي بكتب أفلاطون السياسية اهتمامًا بالغًا، وواسعًا جدًا، لم يتعامل معها إلا من الزاوية الميتافيزيقية. صحيح أن العلاقة بين السياسة والميتافيزيقا في الفكر اليوناني علاقة عضوية ووشيجة، ولكن ما يجب الانتباه إليه ، هو أنه بينما بنى اليونان مدينتهم الإلهية (الميتافيزيقا) على غرار مدينتهم السياسية، قلب الفارابي الوضع قلبًا، إذ راح يشيد المدينة الفاضلة، مدينته السياسية، على غرار المدينة الإلهية التي شيدتها الفلسفة الدينية الحرانية الهرمسية على أساس فكرة الفيض كما ذهب بعض الباحثين .
ليس هذا وحسب بل لقد ربط الفارابي "الصلاح" في السياسة بـ "صلاح" المعتقدات الدينية الفلسفية؛ وهنا يلتقي الفارابي مع الأدبيات السلطانية ليس فقط في مجال المماثلة بين الإله، أو السبب الأول، وبين الخليفة أو رئيس المدينة الفاضلة، وهي المماثلة التي سادت الخيال الديني والسياسي في العصر العباسي، والمنقولة من الموروث الفارسي، بل يلتقي معها في المنطلق أيضًا. ذلك أن وجود رئيس المدينة الفاضلة سابق عند الفارابي على القول في شكلها وصفاتها، تماما مثلما أن وجود "الأمير" عند المؤلفين في "الآداب السلطانية" سابق على النصيحة التي تقدم له. إن الفارابي يؤكد في جميع كتبه التي تناول فيها موضوع "المدينة الفاضلة" على فكرة أن "رئيس هذه المدينة ينبغي أن يكون هو أولًا، ثم يكون هو السبب في أن تحصل المدينة وأجزاؤها، والسبب في أن تحصل الملكات الإرادية التي لأجزائها في أن تترتب مراتبها، وإن اختل منها جزء كان هو المرفد له بما يزيل عنه اختلاله" .
ولا علاقة بهذا الذي يقرره "الفارابي" كمبدأ وكمنطلق مع ما نجده عند "أفلاطون" في هذا الشأن، من كون رئيس المدينة الفاضلة يجب أن يكون فيلسوفًا قد تم إعداده عبر مراحل من التعليم وطوال عقود من السنين. فالفارابي لم يهتم قط بهذا الجانب الذي شغل أفلاطون كثيرًا في تشييده للمدينة الفاضلة، جانب الإعداد بالتربية والتعليم لـ "الحفظة"، وهم رجال الدولة من موظفين وجنود الخ. إن تفكير الفارابي قد اتخذ منحى آخر مخالفًا تمامًا، منحى يكشف عنه عنوان كتابه الأساسي في الموضوع: "كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة". إن المدينة تتلخص، من منظور الفارابي، في "آراء" أهلها، فهي فاضلة إذا كان أهلها يعتقدون في "المبدأ الأول" (الله) وفي "الثواني" أي العقول الفلكية التي هي الملائكة في نظره، وفي صدور الموجودات عن المبدأ الأول بواسطة الثواني وفي العقل الفعال، الذي هو ملاك الوحي الخ، اعتقادات "صحيحة"، يعني تلك التي ذكرها هو كـ "آراء أهل المدينة الفاضلة".
وفي القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، نلاحظ أنَّ علم السياسة أخذ يتشكَّل في هيئة كتب متخصِّصة متفردة، تعالج نُظمَ الدولة في شمول، وأسست على
الشريعة من فقه وقضاء وحديث، كما استفادتْ - في حدود - من كتابات ابن المقفَّع، والأبواب التي احتوتْها كتبُ الأخبار والأدب والسمر. وأول هذه الكتب "الأحكام السلطانية"؛ لمؤلِّفه "أبو الحسن الماوردي"، المتوفى 450 هـ/1058م، الذي يعد قمَّة ثالثة، وكتابه هذا أوَّل كتاب منهجي وافٍ في موضوعه، ويتميَّز بدقته في عَرْض مسائله.
وفي هذا الكتاب استطاع " الماوردي "، أن ينقل إشكالية الدولة والمُلك من مستواها الكلامي، إلي مستواها الفقهي العملي، ليجد لها أصولها الفقهية التي ترتفع بها إلي مستوى القضايا المُؤسِسة للمذهب الفقهي، ومن المؤكد أنه كان لحالة الوهن التي تخبطتْ فيها الخلافة سهمها البارز في إقدامه على هذا العمل؛ إذ إننا أمام خطابٍ خرج من جوف أزمةٍ سياسيةٍ خانقة، وراهن في الآن ذاته على بناء مشروعٍ إصلاحيٍ من شأنه أن يُنقذ ما تبقى من الخلافة المتآكلة. وقد اقتضى منه ذلك التحرك على جبهاتٍ فكريةٍ متعددةٍ جعلتْهُ يتنقل بسلاسةٍ عز نظيرها من الفقه إلى آداب النصيحة، ومن النوازل القضائية إلى الأحكام السلطانية، لينتهي به المطاف إلى إنشاء نمطٍ فريدٍ من الكتابة الفقهية السياسية، تُواءم بين نَفَسِ النصيحة والفقه .
وفي أواخر هذا القرن ومطالع القرن السادس الهجري نَلْقى "أبا حامد الغزالي"، المتوفى 505 هـ/1111م، الذي ألَّف أكثر من كتاب في الفِكر السياسي، أشهرها "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، وقد وَضَعه بالفارسية، وقدَّمه إلى السلطان السلجوقي آنذاك، وتُرجِم إلى العربية، ويُسْلِمُنا تحليلُ الكتاب إلى أنه ينتمي إلى وعْظ الحكَّام وتذكيرهم، وهو من فصيلة "نصائح الملوك"، أو "مرايا الأمراء". ومثله في أوائل القرن السادس الهجري نفسه، نَلْقى الطُّرطوشي، المتوفى 520 هـ/ 1126م، صاحب كتاب ذائع الصيت "سراج الملوك"، وهو وإن انتمى إلى الفصيلة التي ينتمي إليها كتابُ الغزالي "التبر المسبوك "، إلاَّ أنَّه عقَدَه على أربعة وستِّين فصلاً، وأفاض فيه وفصَّل على نحو لم يَرِد في كتاب الغزالي.
ونقفز بعد ذلك نحو قرنين من الزمان، لنَلْقى كتاب "الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية"، لصاحبه ابن الطِّقْطَقي (أو ابن الطِّقْطَقَا)، المتوفى 709 هـ/1309م، وهو كتاب يتناول تاريخ الدول الإسلامية وسير خلفــائها إثر سقوط بغداد في أيـدي المغول عام 1258، وأهداه إلى وإلي الموصل ، وهو " فخر الدين عيسى بن إبرهيم"، وسماه "الفخري" نسبة إليه.
وبعد نحو عَقْدين من القرن الثامن الهجري نفسه، نَلْقى ابن تَيْمِيَّة، المتوفى 728 هـ/1328م، المعروف بأنَّه داعيةُ إصلاح في الدِّين، وقد لاحظ واقعًا مريرًا، فألَّف غير كتاب في السياسة الشرعية ونظم الدولة، أبرزها كتاب "السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية"، وهو مُقامٌ على الشريعة، وهدفه الأعلى إشاعةُ العدل، ورفْع الظلم عن الناس. وقد كانت أفكار ابن تيمية السياسية قد لقيت ترحيبًا لدى "ابن القيم الجوزية " الذي ألف كتابه " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ".
وفي نهاية القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجري، يجيء "عبد الرحمن بن خلدون" (ت: 808 هـ/1406م)، الذي وضع في "مقدمته" الأسسَ الأولى لنظرية العصبية. فلقد بنى ابن خلدون نظريته في الحكم على العصبية، وبما أن نظام الخلافة هو أحد أنماط فلسفة الحكم الخاص بالإسلام ، فقد تناوله ابن خلدون بالدراسة والتحليل في سياق تطوره. فالخلافة نشأت وتطورت، ثم انتقلت من خلافة إلى مُلك عضود بمقتضى العصبية، وهنا يحاول ابن خلدون أن يفلسف التاريخ إلى عهده، وهي محاولة فريدة شهد لها كثير من الباحثين ؛ بأنها لا يوجد لها مثيل في تراثنا العربي الفكري على ضخامته، وتنوع منازعه، وتعدد مشاربه. لقد كون ابن خلدون لنفسه تصورًا خاصًا به للتاريخ الإسلامي ومسيرته، وهو تصور مستمد من ظروف تجربته، ووقائع عصره والمعطيات الاجتماعية والتاريخية للمجتمعات التي عاش فيها ودرس أحوالها .
وفي أواخر القرن التاسع الهجري جاء "أبو عبد الله بن الأزرق" (ت:896هـ) قاضي غرناطة ووزيرها وسفيرها في أيامها الأخيرة، في كتابه "بدائع السلك في طبائع الملك"، والذي لخص فيه ما يتصل بموضوع كتابه في مقدمة ابن خلدون وغيرها من كتب تدبير الملك، مع زيادات كثيرة. إلا أنه غالباً ما يكتفي بكلام ابن خلدون. وقد رجع في كثير من فصوله إلى كتاب أرسطو (السياسة في تدبير الرياسة)، وفي هذا الكتاب ظهر نوع جديد من الاجتهاد السياسي الإسلامي في مجال السياسية الشرعية، حيث كان قد توقف المسلمون عند كتب السياسية الشرعية القديمة مثل الأحكام السلطانية والولايات الدينية، للقاضي الماوردي، في الفقه السياسي الشافع، ثم كتاب الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى الفراء، ثم كتاب "غياث الأمم في التياث الظلم" للإمام الحرمين الجويني، ثم كتاب "السياسة الشرعية" لأبي العباس ابن تيمية، وأخيرًا كتاب "الطرق الحكمية" لابن القيم . إلا أن كتاب العلامة ابن الأزرق خرج بطابع فريد عن هذه التصنيفات الأخرى فلخص ابن الأزرق في بعض فصول كتابه مقدمة ابن خلدون عارضاً لنظرياته ونظمها تنظيماً منهجياً، ولكنه تجاوز ابن خلدون تجاوزاً كبيراً ؛ حيث كانت خطة ابن الأزرق أن يورد النص الخلدوني، إما كما هو، وإما يلخصه، وإما أن يفسره، ثم يعلق عليه بأقوال أخرين، مؤيدين ومعارضين، وبآرائه هو مؤيدًا أو داحضًا.
ويقدم كتابنا هذا أطروحة السياسة من المنظور الإسلامي، ويأتي في هذه الفترة؛ لتحسين الصورة التي اتسم بها الفكر السياسي الإسلامي، بوصفه الفكر الأكثر رجعية، وأنه يؤسس للحاكم الثيوقراطي – السلطان الذي هو ظل الله في الأرض، فيكون الإسلام من هذا المنظور الأساس الأول للإرهاب والتطرف السياسي، القائم على دعائم الديكتاتورية والتسلط والجور. ويأتي الكتاب للدفاع عن العقيدة الإسلامية، من خلال التأكيد على أن كل الأفكار السياسية الإسلامية المطروحة على الساحة تمثل الفكر الديني وليس الدين نفسه. فإن كانت الأفكار صحيحة تقود إلي التقدم والرقي كان هذا بسبب التفهم الصحيح لنصوص الدين، وإن كانت الأفكار غير صحيحة تؤدي إلي السقوط والانهيار، كان هذا جراء الفهم غير الصحيح لنصوص الدين. ويبقى الدين الصحيح العلامة الفارقة التي به تنصلح أحوال الأمم، فبوجود الدين تتحسن الأحوال وبغيابه تسوء وتتدهور.
فمن الضروري في هذا المقام " دراسة السياسة الإسلامية"، ثم بيان وتوضيح الفرق بين الإسلام كديانة، وبين ما يدور حوله من أفكار – الفكر الإسلامي، أو بالأحرى بيان وتوضيح ودراسة صلة القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة بالفكر الإسلامي؛ وذلك لإزالة الوهم والزيغ الناشئ عن الخلط بين الإسلام والفكر الإسلامي، وتحميل الإسلام مسئولية التخلف الحضاري الذي تعيشه الأمة الإسلامية في العصر الحاضر، وعلى الرغم من أن الفرق بينهما واضح بشكل قد لا يحتاج إلي إرهاق العقل لبيانه وتوضيحه، فإن الخلط بينهما لا يزال قائمًا بسوء نية أو بحسن نية، لـقصور في الفهم أو لأجـل مصالح شخصية ترتبط بالسياسة أو الاقتصاد، فتأتي الأفكار الخاصة بهم لتُحمل النص الديني ما لا يحتمله.
فالدين الإسلامي يتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يمكن أن يتخلى طرف منهما عن الآخر، فاليوم نجد من يؤمن بالقرآن ولا يثق بالسنة، والسنة ما هي إلا تفصيل مجمل القرآن وبيان مشكله، وبسط مختصره. وللتأكيد على ضرورة السنة إلي جانب القرآن نجد قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – الذي رواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة: " تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي". ويقول تعالى في محكم تنزيله: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نُزل إليهم ولعلهم يتفكرون". (سورة النحل: الآية44). وقوله: "وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا". (سورة الحشر: الآية7). وقوله تعالى: "من يُطع الله فقد أطاع الرسول". (سورة النساء: الآية 80). هذا هو الدين الإسلامي قرآن وسنة فيه من الأخلاق ومكارمها، والسياسة وحكمتها.
أما الفكر الإسلامي فهو اجتهادات المسلمين في مختلف مجالات الحياة والعلوم والأمور الدينية والدنيوية، وهي اجتهادات بشرية غير معصومة من الخطأ فهي عرضة للصواب والخطأ. ويعبر عن ذلك ما ورد عن الإمام الشافعي: "رأينا صواب يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب"، والفكر الإسلامي المتبع لما في القرآن والسنة الصحيحة هو الفكر الصحيح، وإن ضل ما فيهما كان فكرًا إنسانيًا لا يتسم بسمة الإسلام من قريب أو بعيد. فالفرق واضح وضوح الشمس بين الإسلام والفكر الإسلامي، ولا يجوز الخلط بينهما. صحيح أن الفكر الإسلامي من شأنه أن يسترشد بتعاليم الإسلام ويستضيء بنورها ويجتهد في فهم هذه التعاليم، ولكن ما ينتهي إليه من نتائج يبقى في إطاره الصحيح وهو الإطار البشري .
فالسياسة كي تنتسب إلي الإسلام لا بد من أن تنهل، وتستقي أفكارها من القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية الشريفة. وبالنظر إلي السياسات الراهنة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وما حولها من مجتمعات غربية أوروبية، لا يمكننا أن نتلمس بذور السياسة الحقة التي يمكن أن نعتمد عليها كمنهج في الإدارة، أو كطريقة لإصـلاح أحوال البلاد وتجاوز المشكلات التي تستوقفنا في كل لحظة من لحظات الزمن. فالسياسة العالمية المعترف بها اليوم هي سياسة القوة، إنها السياسة التي تقوم وفق قواعد وتعاليم النظرية الداروينية، سياسة لا تعرف للقيم والفضائل معنى، إنها سياسة تُبنى على القهر والسيطرة والاستبداد، سياسة تقوم على ظاهرة العولمة، لا تراعي الاختلافات الجغرافية للمكان ولا السيكولوجية والسوسيولوجية للمواطنين، ولا المعتقدات الدينية والذرائع الأخلاقية داخل الدولة موطن السياسة. فاليوم غاب عنا مضمون السياسة الإسلامية وصرنا نتمسك بالشكل الصوري المفرغ من المضمون، فغاب عنا ما كنا عليه عندما أخذنا وأسسنا سياسة دولتنا على قواعد وحدود الشريعة الإسلامية. فمن حال إلي حال، وبالنظرة العابرة نُدرك أن السبب هو تخلينا عن قيم الدين. وجملة القول في هذا أن السياسة المعاصرة، لا يمكن وأن ندنس بها الدين أو الفكر الديني الصحيح، ونقول إنها سياسة شرعية أو ربانية، ولكن سياسة شيطانية تُحيك الخطط والمؤامرات لقهر الغير والفتك به لمجرد أنه شريك في الإنسانية.
وخلاصة القول فإن السياسة الحقة، هي التي تقوم على أسس، أهمها الحكم بما أنزل الله، والشورى في إدارة شئون الدولة أو الرعية، وتحقيق المصلحة العامة، حتى وإن تعارضت مع المصالح الخاصة. ولما كان الشرع هو الركن الأساسي في كل السياسات، فإن السيادة لا تكون إلا لشرع الله، وقد تتمثل تلك السيادة في قوة السلطان القاهر، أو إجماع الأمة، أو أهل الحل والعقد، وبعيدًا عن السيادة ولمن تؤول، فالسياسة أو الإمامة من الأمور الضرورية الواجبة التي لا بد للرعية من أن تخضع لها لضبط شئونها - "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" . وهذا ما نصت عليه تعاليم الدين، وتابعها في ذلك أفكار المجتهدين المسلمين من أئمة وفقهاء وفلاسفة ومتكلمين. وتأتي نظريات مفكري الإسلام لبيان قيمة الدولة ، أو الإمام، وتوضيح نظرية السيادة والكشف عن معالمها، والكشف عن نظرية العلاقة بين الحاكم والمحكوم . وهذا ما حاولنا توضيحه في هذا الكتاب، محاولين توجيه العقل الإنساني إلي الفكر السياسي الحق الخالى من التوجهات الخاصة التي تهدف إما إلي تلويث سمعة الإسلام، أو الاستئثار بالسلطة تحت رايته، مؤكدين على أن الفكر الإسلامي، لا يرتبط بالضرورة بالدين الإسلامي نفسه، حتى لا نسحب أحكامنا على الفكر الإسلامي على الدين نفسه، فنكون بهذا ضللنا الصواب.
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط