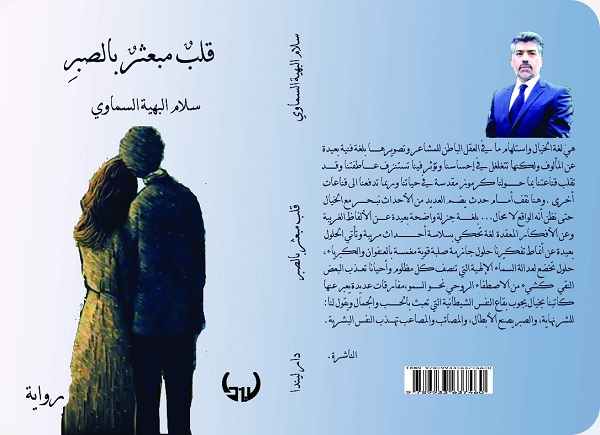قضايا
الوطن من الانطواء إلى الانضواء
 لم يظهر مصطلح «الوطن» في كتابات المفكرين العرب في العصر الحديث إلا في سياق مثقفات وأحاديث أهل الرأى وأمراء المنابر وقادة الفكر، حول قضايا الوعى والهُويّة والولاء والانتماء، ذلك على الرغم من حضور مفهوم «الأمة» و«الروح الجمعى» في ذاكرة الرأى العام العربى والإسلامي بمختلف طبقاته، ولا سيّما في ظل الاحتلال العثماني للعالم العربى.
لم يظهر مصطلح «الوطن» في كتابات المفكرين العرب في العصر الحديث إلا في سياق مثقفات وأحاديث أهل الرأى وأمراء المنابر وقادة الفكر، حول قضايا الوعى والهُويّة والولاء والانتماء، ذلك على الرغم من حضور مفهوم «الأمة» و«الروح الجمعى» في ذاكرة الرأى العام العربى والإسلامي بمختلف طبقاته، ولا سيّما في ظل الاحتلال العثماني للعالم العربى.
الأمر الذى يبرر خلط أكابر الكُتّاب المصريين والشوام بين عدة مصطلحات ظهرت جميعها في أخريات القرن التاسع عشر (الأمة، الوطن، القومية، الجامعة الإسلامية، الرابطة الشرقية، الثقافات العرقيّة).
وعليه لا ينبغي علينا النظر إلى حديث «حسين المرصفي» عن الوطن بعين الناقد الذى يأخذ عليه خلطه بين مفهوم الأمة والوطن والروح الجمعى في كتابه (رسالة الكلم الثمان)، وذلك لأن معظم معاصريه في الثقافتين العربية والغربية لم يهتموا بتحديد مواطن الفصل بين تلك المصطلحات المتشابكة آنذاك.
بيّد أن ما يميز تعريف «المرصفي» للوطن هو تمييزه بين دائرتين متداخلتين للولاء والانتماء، فأوضح أن هناك وَلاءَ عاماً للثقافة التى نتحدَّث بلغتها المتمثلة في مصطلح الأمة العربية أو الأمة العربية الإسلامية، ودائرة ثانية تحمل بين طياتها المشخصات والسمات الذاتية التى تشكل كيانها وصلب بنيّتها، وتلك المشخصات تبرز في مجتمع الوطن أو الدولة، ويحملها جُلَّ أفراده أى إنها تمثل الروح الجمعى أو العقل الجمعى، والعلاقة بين مصطلح «الأمة» و«الوطن» هى علاقة الكل بالجزء.
ومن ثم، نجد مفكرنا يعرف «الوطن» بأنه مكان السكنة، وهو الأرض الذى يحوى أفراد المجتمع بمختلف طبقاتهم، وهو أيضًاً البدن الحاوي لعقل ووجدان وتراث وإرادة الروح الجمعى على مر العصور، فإذا كان الفرد ينطوي على ذاته ويسكن إليها ويعمل جاهدًا لإسعادها ولا يجبن لحظة في التضحية من أجل حمايتها؛ فينبغي أن يتحول هذا الانطواء إلى انضواء، فالوطن بالنسية لكل أفراد المجتمع هو الذات العليا التى يجب على كل أفراد المجتمع الذين ارتضوا السُّكنة فيه أن يعملوا متعاونين من أجل مصلحته ومنفعة كل أفراده بمنأى عن مطامع الأنانية وعصبية العنصرية والانتماءات القبلية والعرقية، فيصبح الوطن بذلك هو مركز من اهتمامات الأنا وأن معيار المواطنة هو الإخلاص في العمل والتفاني في التعاون من أجل الصالح العام، ويقول: «الروح وطن لكونه مسكن الإدراكات، والبدن وطن لكونه مسكن الروح، والثياب وطن لكونها مسكن البدن، والدار والدرب والمدينة والقطر والأرض والعالم كلها أوطان لكونها مساكن».
ويسترسل مفكرنا مخاطبًا الشباب مبينًا لهم أنه إذا كان البدن لا يحيى إلا بالروح ولا تستقيم الروح إلا بالعقل؛ فإنّ المواطنين لا تنجح أعمالهم ولا تسلم أفعالهم من الشرور والفساد إلا بالعقل الواعي الذى لا يتحقق سوى في علماء الأمة، أو إنْ شئت قل قادة الرأى، الذين تنزهت آراءهم عن المصالح الذاتية والانطواءات الشخصية والانضواءات الطائفية، أى أنهم أولئك الذين أخلصوا في حبهم للوطن حتى فنوا فيه، وأيقنوا أن لا بقاء لهم إلا ببقائه وسلامة وأمن كل من يعيش فيه، ويصف علماء الوطن بقوله: «إن مرشدك إلى ذلك الحافظ من الزيغ والذلل فيه هم عقلاء العلماء، الذين ترى في ظاهر شمائلهم من حسن السمت وجلال الوقار وانضباط الأعمال والتصون عما يوجب أدنى نفور منهم، فلا ينطقون إلا بالحكمة، ولا يعملون إلا وفق المصلحة، حتى يعم الجميع الأدب، ويظهر فيهم تمام الاستقامة».
وحسبنا أن نوضح أن مفكرنا يقصد بقادة الفكر، العلماء المعلمون المنوطون بالتربية والتوجيه والتوعية، وارتقاء الأذواق واستقامة الأفكار وتثقيف الأذهان وتقويم السلوك وتهذيب الأخلاق دون غيرهم، الأمر الذى يبرر حملته على مزيفي الوعى، ومحترفي الإضلال والمفسدين والمدَلِّسين الذين يخدعون الرأى العام بمعسول كلامهم عن الدين أو القيّم والمبادئ والمُثل العليا، وهم أبعد عن ذلك بعد اليم عن الشمس؛ محذرًا الشباب من الإصغاء إليهم بلا تفكر، ومنبهًا ولاة الأمر إلى ضرورة فحص شعاراتهم وخطاباتهم وأثرها على العقل الجمعى للوقوف على منافعها وأضرارها، كما يناشد المثقفين ألا ترهبهم كثرة المنافقين والمتاجرين بالكلم ولا مناصبهم ونفوذهم، فالسكوت على إفسادهم ضياع للوطن وخيانة للعلم ورسالة الحق التى حملوها خلفًا للأنبياء، فينبغي عليهم فضح أغراض مثل هؤلاء والتصدي لهم بكل حزم وحسم.
ويقول «كان من الواجب على ولاة الأمر أن لا تحدث في الإسلام أمثال هذه البدع التى يحسبها الجهال من فروع الدين، فيدخل الخلل على احترامهم له واعتبارهم إياه؛ حيث يتعقلون ويستبصرون عند أوان ذلك، فمن الجهال من تكون له فطنة جيدة بحيث يهتدى بفكر نفسه إلى ما ينفع وينبغي أن يكون دينًا متعبًا وما لا ينفع وينبغي أن يكون أمرًا مجتنبًا، فهم على ما هم عليه من احتقار ذلك في نفوسهم وطويات أسرارهم، وإن كان الخوف يمنعهم من مُشافهة ذوى المكر، الذين اتخذوا تلك الأعمال إشراكًا لصيد معايشهم، ومكنوها في نفوس أهل الغفلة الذين ينقادون مع كل قائد ولا يعرفون وجوه الحيل، فهم ورؤساؤهم بليّة على العقلاء المتألمين بما يخامر نفوسهم وتنكره عقولهم من ذلك العمل وأمثاله».
ولا يفرق «المرصفي» بين المنتمين إلى مذاهب مغايرة لثقافة الوطن والمروجين لعقائد وعوائد منافية لثوابت المجتمع والمصرحين بميول ذاتية وشكوك شخصية ونقوض ناقمة على أحوال الوطن المُجافية لميولهم ومزاجهم الخاص.
فمثل هذه الرؤى التى انطوت عليها عقولهم ومعتقداتهم لا ينبغي عليهم إفشاءها أو إذاعتها في الرأى العام باسم الحرية، وذلك لأنها تشوش العقل الجمعى وتستهوى المقلدين، الذين لم يعتادوا تحكيم العقل للحكم على غريب الأفكار والوافد من العوائد. ويفرق «المرصفي» في الوقت نفسه بين هؤلاء، والمجددين والثائرين من أجل صالح المجتمع ومنفعة الوطن، فالبرهان والتجربة هما المعيار الفاصل بين الفريقين، فالعبرة هنا ليس في المقصد، بل بالمآل أى ما يترتب على تحقيق الهدف.
فمن الخطأ في رأيه أن نجعل الحرية شعار ومقصد، فنقوم بنقض الثوابت وهدم النظم وتغليب الحرية الفردية والمصالح الشخصية على المنافع العامة.
لذا نجده يعيب على الزُراع إهمال زراعة المحاصيل الحيوية الأساسية، ويرغبون في غيرها لتصديرها والربح من وراء ذلك ما يضاعف ثرواتهم، كما يعيب على الصناع وأرباب الحرف هجر أعمالهم والاشتغال بالتجارة وتسويق المنتجات الأجنبية طلبًا للراحة والثراء أيضًا، كما رفض تعالى المثقفين وتفضيل العوام بعض طبقات المجتمع على غيرها، والنظر إلى الأعمال اليدوية والحرف الخدمية (الكنّاس، الحداد، النجار) نظرة دونيّة عن (الطبيب، المهندس، الضابط)، مؤكدًا أن هذه النظرة المتخلفة تعمد على تفكيك المجتمع وتعبر عن الجهل بأهمية هذه الوظائف ومكانة هذه الأعمال.
فالوطن في عينيه - كما ذكرنا - بدن واحد لا تفضل فيه الرأس على القدمين، أو العين على الأصابع، فلكلٍ أهميته والمعيار في المفاضلة هو الإتقان والتزام أخلاقيات المهنة والإخلاص في العمل من أجل الوطن، ويقول إن معيار التفاضل بين المهن لا ينبغي أن ينبع من طبيعتها «لا شرف من هذه الجهة لطائفة على طائفة إذ كان الكل ضروريًا وبه حصة من منافع الأمة، فلا أراك تغفل ما يفعل السّفهاء من التشاتم بحرفة الحياكة أو الكناسة أو غيرهما من الحرف التى تطرحها سخافة أنظارهم في مطارح الخسة، وإذا تحققت ذلك لم يكن الأولى بسقوط الاحترام وعدم الاعتبار سوى طائفة أخرجتها من الأمة، بل من نوع الإنسان، خسها وضعة نفوسها وقصور أفكارها، ليس لهم من الدنيا سوى المُنى يتهامسون باغتياب بعضهم بعض مع ما يتلوّن كأنهم لمعناه لا يعقلون، يطرحون رذائل آمالهم بين أهل الدنيا، فترتد إليهم بالخيبة وطول الأسف».
ويختتم مفكرنا حديثه عن مقومات الوطن المرجُوّ، محذرًا جميع المواطنين من آفة التبعيّة والتقليد والتواكل، موضحًا أن ارتقاء هذا الوطن لن يتحقق إلا بوعى عقول أبنائه وقوة سواعدهم وتصالح طبقاته وتعاون أفراده ووحدة إرادته واستحالة خلافاتهم إلى مثقفات لانتخاب الأفضل من الأفكار والتصورات والمشروعات، فيجتمعون على تنفيذه ويتفقون في الوقت نفسه على أن تتنوع الآراء وتتباين الأفكار.
هو الطريق الأمثل للإبداع والوقوف على المنفعة العامة وصوالح المواطنين في ضوء العدالة والحرية والمساواة، وحكومة حازمة في تطبيق ما فيه خير لهذا الوطن، ويقول: «نهمل النظر في مصالحنا والعمل من أجل منافعنا، ونعوّل في ذلك على قوم كل ما تخيلناه فيهم بالنسبة إلى مصالحنا ومنافعنا فاسد، فكل يميل إلى شهوته، وكل يريد رضاء نفسه، ويطلب نارًا إلى برمته».
(وللحديث البقية)
بقلم: د. عصمت نصّار