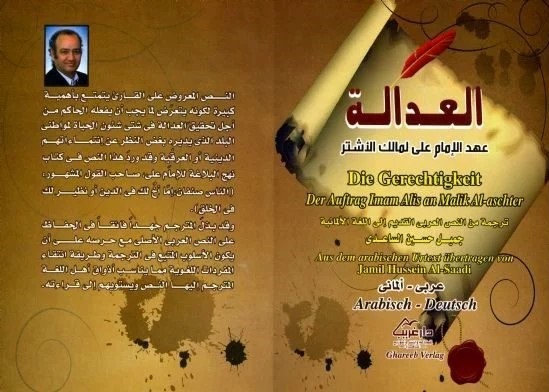قضايا
محمود محمد علي: محمد السيد الجليند وموقفه من قضايا الفلسفة الإسلامية (2)
 نعود ونكمل حديثنا عن موقف محمد السيد الجليند من قضايا الفلسفة الإسلامية، وهنا نركز حديثنا في هذا المقال حول موقفه من ابن تيمية، كما ورد كتاباته؛ فنراه يؤكد علي أن تراث ابن تيمية لم يقرأ بشكل علمي ودقيق، معتبرا أن "هناك سوء فهم لبعض فتاوى ونصوص ابن تيمية"، وذلك يعود إما إلى القراءة المغالية لنصوصه والتي تغلب عليها "العاطفة الدينية القوية"، أو القراءة المتحيزة ضده والرافضة له من خصومه، كما يرى أن "تشدد ابن تيمية وقت غزو التتار ليس حباً في التشدد إنما ولاء في الوطن"، وأن موقفه إنما كان بهدف الدفاع عن أراضي المسلمين ضد الغزو الأجنبي. وهو في ذلك ينطلق من موقف وطني لا "عقائدي". مشددا على أن فتوى ابن تيمية الشهيرة بـ"الفتوى الماردينية"، إنما أساء فهمها وشوهها أتباع "السلفية الجهادية"، ما عرضها لكثير من "التحريف"، حيث هي فتوى خاصة بمسألة معينة محددة. مبينا أن "فتاوى المناسبات لا يؤخذ منها حكم عام، والفتوى قد تتغير بتغير الظروف" (5).
نعود ونكمل حديثنا عن موقف محمد السيد الجليند من قضايا الفلسفة الإسلامية، وهنا نركز حديثنا في هذا المقال حول موقفه من ابن تيمية، كما ورد كتاباته؛ فنراه يؤكد علي أن تراث ابن تيمية لم يقرأ بشكل علمي ودقيق، معتبرا أن "هناك سوء فهم لبعض فتاوى ونصوص ابن تيمية"، وذلك يعود إما إلى القراءة المغالية لنصوصه والتي تغلب عليها "العاطفة الدينية القوية"، أو القراءة المتحيزة ضده والرافضة له من خصومه، كما يرى أن "تشدد ابن تيمية وقت غزو التتار ليس حباً في التشدد إنما ولاء في الوطن"، وأن موقفه إنما كان بهدف الدفاع عن أراضي المسلمين ضد الغزو الأجنبي. وهو في ذلك ينطلق من موقف وطني لا "عقائدي". مشددا على أن فتوى ابن تيمية الشهيرة بـ"الفتوى الماردينية"، إنما أساء فهمها وشوهها أتباع "السلفية الجهادية"، ما عرضها لكثير من "التحريف"، حيث هي فتوى خاصة بمسألة معينة محددة. مبينا أن "فتاوى المناسبات لا يؤخذ منها حكم عام، والفتوى قد تتغير بتغير الظروف" (5).
ويستطرد الدكتور الجليند فيقول:" هناك اتجاه غير صحيح من الدارسين لابن تيمية قرؤوا موقف ابن تيمية من المتصوفه في رسائله الصغيرة والكبيرة في موقفه من الحلاج وفي موقفه من ابن الفارض وفي موقفه من ابن عربي حتى في موقفه من الغزالي، وظنوا أن ابن تيمية حين هاجم انحرافات هؤلاء الصوفية فإنه بذلك رفض التصوف كمبادئ إسلامية وقواعد دينية ولم يفرقوا بين موقفة من المتصوفة وموقفه من التصوف؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له رسائل في التصوف هو وتلميذه ابن القيم تكلموا في هذه الرسائل كلاما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ابن تيمية له رسالة تسمى "التحفة العراقية في الأعمال القلبية" وله رسالة تسمى "أمراض القلوب وشفاؤها" وله رسالة تسمى "الحسنة والسيئة" من أنفس ما كتب عن النفس الإنسانية، وله رسالة "الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان"، والفرقان بين الحق والباطل، هذه كلها رسائل في صميم التصوف الإسلامي تفرق بين ما هو صحيح وما هو زائف من سلوكيات الصوفية، الذين قالوا بالحلول والاتحاد، والذين قالوا بوحدة الوجود، والذين قالوا بالفناء، بل لك أن تقرأ كتاب "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم، وكتابه "طريق الهجرتين"، وكتاب "مدارج السالكين"، لك أن تقرأ كتاب ابن القيم وهو يشرح رسالة الإمام الهروي له كتاب اسمه "الكلمات النقيات"، شرح فيه رسائل بعض الصوفية كالرسالة القشيرية، تكلم فيها كلاما يخاطب القلوب قبل أن يخاطب العقول، وكان القصد من هذه العبارة أن أبين أن ابن تيمية لم يحارب التصوف ولم يرفض التصوف؛ لأنه كما قلت في أول هذا اللقاء يرى أن قواعد التصوف ومبادئه قرآنية ولا ينبغي أن نحكم على هذه المبادئ وهذه القواعد من سلوكيات المتصوفة الغلاة، ولذلك فإن دارسي التصوف في عصرنا هذا يحاولون أن يصححوا مسيرة الصوفية المعاصرين من خلال كلام ابن تيمية المتهم بأنه ضد التصوف، هكذا أردت أن أبين أن ابن تيمية حينما نقد ابن عربي وحين رفض كلام الحلاج والبسطامي وغيرهم من غلاة الصوفية لا ينبغي أن نتخذ هذا دليلا على رفضه للتصوف، وبمثل هذا فعل ابن القيم فهو لم يرفض التصوف وإن كان أخذ بسيرة شيخيه ابن تيمية في رفضه لدعاوى ابن عربي والحلاج وابن الفارض والبسطامي وغيرهم من أصحاب الشطح الصوفي أو من القائلين بالحلول والاتحاد، وهذه قضية على جانب كبير من الأهمية أن نفرق في كتابات هؤلاء بين موقفهم من التصوف وموقفهم من انحرافات الصوفية (6).
ثم يؤكد الدكتور الجليند بأن حملة الفكر "المتشدد" من الشباب والذين كانوا يكفرون علماء المسلمين، حذر منهم ابن تيمية، هذا ما يكشف عنه الباحث الجليند، مضيفا أن ابن تيمية كان يقول إنه على ولي الأمر أن يعلم أن كف أذى هؤلاء عن علماء الأمة من أولويات الحاكم المسلم (7).
إن "مذهب ابن تيمية في نظر الدكتور الجليند لا يكفر مسلماً إلا إذا أنكر الثوابت الدينية"، يقول الدكتور الجليند، مضيفاً أن ابن تيمية "أكد أنه لا يجوز تكفير المخطئ في اجتهاده، بل يُثاب أيضا عليه، حتى الموقف من المخالفين فكريا لابن تيمية، مثل المعتزلة والأشاعرة والصوفية "لم يكفرهم ابن تيمية"، حيث إنه "انتقد المتصوفة ولم ينتقد التصوف"، بل كان "من كبار المتصوفين، والذي اعتنى بأعمال القلوب (8).
وهنا نجد الدكتور الجليند، يذهب إلى أبعد من ذلك، عندما يؤكد على أن شخصية صوفية "إشكالية" مثل الحسين بن منصور الحلاج، لم يُكفره ابن تيمية، وإنما اعتبر بعض ما خرج منه من حديث "كفرا"، وحينما سئل عنه بعد وفاته قال "الله أعلم بحاله (9).
وحول موقف الدكتور الجليند من العقبات التي تواجه الخطاب الإسلامي الوسطي، وهل يمكن التغلب عليها ليكون هذا الخطاب الوسطي الأكثر حضورًا وتأثيرًا؟
ويجيبنا الدكتور الجليند قائلا: هناك عقبات، يتمثل أولها في المتحدثين عن الإسلام، وأشير هنا إلى بعض القضايا التي يلاحظها الجميع، مثل عدم فهم الواقع الذي يتحدث فيه الداعية أو الخطيب، فتجد في بيئات ثقافية عالية المستوى مَنْ يتحدث عن أمور لا تتصل بهم من قريب ولا من بعيد، والعكس صحيح، تجد البيئات الأمية ثقافيًّا ودينيًّا تسمع فيها مَنْ يخاطبهم بلسان لا يفهمونه لا من قريب ولا من بعيد، ومن القواعد التي ينبغي أن تُراعى في هذا الشأن أن لكل مقام مقالاً، وخاطبوا الناس على قدر عقولهم، هذه واحدة، وهناك أخرى وهي الأهم، أن الدعاة- خاصة خطباء المساجد- قد فضَّلوا أن يختزلوا الإسلام في ممارسة الشعائر الدينية في داخل المسجد، ونسوا أن الإسلام ما لم يكن مؤثرًا في حياة المسلم؛ في الشارع والمتجر والمصنع والمؤسسات التعليمية والجامعات فهو إسلام ميت لا تفارق آثارُه جدران المساجد، وهذه جناية الدعاة على الإسلام (10).
ويستطرد الدكتور الجليند:" وأرى أن هناك قضية كبرى أوجه إليها الخطباء والمشتغلين بالدعوة: وهي الخروج بالإسلام من دائرة العبادات والشعائر إلى النظرة الشمولية التي تجعل العالم الكيميائي والطبيب والجراح والمهندس وعالم النبات وعالم الفلك، وهم يمارسون بحوثهم العلمية تجعلهم في عبادة لله لا تقل أهمية ولا تقربًا إلى الله مِن الواقف في محراب المسجد؛ فتلك عباده قولية في داخل المسجد، وهذه عبادة عقلية علمية تربوية نهضوية تقود الأمة إلى الأمام حتى تعيش الأمة ثقافة (إتقان العمل) فهذه عبادة منسية، إن لم تكن مجهولة دعانا إليها القرآن، ونبهنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن العجيب أن خطباء المساجد حين يقرأون قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة: 43 يستدلون بها على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، وحين يقرأون قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} يونس: 101، وقوله تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} العنكبوت: 20، وقوله تعالى: {أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ} الغاشية: 17؛ فلماذا لا يستدلون بها على وجوب إعمال العقل في الكون وما فيه؛ لاستظهار قوانينه تحقيقًا لمبدأ التسخير الإلهي للكون الذي لا يتم إلا باكتشاف هذه القوانين العلمية (11).
ويخلص الدكتور الجليند إلي أن:" إعراض الخطباء عن إحياء هذا الواجب الديني والفريضة الشرعية قد صرف عقول العلماء عن الاشتغال بها لعبادة لله واقتصروا في ممارستها على أنها وظيفة دنيوية لأكل العيش، فما نصروا بها دينًا، ولا عمَّروا بها دنيا. وهذا أخطر ما أصاب الخطاب الديني من خلل في عصرنا الحاضر، وما لم يتنبه له المهتمون بقضايا الأمة ثقافيًّا وتربويًّا فلا أمل في أية نهضة يتحدثون عنها؛ لأن العلم الكوني هو مفتاح نهضة الأمم، شئنا أم أبينا. وقد أمرنا القرآن الكريم بذلك، ونبَّه إليه الشرع الحنيف" (12).
وحول موقف الدكتور الجليند من السبب الفاعل في تأسيس الحضارات وازدهارها؛ قال:" إن غياب الإيمان والاعتقاد الصحيح يترتب عليه سيادة قيم ومبادئ اجتماعية وأخلاقية تجسد الجوانب الدنيا في الطبيعة البشرية، فيسود منطق الأثرة والأنانية بدلاً من الإيثار والمحبة، ويحل الظلم ويغيب العدل، ويختفي كل معنى أخلاقي نبيل؛ ليسود منطق الغاب وسيادة الأقوى.. تأمل معي حال مجتمع يعيش أفرادُه تحت سيادة هذه المبادئ اللاأخلاقية، ثم ماذا يكون حال العلاقات بين الدول إذا أخذوا بهذا المنطق في علاقات الدول الكبرى بالدول الضَّعيفة؟ وهذا هو الواقع المعيش الآن، فإن الدول الضعيفة تكتوي بنار هذا المنطق المعكوس في تعامُل الدول الكبرى معها؛ حيث سطت هذه الدول على خيرات العالم الثالث سلبًا ونهبًا، وإذا وجدت من يقاومها، فإن القتل والتشريد يكون وسيلةَ الخلاص منه؛لقد اغتر هؤلاء بما عندهم من العلم، كما يغتر أبناء عصرنا بما عندهم من العلم، ونسوا أن العلم هو وسيلة بناء الحضارات وازدهارها، وأنه هو نفسه قد يكون سببًا في انهيارها وإبادتها، ومن هنا جاء الأمر الإلهي بالقراءة المقرونة باسم الرب الخالق، وليس بالقراءة المبتورة عن الخالق؛ قال الله - تعالى -: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: 1]، فقراءة الكون واكتشاف أسراره وقوانينه يجب أن تكون في أحضان الإيمان بالرب الخالق، حتى إذا ما أحسن الإنسان قراءة الكون، وتعرف على قوانينه، فإنه يوظف هذه القوانين العلمية توظيفًا إيمانيًّا يسعد بها الإنسان ولا يشقى، فيكون العلم مصدر أمن وأمان للإنسان، وليس مصدر خوف وشقاء (13).
ولم يكتف الدكتور الجليند بذلك بل يقول:" نحن فرَّطنا في أمور ديننا من ناحية الاهتمام بالعلوم الكونية ـ للأسف الشديد ـ وأهملنا العقل، فأصابنا الضعف والهوان وقد ظلم بعض فقهائنا الأمة، لما حصروا الدين فى العبادات مثل الصوم والصلاة وما إلى ذلك، فهذا يخص علاقة العبد بالله وعلاقة الله بالعبد، أما الجانب الذى يشمل الكون قد أهملوه حتى أن بعض علماء الدين والشريعة غمز فى عقيدة علماء الكونيات وبعضهم ـ بكل أسف ـ شغلنا بمسائل هى من نوافل النوافل مثل إطالة اللحى وتقصير الثياب، رغم أن الله خلق الإنسان المسلم فى هذا الكون إنما ليعمره مصداقاً لقوله تعالي: "وهو أنشأكم فى الأرض واستعمركم فيها" ونحن ندرك أن حرفى "السين والتاء" إذا دخلا على الفعل حولاه إلى فعل أمر، أيضاً هناك وظيفة أخرى هى الاستخلاف، بمعنى إظهار قوانين الله الكونية فى هذا العالم، حتى أن المقصود في قوله تعالى: "إنما يخشى اللهَ من عباده العلماءُ" هم علماء الكونيات وليسوا علماء التفسير والحديث، ولذلك وجب على العلماء أن ينتبهوا إلى أهمية قراءة الكتاب المنظور «الكتاب الكوني» التى لا تقل أهميته عن قراءة الكتاب المسطور "القرآن الكريم" فكما نتعبد إلى الله بالقرآن يجب أن نتعبده بالعلم وأن نجلى آياته الكونية للخلق (14).
ولكن هذا في نظر الدكتور الجليند لا يتم إلا من خلال " ثورة دينية" ، وهذه الثورة هي ثورة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في خطابنا الديني المعاصر، لأنها مدخل طبيعي للإصلاح الاجتماعي والسياسي للأمة الإسلامية؛ يقول الدكتور الجليند:" نحن اليوم بحاجة إلى ثورة لتصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان الشباب، لأن تصحيح المفاهيم هو المدخل الطبيعي لتصحيح السلوك، وعلاج المشكلات في الواقع، لذا الواقع يتطلب تصحيح المفاهيم المغلوطة في عقول الشباب التي أفرزت لنا تطرفاً في السلوك، وغلواً في الأحكام، وأثارت كثيراً من الشكوك والشبهات حول القيم الكبرى التي يتميز بها الإسلام في صفاته ونقائه من التسامح مع المخالف، ونشر روح المودة والأخوة وصيانة المقاصد الشرعية وحرمتها، مثل حرمة النفس والمال والعقل والدين والعرض. فإن لم تُصحح المفاهيم المغلوطة لن يصح الاعتقاد، وما لم يصح الاعتقاد لن يصح السلوك (15).
ويستطرد الدكتور الجليند فيقول:" نعم، نحن في أمس الحاجة إلى مراجعة نقدية لمكونات العقل المسلم تكشف لنا عن أوجه من الخلل متعددة الجوانب أصابت مناهجنا الدراسية بالركود والجمود، ما انعكس أثره على عقلية الأمة، فأصابها بشيء من السكون إلى الواقع والرضا به والالتفاف حوله ورفض تجاوزه، لذا فالقضية تحتاج منا إلى إعادة نظر ومراجعة كل ما يتعلق بشؤون الحياة المتغيرة والمتطورة، كذلك ينبغي أن نفرق في السياق بين ما اتفق عليه بأنه ثابت لا يتغير من مسائل الأصول وثوابت العقيدة، وذلك الذي يحتاج منا إلى مراجعة لضرورة التجديد والتغيير حسب تجدد الظروف ومستحدثات العصر من مشكلات وقضايا تفرض بطبيعتها البحث عن حلول ومواجهة، لأنها لم تكن موجودة في عصر التأليف والتأسيس للعلوم الإسلامية، كذلك الأمر بالنسبة إلى بعض القضايا التي ورثناها في تراثنا وجعلناها ركناً أساسياً في مناهجنا الدراسية فإنها تحتاج أيضاً إلى مراجعة، لنتخلص من المسائل التي نشأت تحت ظروف تاريخية معينة، وأصبحت تمثل عبئاً ذهنياً على المعلم والمتعلم، وانتهت ظروفها التاريخية ومناسبتها الثقافية. فقد حدثت أمور وظهرت إشكالات ثقافية لم تكن موجودة، ينبغي أن تأخذ مكانها وتحتل مكانتها في مناهجنا الدراسية، كما فعل الأقدمون تماماً بقضايا ومشكلات عصرهم (16).
ثم يؤكد الدكتور الجليند قائلا:" أحد الأمور التي كان لها دور كبير في واقع الأمة الإسلامية هذا الخلل الخطير الذي أصاب الأمة في فهم عقيدتها، واختزال هذه العقيدة في مجرد ترديد الشهادتين وإقامة الشعائر الدينية دون ترجمة لهذه العقيدة ولمفرداتها إلى واقع عملي يعيشه المسلم في صباحه ومسائه. ورأينا كيف اقتصر حظ المسلم من دينه على هذه الأمور النظرية والمظهرية معاً، من دون أن تملأ هذه العقيدة على المسلم حياته كلها فتشغل قلبه وتحرك جوارحه تحت مظلة الاعتقاد الصحيح علماً وعملاً، واعتقاداً وسلوكاً، على نحو ما كان عليه المسلمون يوم أن سادوا نصف الكرة الأرضية في أقل من قرنين من الزمان. لذا فإن العقيدة ودورها في نهضة الأمم سنة من سنن التاريخ، وعليك أن تدور بناظريك في الحضارة الإنسانية قديمها وحديثها، فلا تجد أمة نهضت وقامت لها حضارة إلا كان الدافع إلى ذلك هو اعتقاد أبنائها، فلا تجد أمة بلا معبد تمارس فيه شعائرها، ولا تجد أمة على وجه الأرض إلا وتعتز بعقيدتها وتموت دونها؛ لكن الحظر لمن يغتر بالقول الذي يردده البعض عن الحضارة الأوروبية أنها حضارة علمانية لا دين لها ولا عقيدة، فإن ذلك من خلل الرأي الذي استقاه البعض من ظواهر شكلية تطفو على السطح أحياناً. والواقع أن هذه الحضارة مسكونة بعقيدة تحركها على محاور متعددة، لتحقق بذلك مقاصد وغايات تبنتها الحضارة الأوروبية قديماً وما زالت تحركها الآن (17).
ولم يكتف الدكتور الجليند بذلك بل نراه يؤكد بأن من مظاهر الخلل الذي أصاب مناهجنا التعليمية قضية الفصل بين القضايا العقدية، وتطبيقها على مستوى الدرس والتعلم، وعلى مستوى السلوك والعمل، ما ترتب عليه انفصال في ذهنية الدارس بين الاعتقاد والعمل، وبين المبدأ والسلوك. إن هذا الفصل – مع اعترافنا بأنه مدرسي – خلق نوعاً من الانفصام، وتحوَّلت مسائل الاعتقاد نظرية في التطبيق القلبي الذي لا يمتد أثره إلى تحريك الجوارح، وزحزح العمل والسلوك عن مكانته الطبيعية في ضرورة الارتباط والاقتران بالتصديق القلبي، الذي عبر عنه الحسن البصري في قوله «ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال»، فجعل عمل الجوارح علامة على صدق ما في القلب؛ من هنا جاء خطاب ديني يختلف عن السلوك الظاهر للمسلم، ولعل ما نشاهده في حياة الناس وسلوكهم من الخلل الواقع في الاكتفاء من الإيمان بالشكل دون المضمون، وبالظواهر الشكلية دون الوصول إلى جوهر يرجع في أساسه إلى الخلل المنهجي الذي دأبت عليه مناهجنا التعليمية، في الفصل بين العقدية وما يترتب عليها في السلوك والواقع. وهنا يتحتم علينا أن نحول عقيدتنا من مستوى الإيمان القلبي النظري إلى سلوك وواقع، يعيش في ظله الفرد والمجتمع، لأن قانون النهضة والتجديد مرتبط بالأخذ بالأسباب. وكفانا أن نكثر من التمني من دون عمل (18).. وللحديث بقية..
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط
............
الهوامش
5- محمد عبد العزيز الهواري (محاورا): حوار لا تنقصه الصراحة مع أستاذ الفلسفة المتخصص في الشأن الصوفي.. مجلة الصوفية العدد السابع ، 1429هـ.
6-المرجع نفسه.
7- المرجع نفسه.
8- المرجع نفسه.
9- المرجع نفسه.
10- مصطفى يوسف: شخصية الشهر (6) - أ.د. محمد السيد الجليند - مجمع اللغة العربية.. مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية.. [09-16-2015 - 09:38 AM]
11- المرجع نفسه.
12- المرجع نفسه.
13- صابر رمضان (محاورا): د. محمد السيد الجليند: فرَّطنا في أمور ديننا فأصابنا الضعف والهوان.. جريدة الوفد .. الأربعاء, 20 مايو 2020 22:48.
14- ياسر البحيري(محاورا): المرجع نفسه.
15- المرجع نفسه.
16- المرجع نفسه.
17- المرجع نفسه.
18- محمد عبد العزيز الهواري (محاورا): حوار لا تنقصه الصراحة مع أستاذ الفلسفة المتخصص في الشأن الصوفي.. مجلة الصوفية العدد السابع ، 1429هـ.