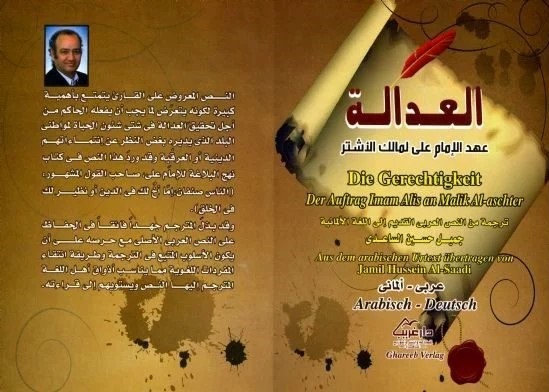قراءة في كتاب
ابن أبي الربيع رائد الفكر السياسي الإسلامي (2)
 نعود ونكمل حديثنا في مقالنا الثاني عن ابن أبي الربيع رائد الفكر السياسي الإسلامي؛ حيث نتحدث كيفية نشأة الدولة لدية، وفي هذا يمكن القول بأن ابن أبي الربيع تحدث في الفصل الرابع المخصص لأقسام السياسات وأحكامها – في ذكر السبب الموجب لاتخاذ المدن والداعي إلى إقامة السياسة في العالم؛ حيث يرى أن الإنسان في حاجة لغيره في سد احتياجاته الطبيعية، وهو عاجز على أن يسد هذه الاحتياجات بنفسه، ولهذا يفتقر الناس إلى بعضهم البعض، وأن حاجة بعضهم إلى بعض أدت إلى أن يجتمع الكثير منهم في موضع واحد وأن يعاون بعضهم بعضاً في المعاملات والإعطاء، فاتخذوا المدن، لينال بعضهم من بعض المنافع من قرب، لأن الله عز وجل خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنس، إذ لا يكتفي الواحد من الناس بنفسه في الأشياء كلها. ولما اجتمع الناس في المدن وتعاملوا، وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة، وضع الله لهم سننًا وفرائضًا يرجعون إليها ويقفون عندها، ونصب لهم حكاما يحفظون السنن ويأخذونهم باستعمالها لتنتظم أمورهم ويجتمع شملهم، ويزول عنهم التظالم والتعدي الذي يبدد شملهم ويفسد أحوالهم. ولما كان الشر يدخل في الإنسان: إما من نفسه، وإما من أهل مدينته، وإما من أهل مدينة أخرى، فقد تبين أن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي، وأن المتوالين لذلك ينبغي أن يكونوا أفاضلهم، فإن من نهى عن شيء أو أمر بشيء، فالواجب أن يظهر ذلك بنفسه أولًا ثم في غيره. ولأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة وتوقع التثبت, احتاجت المدينة أو المدن الكثيرة، أن يكون رئيسها واحدًا، وأن يكون سائر من ينصب لتمام التأثير والسياسة أعوانًا سامعين مطيعين منفذين لما يصدر عن أمره، حتى يكونوا كالأعضاء له يستعملهم كيف شاء، ويكون كالحاضر في إنقاذهم أمره ونهيه وإنما اضطر العالم إلى سائس ومدبر ليدفع عنهم الأذى الواقع على بعضهم من بعض، حتى يقصد كل واحد منهم للصناعة التي ينتحلها لمصلحة نفسه ومصلحة غيره ممن يحتاج إليها، ولا يعوقه عنها عائق فيتم بذلك تعاضدهم وتعاونهم على مصالح عيشهم واستقامة أمورهم .
نعود ونكمل حديثنا في مقالنا الثاني عن ابن أبي الربيع رائد الفكر السياسي الإسلامي؛ حيث نتحدث كيفية نشأة الدولة لدية، وفي هذا يمكن القول بأن ابن أبي الربيع تحدث في الفصل الرابع المخصص لأقسام السياسات وأحكامها – في ذكر السبب الموجب لاتخاذ المدن والداعي إلى إقامة السياسة في العالم؛ حيث يرى أن الإنسان في حاجة لغيره في سد احتياجاته الطبيعية، وهو عاجز على أن يسد هذه الاحتياجات بنفسه، ولهذا يفتقر الناس إلى بعضهم البعض، وأن حاجة بعضهم إلى بعض أدت إلى أن يجتمع الكثير منهم في موضع واحد وأن يعاون بعضهم بعضاً في المعاملات والإعطاء، فاتخذوا المدن، لينال بعضهم من بعض المنافع من قرب، لأن الله عز وجل خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنس، إذ لا يكتفي الواحد من الناس بنفسه في الأشياء كلها. ولما اجتمع الناس في المدن وتعاملوا، وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة، وضع الله لهم سننًا وفرائضًا يرجعون إليها ويقفون عندها، ونصب لهم حكاما يحفظون السنن ويأخذونهم باستعمالها لتنتظم أمورهم ويجتمع شملهم، ويزول عنهم التظالم والتعدي الذي يبدد شملهم ويفسد أحوالهم. ولما كان الشر يدخل في الإنسان: إما من نفسه، وإما من أهل مدينته، وإما من أهل مدينة أخرى، فقد تبين أن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي، وأن المتوالين لذلك ينبغي أن يكونوا أفاضلهم، فإن من نهى عن شيء أو أمر بشيء، فالواجب أن يظهر ذلك بنفسه أولًا ثم في غيره. ولأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة وتوقع التثبت, احتاجت المدينة أو المدن الكثيرة، أن يكون رئيسها واحدًا، وأن يكون سائر من ينصب لتمام التأثير والسياسة أعوانًا سامعين مطيعين منفذين لما يصدر عن أمره، حتى يكونوا كالأعضاء له يستعملهم كيف شاء، ويكون كالحاضر في إنقاذهم أمره ونهيه وإنما اضطر العالم إلى سائس ومدبر ليدفع عنهم الأذى الواقع على بعضهم من بعض، حتى يقصد كل واحد منهم للصناعة التي ينتحلها لمصلحة نفسه ومصلحة غيره ممن يحتاج إليها، ولا يعوقه عنها عائق فيتم بذلك تعاضدهم وتعاونهم على مصالح عيشهم واستقامة أمورهم .
وبعد أن ذكر ابن الربيع السبب الموجب لاتخاذ المدن والداعي إلى إقامة السياسة في العالم، يبين لنا بعد ذلك السبب الذي دفعه إلى كتابة الفصل الرابع من كتابه" سلوك المالك في تدبير الممالك"، وهو تعظيم الملوك وتوقيرهم كما أوجب طاعتهم، ويستشهد ابن أبي الربيع بالآية الكريمة "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". كذلك يقول: " إن العامة وبعض الخاصة تجهل الأقسام التي تجب لملوكها عليها، وإن كانت متمكنة بجملة الطاعة، كذلك يقرر صاحب الكتاب أن " السعادة العامة هي تبجيل الملوك وتعظيمها وطاعتها".
ندرك من الفقرة السابقة أن ابن أبي الربيع وضع هذا الفصل لأجل الملوك وكذلك إذا جاء ذكر العلماء والحكماء فلأجل أن يوقروا ويبجلوا الملوك وإذا جاء ذكر العامة فلأجل طاعة الملوك لا غير ثم لا يتردد أن يستشهد بآيتين كريمتين ذكرنا واحدة منهما تذكر الإنسان بأن الله تعالى رفع بعضنا فوق بعض درجات، وكذلك كما نطيع الله والرسول يجب أن نطيع أولي الأمر. ثم يقرر ابن أبي الربيع نظرية عجيبة هي أن السعادة العامة في تبجيل الملوك وطاعتهم. ولا ندري لماذا يقرر – مثلا - بأن السعادة العامة هي في عدل الملوك بين رعيتهم. الحقيقة أننا لا نستطيع أن ننظر المسألة نظرة عصرية وإنما الأصح أن نتذكر أن الخليفة العباسي كان يعتبر نفسه ظل الله في الأرض، فهو يجمع بين الرئاسة الدينية والدنيوية، كما لا ننسى أن أي وزير أو قائد في الدولة كان إذا أراد مكالمة الخليفة خاطبه بـ: (بابن عم رسول الله)، ولا حاجة بنا أن نذكر ما لهذه الجملة من قدسية لدي المخاطبين والسامعين. ولهذا إذا لمنا ابن أبي الربيع من أنه كان يجب عليه أن يدرس المجتمع مشيرًا إلى الأسباب التي تجلب له السعادة، وجب علينا أن نتذكر أن المجتمع في ذلك الحين كان هرميا يبدأ بالقمة الذي هو الخليفة؛ حيث يستطيع هذا أن يقرب هذا ويبعد ذاك من العلماء، وهو قادر على عزل أو تعيين من يشاء من القادة والوزراء، كما أنه يستطيع أن يُغني أو يُفقر أي فرد من العامة، وهي سمة سنجدها أيضًا عند الفارابي في كتابه المعروف "آراء أهل المدينة الفاضلة".
ويعتقد ابن أبي الربيع أن نشأة المدن ترجع – كما أشار أفلاطون من قبل – إلى افتقار الإنسان إلى أمور أساسية: -
1- الحاجة إلى الغذاء: ووظيفته أن يعوض الإنسان عما فقده من بدنه بالحركة والرياضة.
2- اللباس: ليدفع عن نفسه ألم الحر والبرد والرياح.
3- المسكن: ليصون نفسه ويحرسها من تطرق الآفات.
4-الجماع: ليبقي به النوع إذ لا سبيل إلى بقاء الشخص دونه.
5- العلاج: لتغير الكيفيات التي فيه, ولما يناله من تفرق الاتصال.
وهو لا يستطيع (الإنسان الفرد) كما يقول ابن أبي الربيع: "أن يقوم بذلك كله بمفرده لأنه يحتاج إلى الصنائع والعلوم التي تعمل بها هذه الأشياء، ولما كان الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعمل الصنائع كلها، افتقر بعض الناس إلى بعض، وبحاجة بعضهم إلى بعض اجتمع الكثير منهم في موضع واحد، وعاون بعضهم بعضًا في المعاملات والإعطاء، فاتخذوا المدن، لينال بعضهم من بعض المنافع من قرب، لأن الله (عز وجل) خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والأنس، إذ لا يكتفي الواحد من الناس بنفسه في الأشياء كلها. ولما اجتمع الناس في المدن وتعاملوا، وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مخلفة، وضع الله لهم سننا وفرائض يرجعون إليها ويقفون عندها، ونصب لهم حكاما يحفظون السنن ويأخذونهم باستعمالها لتنتظم أمورهم ويجتمع شملهم ويزول عنهم التظالم والتعدي، الذي يبدد شملهم ويفسد أحوالهم. ولما كان الشر يدخل على الإنسان من وجوه يأتي ذكرها، جعل لهم ما يتحفظ به من وقوع الشر، وما يدفعه ويداويه إذا وقع وهي:
1- إما من نفسه: ويدفع ذلك بسلوك الطرق المحمودة، وضبط النفس واستعمال العقل في كل الأمور.
2- وإما من أهل مدينته: ويدفع ذلك باستعمال الشرائع والسنن الموضوعة لهم، وإصلاح الكافة.
3- وإما من أهل مدينة أخرى: ويدفع ذلك بالأسوار والخنادق والحراس، ثم إذا وقع المحاربة والقتال.
ويستطرد ابن أبي الربيع، فيقول: " فقد تبين بما ذكرنا أن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي. وأن المتوالين لذلك ينبغي أن يكونوا أفاضلهم، فإن من نهى عن شيء أو أمر بشيء، فالواجب أن يظهر ذلك في نفسه أولًا ثم في غيره. ولأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة وتوقع التثبت، احتاجت المدينة أو المدن الكثيرة، أن يكون رئيسها واحدًا، وأن يكون سائر من ينصب لتمام التأثير والسياسة أعوانًا سامعين مطيعين منفذين لما يصدر من أمره، حتى يكونوا كالأعضاء له يستعملهم كيف شاء، ويكون كالحاضر في إنقاذهم، أمره ونهيه، وإنما اضطر العالم إلى سائس ومدبر ليدفع عنهم الأذى الواقع على بعضهم من بعض، حتى يقصد كل واحد منهم للصناعة التي ينتحلها لمصلحة نفسه، ومصلحة غيره ممن يحتاج إليها، ولا يعوقه عنها عائق فيتم بذلك تعاضدهم وتعاونهم على مصالح عيشهم واستقامة أمورهم .
ومن الملاحظ هنا أن ابن أبي الربيع يقدم لنا فكرة جديدة في كتابه فينصح بالتعاون بين الناس، لأن الإنسان الواحد – برأيه - لا يمكنه أن يعمل الصنائع كلها، ولهذا افتقر بعض الناس إلى بعضهم، لا سيما وأن الإنسان محتاج إلى الغذاء واللباس والمسكن والجماع والعلاج. ولهذا السبب اجتمع كثير منهم في موضع واحد فاتخذوا المدن لينالوا المنافع من قرب بعضهم لبعض، لذلك رأينا ابن أبي الربيع يؤكد كما وضح في النص السابق بأن الله (عز وجل) خلق الإنسان بالطبع يميل إلى الاجتماع والمعروف أن أرسطو في كتابه "الأحلاق إلى نيقوماخوس" كان أول من قال بأن الإنسان مدني بطبعه. كذلك قال قبله أفلاطون في كتابه "الجمهورية" إن الإنسان محتاج للاجتماع والتعاون لأن الإنسان يحتاج للآخرين في بناء المدينة السعيدة. ومن فلاسفة الأخلاق في الإسلام الذين ذهبوا بأن حياة الإنسان تكتمل في المجتمع ابن مسكويه في كتابه "تهذيب الأخلاق". وبعد أن اجتمع الناس في المدن وتعاملوا يتأثر ابن أبي الربيع في العقيدة الإسلامية فيشير إلى أن قد صنع لهم سننًا وفرائضًا يرجعون إليها ويقفون عندها، ونصب لهم حكامًا يحفظون السنن ويأخذونهم باستعمالها لتنتظم أمورهم ويجتمع شملهم .
كما يتبين لنا أن ابن أبي الربيع لم يكتف بما قاله في النص السابق، بل يقرر أن السنن منزلة من عند الله، وبلا شك هنا يقصد الشريعة الإسلامية. كما أنه في الوقت نفسه يقرر أن الله هو الذي نصب الحكام، والسبب لقوله هذا كما يذكر بعض الباحثين أنه كان يعيش في زمن خلفاء ينتسبون إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والذي اختاره الله يوصل السنن إلى البشر، ولهذا يريد ابن أبي الربيع من الحكام أن يزيلوا الظلم والتعدي والفساد. ويلفت ابن أبي الربيع لفتة بارعة حيث يقول إن المتولين لذلك يجب أن يكونوا أفاضلهم من نهى عن شيء أو أمر بشيء فالواجب أن يظهر ذلك في نفسه أولًا ثم في غيره. ثم يأتي بفكرة رائعة أيضًا؛ وهي أن المدينة أو المدن الكثيرة يجب أن يكون رئيسها واحدًا لأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة. بعد هذا يقول إن سائر الأعوان والسياسيين يجب أن يكونوا سامعين للرئيس مطيعين منفذين لما يصدر عن أمره. ولم يكتف ابن أبي الربيع من الأعوان بالسمع والطاعة بل يقول "وحتى يكونوا كالأعضاء لهم يستعملهم كيف شاء".
وهنا نرى ابن أبي الربيع يرفض بوضوح أي شكل آخر من أشكال الحكم سوى الشكل الملكي الذي ينفرد فيه شخص واحد هو الملك بالحكم، ذلك لأن كثرة الرؤساء تفسد السياسة، لهذا احتاجت المدينة أو المدن الكثيرة، أن يكون رئيسها واحدا، وأن يكون سائر من ينصب لتمام التأثير والسياسة أعوانًا سامعين مطيعين منفذين لما يصدر عن أمره، حتى يكونوا كالأعضاء له يستعملهم كيف يشاء . وهي دعوة صريحة إلى الحكم المطلق كما يؤكد بعض الباحثين ؛ فرئيس الدولة ينبغي أن يكون فردًا واحدًا حتى لا تفسد السياسة، وأوامره واجبة التنفيذ فلا راد لقضائه، وعلى سائر الأعوان والسياسيين السمع والطاعة، وتنفيذ ما يصدر عنه من أوامر.
ولم يكتف ابن أبي الربيع من الأعوان بالسمع والطاعة بل يقول: " عليهم أن يكونوا كالأعضاء له يستعملهم كيف يشاء. وما أشبه شخصية الملك هنا بما كان يتصف به "فرعون " في مصر القديمة من قداسة وهيبة ورهبة ".
ويصف ابن أبي الربيع أدب الذل والانكسار مع الحاكم المطلق: " فيجب على الداخل على الملك أن يسلم قائما على بعد، فإن استدناه قرب منه قبل الارض وتنحى عنه ". " وعلى الجالس مع الملك ألا يبدأه بالكلام دون أن يسأله ويجيبه، حينئذ يخفض صوته، فإن سكت الملك فلينهض. كذلك على الجالس ألا يضحك عند الحديث مع الملك، ولا يكثر التعجب منه ولا يرفع صوته، ولا يحرك شيئًا من أعضائه بحضرته، ولا يكثر الالتفات ولا يقطع حديثه، ولا يعيد عليه حديثًا مرتين إلا أن سأله عنه. ويجب عليه أن يخدم الملك بالنصح، والشكر والعرفان، وكتمان السر، فإذا سلك هذا السبيل كان جديرًا بالسلامة ونيل الحظوة، وأصابة الأمنية، وجميل العافية". " وليعلم أن الرئيس كالسيل المنحدر من الربوة، متى واجه أهلك نفسه... ".
وقبل أن انتهى من الفقرات السابقة أود أذكر أن هناك سؤالًا يطرح نفسه: لماذا يشير ابن أبي الربيع إلى ذكر الملوك ولا يقول الخلفاء؟. لا سيما إذا علمنا أن ابن أبي الربيع كتب كتابه في ظل الدولة العباسية. وإذا كان هناك ملوك أطراف، وإذا كان هناك ملوك ولايات أو مقاطعات، إلا أن الشيء الذي يجب ألا يغيب عن بالنا أن ابن الربيع ذكر أنه كتب كتابه هذا من أجل (خليفة) وهو الخليفة المعتصم، يخيل لي على حد تعبير بعض الباحثين أن هناك أسبابًا كثيرة لعل أهمها أن الدولة العباسية في بدء نشأتها كانت محاطة بدول يحكمها ملوك مثل بلاد فارس والحبشة ومصر وبلاد الروم، بالإضافة إلى أن العرب عرفوا الملوك في بلاد، فهناك ملوك مثل اليمن وملوك كندة وملوك المناذرة وملوك الغساسنة. والسبب الثاني أن كلمة (خليفة) اتخذت أول الأمر للرجل الذي يخلف رسول الله، فهي دينية أكثر منها إدارية، وكذلك كلمة (أمير المؤمنين) تدل على معني الإدارة والحكم. والسبب الثالث أن الدولة رغم أنها كانت تدار من قبل الخليفة – في أيام عز الدولة العباسية – ورغم أن الخليفة – في عصور الضعف – قد فقد كل قوة سياسية، أقول رغم هذا وذاك فقد كانت هناك مقاطعات وولايات تدار من قبل الملوك. والسبب الرابع – وهو مهم برأيي – أن مفكري الإسلام قد اطلعوا على آداب وفلسفات الدول ذات الحضارة العريقة، مثل فارس والهند واليونان حيث إن كلمة (ملك) عندهم تعني الحاكم والرئيس المهيمن على شؤون البلاد، ولهذا عندما نقرأ لكتاب مسلمين نجد أنهم يستعملون كلمة ملك ويقصدون به الحاكم أو الخليفة أو الرئيس، فمثلا نقرأ في كتاب (التاج في أخلاق الملوك) المنسوب للجاحظ والذي عاش في عز أيام الدولة العباسية يستعمل كلمة (ملك) وهو يقصد خليفة في كثير من صفحات كتبه. وكذلك الفارابي في كتابه (آراء أهل المدينة الفاضلة ) فإنه يستعمل كلمة: ملك، ورئيس، وإمام، وخليفة، ويقول إنها كلمات تدل على معنى واحد. ويحيى بن عدي في كتابه (تهذيب الأخلاق) يستعمل كثيرًا كلمة ملك، وسلطان، ورئيس، ويقصد بكل هذه الكلمات الرجل الحاكم للدولة... وللحديث بقية!
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط.