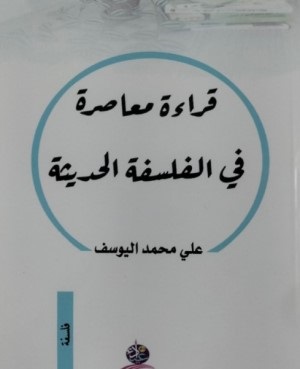أقلام حرة
الثورة السورية عقد من دم وياسمين.. وأمل أيضاً
 الحديث عن الثورة السورية لايشبه كل حديث، إنه حديث التاريخ والذاكرة، حديث البدايات والنهايات، وعطر الدم العابر للحدود، والألم الذي يرفض أن "يترجّل" عن صهوة الريح واللامنطق. هو الحديث الاستثنائي جداً الذي تجاوز منطق التعبير والإنشاء، إلى منطق الحزن المركَّب. هو حديث الساعات والأمم. ليس لأن قضيتنا تعنيهم، بل لأنَّ وقار الثورة يبدو أكثر وضوحاً في الشمس، لذلك اختاروا الظل لكي يحطموا آمال آخر طفل يقف على باب خيمة، وقد عجزوا بكل قدراتهم التمثيلية أن يمزّقوا منطق الخيمة لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تهادنوا مع منطق الغياب. لعلَّ السّر يكمن في انتظار صحوة مفاجأة، فالتاريخ أعطى الدروس في فنون الصدفة، أو في نبوءات التاريخ ذاتها، هكذا تماماً، عندما صارت الثورة نبوءة أو قدراً أو ألماً فاق الألم، "فللحرية الحمراء باب".
الحديث عن الثورة السورية لايشبه كل حديث، إنه حديث التاريخ والذاكرة، حديث البدايات والنهايات، وعطر الدم العابر للحدود، والألم الذي يرفض أن "يترجّل" عن صهوة الريح واللامنطق. هو الحديث الاستثنائي جداً الذي تجاوز منطق التعبير والإنشاء، إلى منطق الحزن المركَّب. هو حديث الساعات والأمم. ليس لأن قضيتنا تعنيهم، بل لأنَّ وقار الثورة يبدو أكثر وضوحاً في الشمس، لذلك اختاروا الظل لكي يحطموا آمال آخر طفل يقف على باب خيمة، وقد عجزوا بكل قدراتهم التمثيلية أن يمزّقوا منطق الخيمة لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تهادنوا مع منطق الغياب. لعلَّ السّر يكمن في انتظار صحوة مفاجأة، فالتاريخ أعطى الدروس في فنون الصدفة، أو في نبوءات التاريخ ذاتها، هكذا تماماً، عندما صارت الثورة نبوءة أو قدراً أو ألماً فاق الألم، "فللحرية الحمراء باب".
وفي غرف العالم السّرية هناك كلمة أخرى، وقرار آخر، ورؤية مختلفة لتدير الأزمة التي تعمَّقتْ جداً، وتعقدت جداً بفعل الإرادات لتصبح أزمة تتم إدارتها.
فتعقيدها وتشتيتها و"تأزيمها" المتعمد، لا لشيء، بل لتشتيت الأهداف عن المسبّب الرئيس لكل آلام السوريين، وإبقائه في الحكم، فلا خيار أمام النظام العالمي الجديد وحكوماته الخفية بانتزاع نظام يخدم كل أهدافه الاستراتيجية.
فصارت الثورة السورية هي السوق التجاري الرابح الأكثر نشاطاً في الكون، فلا أحد له مصلحة في إنهاء أزمة تدر الأموال في السوق السوداء والبيضاء، بما في ذلك تجارة السلاح والممنوعات. بل حتى تجارة المثاليات والقيم التي تم استعراضها بتمثيليات فضفاضة طوال كل السنين على جراح السوريين، وتلك المنظمات التي تعمل بأسماء شتى، والدول والأمم وغيرها من أفراد وجماعات. فالاتجار في زمن الحرب يجني ثماراً.
عندما بدأ الربيع العربي قبل عشر سنوات، كان لزاماً أن تلحق سورية بركب هذا الربيع وتصنعه، فهي المنظومة الحضارية التي وقعت تحت حكم الفرد والعائلة، بطابع شمولي استبدادي، متمثلة بحم (عائلة الأسد) التي اغتصبت السلطة في انقلاب حافظ الأسد الشهير الذي يسمونه الحركة التصحيحية، عام 1970.
فالحرية هي قدر كلّ شعب يبحث عنها ويدق بابها. والحديث عن الثورة السورية لايبتعد كثيراً عن هذا وذاك. الثورة التي ستكمل عقداً دون حل أو أملٍ بحل..
فكيف استطاع العالم، لمدة عقد تقريباً، أن يصمت عن هذه المأساة التي لا تتعدّى أن تكون فضيحة العالم المعاصر الذي يدّعي الحرية والإنسانية، وأن حقوق الإنسان من أولوياته. إنها، كما صُنفت، مأساةُ القرن بامتياز، وليست ثمة مأساة تفوقها، بما في ذلك ما نتج عن الحربين العالميتين، الأولى والثانية.
لذلك يكون الحديث عن الثورة السورية حديث طويل، يبدأ بالياسمين ويتعمَّد بالدّم وينتهي بأعداد هائلة من بشر. بشرٌ إما فُقِدوا أو فَقدوا، أو غابوا أو تغيَّبوا، أو تشرَّدوا أو تقطَّعت بهم السّبل على الحدود وفي كلّ أصقاع الأرض. فمن أين نبدأ..؟ هل نبدأ بالأعداد؟ فسهلٌ جداً أن نحصي الأعداد. فالسوري صار رقماً، لكنه ليس رقماً صعباً، فهو الرقم الأضعف في المعادلة، معادلة الأمم ومعادلة السياسة، لأنه فقد صيروة الوطن والاستمرار كإنسان طبيعي فوق أرض هي من حقه، ومن حقه أن يكون عليها حراً أبياً سيداً لنفسه، معتزا بهويته السورية التي تمتد عميقة جداً في التاريخ.
اليوم تصبح تلك الأرقام بلا وطن، تحت ذريعة الفشل، وتعمُّد الفشل بإسقاط نظام كان السبب الأول والأخير في مأساة هذه الأعداد. فلا إرادة ولا أصدقاء حقيقيين للشعب السوري الذي تلاعبت به أهواء السياسة والسياسيين. لتصبح تلك الأعداد أسيرة الانتظار، وليبني أمراء الحروب والسياسة ومافيات السلاح أمجادهم وثرواتهم، أما الشعب السوري الذي ضاعت موانئه، فليذهب إلى الجحيم.
وبين صحوة التاريخ والضمير ينتظر السوري مواكب العائدين من النصر، لعل اسمه –بالصدفة- موجود بينهم. ولتسقط كل مقولات التاريخ. فنحن فلم نعد نحصي الأيام، و لا حتى الأشهر. ها نحن الآن نعد السنين، ونكدّس في أرشيف ذاكرة الألم مزيداً من الذاكرة والخيبة والصور. صور لاحصر لها، تم التقاطها خلسة أو دون ذلك. وغدا سيتم اختيار "صورة العام المثالية" من مأساتنا، فهذا أقصى ما وصل إليه العالم، وهو أن تكون مأساتنا معرض صور، يتسابق العالم فيه لاختيار الصورة الأفضل، بين مفاضلة الألم، ووفق منطق الدم والضياع.
فالكل يتاجر بنا على طريقته، والكل يريد أن يبني مجده الشخصي على ملامح التعب والوجع في وجوهنا، وعلى بقايا دمائنا وأجسادنا التي تقاسمتها ضباع العالم. ووفق منطق الشهوة إلى المزيد، لازال التعطّش لإطالتها مفتوحاً على مصراعيه. حتى الصبر استنفذ قواه، وتجمَّدت عروق الضمائر، وانتهى مخزون الألم وصار الحزن روتيناً سورياً. وصارت لعنة الموت تطارد السوري في كل مكان، فإن لم يمت بسيف بشار مات بغيره. مات برداً، أو قصفاً، أو جوعاً أو غرقاً، أو على الحدود، أو برصاص طائشٍ، أو في أحد بلدان اللجوء. حصة دمنا توزَّعت في هذا العالم، وكل أخذ حصته، ولم تنتهِ الحكاية، ولم تنتهِ شهوة الموت إلى الجسد السوري. فنحن لم نمت على طريقة النبي يوسف، نحن لم نُصلَب، ونحن لسنا أنبياء، كي تطالبوننا بالصبر، ولسنا ملائكة كي نتحمل. ولسنا مجرمين كي نقف أمام العدل لندافع عن حقنا في الحياة والوطن، فنحن نريد العدل فقط، أو نريد ظلماً عادلاً.
وقريبا ستدخل الثورة السورية عامها العاشر، ويكون العالم أمام اختبار إنساني جديد، فهل سيطيل أمدها لسنين أخرى –لا قدَّر الله-، أم يفعّل ميزة الإنسانية الضمير ليتخلّص من هذا النظام المجرم، الذي لولا تلك الفرص الممنوحة ممّن يسمون أنفسهم المجتمع الدولي، لَمَا بقي لحظة في السلطة، خاصة أن الثورة بدأت سلمية بيضاء كالياسمين، وهي رغم "سلميتها" زلزلت كيانه.
المجتمع الدولي الذي ترك الجاني لمدة سنين طويلة يستخدم ويجرب كل وسائل القتل والدمار بحق الشعب، بدعم روسي وإيراني قل نظيره. المجتمع الدولي استطاع بأساليبه أن يدير الأزمة ويجعلها أزمة لاجئين، ويركز على قضية اللجوء ليصرف النظر عن أصل المشكلة المتمثلة بنظام شمولي أمني يحظى بدعم عسكري مباشر من أحد أهم أقطاب العالم السياسي، وهي روسيا.
لم يستطع إلا أن يجعل المأساة السورية مأساة إنسانية، ورغم ذلك فشل حتى إنسانياً، فهو بتركيزه على قضايا اللجوء يجعل من الثورة قضية لاجئين، وليست قضية شعب أمام نظام مجرم، جثم على صدور السوريين لأكثر من نصف قرن، تحت حكم العائلة الواحدة التي حولت سورية إلى مزرعة لها، عائلة الأسد التي حكمت بقرار فرنسي استعماري. باعتراف سفير فرنسا في الأمم المتحدة، ووثائق التاريخ.
لكن الدور الذي بدأته فرنسا يوماً ما، تابعته روسيا بكل سفاقة وإجرام. اليوم وكل يوم، كانت روسيا ودعمها العسكري الكامل للنظام الذي بدأ في السنة الأولى من الثورة، إضافة إلى الدور الإيراني والميليشيات الطائفية
لم تكتف روسيا بجيوشها وسلاحها الذي جربته على أجساد السوريين، بل عمدت إلى إجهاض كل قرار دولي من شأنه إدانة النظام أو محاسبته، فالفيتو الروسي كان يداً مرفوعة لحماية نظام بشار الأسد.
تلك هي روسيا ومنظومة الإجرام التقليدية المتأصلة في بنيانها منذ النشوء، كما منعت كل قرار قائم على مبدأ محاسبة النظام على جرائمه، وحتى ملاحقته مستقبلاً.
حتى في أشد لحظات إجرامه، عندما أحرق الغوطة بالكيماوي، في مجزرة الكيماوي الشهيرة التي ذهب ضحيتها الآلاف، وقفت روسيا ضد محاسبة النظام. ففي أول فيتو ، رفعت يدها، ضد قرار فرض عقوبات على نظام الأسد لاستخدامه العنف ضد المتظاهرين. كما وقف الفيتو الروسي ضد مشروع قرار تحويل ملف النظام الى الجنائية الدولية، وكان مشروع القرار قائم على إعطاء محكمة الجنايات الدولية حق الولاية بمحاسبة الأطراف المسؤولة عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية. ومنها مفاقمة مأساة حلب عندما اجتاحها النظام والروس في محرقتها الشهيرة التي هزت العالم عام 2016. كما اُستخدِم ضد مشروع قرار فرض عقوبات على النظام لاستخدامه الكيماوي. ومرات كثيرة أخرى لامجال لذكرها، استخدمت فيها روسيا حق النقض" الفيتو". دعم سياسي بالتوازي مع آلة عسكرية امتهنت قتل الجسد السوري، ووجود ميداني كامل، من عسكريين وقواعد عسكرية. روسيا اليوم كما الأمس، روسيا النار والدم والدعم المطلق للأنظمة المرتبطة بها والمانعة الممانعة لكل ثورة تتطلع إلى التحرر من قيود القمع والاستعمار، تلك الأنظمة التي تتبع لها أيديولوجياً، فهي تحمل عقيدة الاتحاد السوفياتي، تلك العقلية "المافيوية" الإجرامية الاستخباراتية التي شكلت منظومة الاتحاد السوفياتي.
ثم ألم يعلن الرئيس الروسي بكل صراحة ذات يوم، أنه يريد فرض سطوته على العالم تحت طموحات سيادية تنطلق من إرث وعقلية الاتحاد السوفياتي، فالرجل يريد أن يعيد أمجاد اتحاده البائد فوق جماجم السوريين. عشر سنوات من الدعم الروسي العسكري الواضح للنظام تحت أنظار العالم، ومؤسساته العاجزة عن فعل أي شيء سوى الإدانة وإبداء القلق.فتاريخ الإجرام والدم في السياق السياسي الروسي قصة لاتنتهي، فتاريخ روسيا يشهد لها. أما حقبة روسيا مع بوتين، فهي الأكثر دمويةً، لرجل قادم من عمق العقل الاستخباراتي الروسي الدموي الذي تربَّى في أحضان أكثر أجهزة المخابرات إجراماً، وهو حهاز "الكي جي بي".
ولا ننسى دعمها للأحزاب اليمينية المتطرقة في أوروبا وتغذيتها، وخاصة في ألمانيا، تلك الأحزاب التي وقفت ضد اللاجئين السوريين، لكي تتم محاصرة كل سوري حتى لو فرَّ إلى آخر نقطة في الكون.
اليوم، ومع عجز العالم عن كبح جماح التمدد، والدعم الروسي لبشار الأسد للتمادي في قتل السوريين، ما هي الحلول؟
هل هناك حلول سياسية قادمة يحملها العام الجديد؟
أملنا كبير أن يزهر الربيع السوري ياسميناً يعبق في فضاءات الحرية.
أسماء شلاش