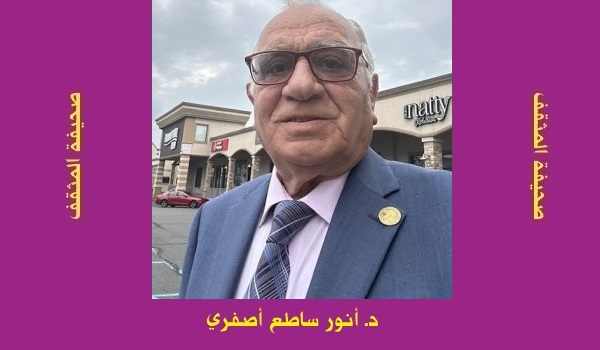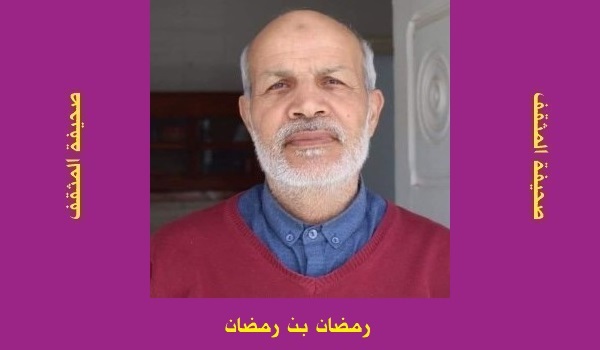ظاهرة الإستسقاط* تتكرر بشكل خاص في السرديات التاريخية، توفر السرديات الإستسقاطية وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار الداخلية، مما يسهل عملية الفهم الذاتي ،كما يساعد استخدام هذه السرديات في تحليل التجارب الشخصية وفهم كيف تؤثر على السلوكيات والقرارات كذلك تسهم في تشكيل الهوية الشخصية، حيث يمكن للأفراد استخدام قصصهم لتوضيح من هم وما يرغبون في أن يكونوا، تتيح السرديات الإستسقاطية للأفراد التواصل مع الآخرين ، مما يعزز الروابط الاجتماعية حيث يسعى الناس لفهم الأحداث المعقدة من خلال إيجاد روابط غير منطقية بين السبب والنتيجة، تعتبر الحضارة السومرية من أقدم الحضارات المعروفة، وقد تركت وراءها العديد من السرديات والأساطير، في اغلب هذه السرديات، نجد أنهم قد ربطوا بين مختلف الظواهر الطبيعية، مثل الفيضانات، الزراعة، والآلهة، بشكل يبدو غير منطقي واستمرت هذه الظاهرة في أكثر السرديات التاريخية التي اعقبتها مما جعلها تستمر في التأثير الى الوقت الحاضر. كان السومريون يعتقدون أن الآلهة تتحكم في الظواهر الطبيعية، مثل الفيضانات والمواسم، مما أدى إلى ربط الأحداث الطبيعية بقرارات الآلهة في أساطيرهم ،كما نجد تفسيرات عملية الخلق لا ترتبط بالأحداث الكونية بل بفعل حاجة الالهة الى العبادة والتقدمات، مما يعكس رغبتهم في فهم وجودهم من خلال سياقات دينية وروحية امتد تأثيرها الى سرديات الاديان ، ان دراسة ظاهرة الإستسقاط تساعد في فهم كيف يمكن للأفكار والأساطير أن تتشكل وتؤثر على المجتمعات، كما تعكس كيفية تعامل البشر مع عدم اليقين من خلال البحث في الأنماط والمعاني المتعارضة، حتى في غياب الأدلة المنطقية ،الإستسقاط هو في حقيقته ظاهرة نفسية، وهو جزء مهم من معرفة كيفية بناء السرديات التاريخية من ناحية ابداعية، ان فهم هذه الظاهرة يساعدنا في فهم السياقات الثقافية والدينية التي شكلت الحضارات القديمة.
الإستسقاط والتفكير الاستنتاجي
التفكير الاستنتاجي هو عملية منطقية تستند إلى أدلة وفرضيات، حيث يتم الوصول إلى نتائج من خلال تحليل المعلومات المتاحة ،الإستسقاط يعتمد على الرغبة في إيجاد معنى أو نمط في المعلومات، حتى في حالة عدم وجود علاقة حقيقية بين العناصر، التفكير الاستنتاجي يعتمد على بيانات واضحة ومنطقية، حيث يتبع خطوات محددة للوصول إلى نتائج صحيحة يمكن أن تؤدي إلى قرارات أو معتقدات صحيحة، اما الإستسقاط يستند إلى روابط ضعيفة أو غير موجودة والتي تظهر غالبًا في السرديات التاريخية و الأساطير، نتيجة حالات القلق والشك، حيث يسعى الأفراد للبحث عن معنى بينما يحاول استخدام الإستسقاط لإيجاد روابط غير منطقية في عالم معقد وغير مؤكد.
التحيزات المعرفية والإستسقاط
التحيز هو الميل إلى البحث عن المعلومات التي تؤكد المعتقدات السابقة، وتجاهل المعلومات التي تتعارض معها، يمكن أن يؤدي إلى ربط الظواهر غير المرتبطة من خلال الاعتماد على المعلومات المتاحة بسهولة، مما يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة وبناءً تجارب على أحداث عابرة ،الميل إلى افتراض أن هناك علاقة سببية بين حدثين لمجرد حدوثهما معًا، دون دليل على وجود علاقة فعلية والاعتقاد بأن الأمور ستسير بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المخاطر أو الأحداث السلبية ،لكن بفضل القصص أو السرديات تجعل الأحداث تبدو مترابطة، حتى وإن كانت هذه الروابط غير منطقية دون الوعي بهذه التحيزات يمكن أن يساعد الأفراد في اتخاذ قرارات باستخدام العواطف القوية كما يساعد في جذب انتباه الجمهور وإحداث تأثير عميق.
الإستسقاط والتفكير السحري
التفكير السحري هو اعتقاد بأن الأفكار أو المشاعر يمكن أن تؤثر على الأحداث الواقعية، حتى في غياب أي دليل منطقي، كما ينشأ من الحاجة البشرية لإيجاد تأثير في أنماط في بيئة معقدة، مما يؤدي إلى تفسيرات غير مدعومة بالأدلة، التفكير السحري ينشأ من الرغبة في السيطرة على العالم الخارجي أو التأثير فيه، وغالبًا ما يكون مدفوعًا بمشاعر الخوف ، يعكس ميل الأفراد للبحث عن روابط أو تفسيرات في الأحداث، حتى عندما تكون هذه الروابط غير موجودة، التفكير السحري يمكن أن يؤدي إلى الإستسقاط، حيث يربط الأفراد بين أفكارهم أو مشاعرهم وأحداث معينة، مما يجعلهم يستنتجون أن هناك علاقة سببية، في العديد من الثقافات يمكن أن نجد أمثلة على التفكير السحري (الطقوس أو الخرافات) التي تتضمن الإستسقاط، حيث يتم ربط أحداث معينة بممارسات أو تعاويذ معينة دون أي دليل علمي ،الإستسقاط والتفكير السحري مرتبطان بشكل وثيق، حيث يعكسان ميولًا إنسانية لفهم العالم من خلال إيجاد معاني وروابط حتى في غياب الأدلة العقلية .
العقلية النقدية
تشجع العقلية النقدية على تحليل المعلومات بشكل موضوعي، مما يساعد في تحديد الروابط الحقيقية بين الأحداث والأدلة المتاحة، والتأكد من مصداقية المصادر التي تُستخدم لتكوين الآراء أو الاستنتاجات، استخدام أساليب التفكير المنطقي يمكن أن يساعد في تفكيك الروابط غير المنطقية، مما يقلل من احتمالية الوقوع في فخ الإستسقاط ، الاستعداد لتقبل النقد والملاحظات يمكن أن يعزز القدرة على التفكير النقدي وإدراك التحيزات المعرفية التي قد تؤدي إلى الإستسقاط ،التفكير النقدي يسعي بشكل مستمر لاكتساب المعرفة في مجالات متعددة التي تساهم في فهم العالم بشكل أعمق، مما يقلل من الاعتماد على الإستسقاط ،ان فهم الأخطاء جزء من عملية التعلم الذي يمكن أن تحفز الأفراد على تحسين تفكيرهم النقدي، تعتبر العقلية النقدية أداة قوية من خلال تحليل المعلومات وتطبيق التفكير المنطقي وتعزيز الوعي الذاتي.
انتشار السرديات الإستسقاطية
يميل الأفراد إلى البحث عن المعلومات التي تدعم معتقداتهم، مما يسهل انتشار السرديات التي تربط بين ظواهر غير مرتبطة، توفر السرديات الإستسقاطية وسيلة للتعبير عن المشاعر والأفكار الداخلية، مما يسهل عملية الفهم الذاتي، اذ يعتمد الناس على المعلومات المتاحة بسهولة، مما يؤدي إلى تكرار السرديات التي تتضمن روابط ضعيفة، قلة الوعي التاريخي أو الثقافي يمكن أن تعزز من قبول السرديات الإستسقاطية، حيث يسهل على الأفراد تصديق الروابط غير المنطقية عندما تكون الظواهر معقدة في غياب المعرفة العلمية الصحيحة، تلجأ السرديات الإستسقاطية لتبسيط الفهم.
السرديات الإستسقاطية خلل معرفيا
في بعض الأحيان تكون السرديات الإستسقاطية مقصودة كوسيلة لنقل قيم ثقافية أو دينية معينة، حيث يسعى المؤلفون توجيه الرسائل من خلال روابط غير منطقية، يمكن أن تُستخدم هذه السرديات في سياقات سياسية أو اجتماعية لتحفيز مشاعر معينة أو لتأليب الجماعات حول فكرة معينة، اذ تعكس هذه السرديات فهمًا غير دقيق أو محدود للعلم والمنطق، مما يؤدي إلى ربط الظواهر بشكل غير منطقي ،بعض السرديات تنبع من رغبة بشرية في إيجاد معنى أو تفسير في عالم معقد، مما يعكس نقصًا في التفكير النقدي في الكثير من الحالات قد تكون السرديات مزيجًا من كلا الجانبين، حيث قد تكون رسائل مقصودة في بعض السياقات بينما تعكس خللًا معرفيا في حقيقة سياقاتها مما يساعد في فهم تداخل العوامل الثقافية والاقتصادية والسياسية في السياق.
***
غالب المسعودي – باحث عراقي
............................
* الإستسقاط السردي: هو مصطلح يشير إلى الميل البشري لإيجاد أنماط ذات معنى في المعلومات العشوائية أو غير المترابطة، وتطبيقها على القصص والروايات. وبعبارة أخرى، هو محاولة ربط أحداث أو أشياء منفصلة في سرد ما، وإعطائها معنى جديدًا ليس بالضرورة موجودًا في الأصل.
1- سعود سالم - ظاهرة الإستسقاط وعلاقة الفن بالهلوسة - الحوار المتمدن
2-إستسقاط – ويكيبيديا