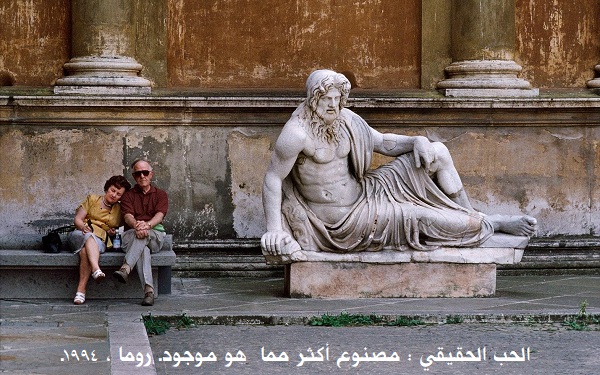صحيفة المثقف
هل أمريكا هي الكورونا، والكورونا هي أمريكا؟
 أمريكَا يكفي! لقد وحّدتنا الكورونا!
أمريكَا يكفي! لقد وحّدتنا الكورونا!
مقدمـة:
هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هي ناشرة الكورونا؟؟ هاهي الصين تتهم أمريكا رسميّا باختراع الفيروس بواسطة عسكريين أمريكيين نشروه بسوق للحيوانات البحرية في يوهان أثناء الألعاب العسكرية العالمية في أكتوبر 2019. ألم تسمح لنفسها باستعمال سلاح دَمارٍ شامل هو القنبلة النوّوية على اليابان اثناء الحرب الإمبرياليّة الثانية؟ ألم تستعمل النّاپالِم في فيتنام ضدّ الثورة عليها هناك؟ ألم تزوّد «إسرائيل» بأسلحة دمار شامل ضدّ المقاومة العربية؟! هل ستكون الكورونا أكثر فتكًا ممّا فعلته الولايات المتحدة طيلة العصر الحديث ضدّ الإنسان والبيئة داخل حدودها (حجم الفقر والتشرد والاختلال الصحي) وخارجها؟! أليست الرأسمالية نفسها، وصلت إلى طور رأسمالِية الاستثمار في الكوارث (إنتاجًا لها ثم إنقاذًا، إذ في الإنقاذ كما في الإنتاج ربح اقتصادي وصيدلاني ودَوائي) [آنظر: أنتوني لوينشتاين، رأسمالية الكوارث: كيف تجني الحكومات والشركات العالمية أرباحًا طائلة من ويلات الحروب ومصائب البشرية؟، عالم المعرفة، الكويت، نوفمبر 2019].
لن أناقش مدى قوّة القرائن الصينية والإيرانية التي قد تصل إلى قوّة الدليل، ولكنني أريدُ أن أجُوس خلال الشخصية القاعدية للدّولة العميقة الأمريكية، أي أن أفكّك إبِسْتِميّتها: هل داخل هذه الإبِسْتميّة فيروسات يُمكن أن تنتج فيروس الكورونا فما دونه وما أخطر منه؟؟ هل إنّ ما قاله شاعرنا محمود درويش «أمريكا هي الطاعون. والطاعون هو أمريكا» يمكن أن يَجد مِصدَاقية في البحث الإبِسْتمي؟!
ربّما نجد إجابة عن هذا السؤال إذا فككناه: ماهو «العقل» الذي أنتج الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل فيه فيروس كورونا؟ هل دَاخِلهُ أسلحةُ دمارٍ شامل مخياليةٌ قابلةٌ للتحوّل و اقعيّا؟!
وإذا كان ذلك كذلك، ما أثره إذا اكتشفته كل شعوب العالم؟ أيْ ما آثاره على مستقبل الإنسانية؟؟
1- تأسيس الولايات المتحدة هو تأسيس بروتستنتي- صهيوني:
عام 1831، كان المسلمون خارج الحياة العالمية، ولم يكونوا يمثلون أيّ خطر إيجابي أو سلبي. ولكنْ في ذلك العام، يكتب جورج بوش (الجدّ الأكبر للأبواش المعاصرين): «حياة محمد» ليصف فيه النبي والمسلمين بأسوإ النعوت: «أعراق مُنْحّطة» «حشرات»، «جرذان»، «أفاع». ودعا فيه اليهود إلى «ضرورة العمل من أجل تجميع يهود العالم في فلسطين»، وإلى ضرورة «استعمال وسائل الدمار الشامل لإفناء السارَزِن» (أي «العرب» و«المسلمين» في التعبير الصليبي أثناء حروب الفرنجة)، قائلا: «ما لَمْ يتمّ تدمير إمبراطورية السَّارَزِن، فلن يتمجَّد الرب بعودة اليهود إلى وطن آبائهم وأجدادهم». ولذلك لم يكن غريبًا أن يعلن حفيده جورج بوش الابن «حملة صليبية». كان بوش الجدّ الأعلى مبشرّا بالصهيونية وأسطوريّتها في وقت لم يكن فيه يهوديّ واحد صهيونيًّا.
فلقد كان تأسيس أمريكا نفسه تأسيسا للصهيونيّة. فهي ليست إلا الفهم البروتستنتي- البِيُوريتاني التطبيقي «لفكرة إسرائيل التاريخية في أدبيّات تلك الإسرائيل [الولايات المتحدة]»، بتقمّصٍ لإسرائيل الأسطورية الأولى، وبتقمّص لأبطالها ووقائعها وأبعادها الدينية والسياسية. وبذلك أنتجت الميثولوجيا القديمة ميثولوجيا حَداثية.
ولذلك سمَّى المستوطنون الأوائل أنفسهم «إسرائيليين» و«عبرانيين» و«يهودًا»، وأطلقوا على ما يُسمّى اليوم «نيو إنكلند»: «أرض كنعان»، و«صهيون»، و«إسرائيل الجديدة». فكتب جورج فوكس (1624-1691): «أن تكون يهوديًّا باللحم والدم لا يعني شيئا. أما أن تكون يهوديّا بالروح، فهذا يعني كل شيء. وكتب السّناتور بِيفَرْدج عام 1900: «إن الله اصطفى الأمة الأمريكية بين كل الأمم، وجعلها شعب الله المختار» وذلك من أجل قيادة العالم وتخليصه من شروره». وكانت لغة التدريس في جامعة هارْفارد هي «اللغة» «العبرانية» عند تأسيسها عام 1936، رغم عدم وجود هذه اللغة، فليس هناك إلا السريانيّة، وما العبرانية إلا إحدى لهجاتها.
هاهو كلنتون يصرّح أمام «الملائكة» (قادة الكيان الصهيوني) أن كاهنه الذي ربّاه أوصاهُ: «إذا تخليت عن إسرائيل فإن الرب سيغضب عليك»، وقد علَّمه أن «إرادة الله تقضي بأن تكون إسرائيل- كما هي في العهد القديم- لشعب إسرائيل إلى الأبد». وهذا الرئيس بوش الإبن كان يقرأ كل صباح عِظات مبشرّ عسكري شارك في الحملة على فلسطين عام 1917. وهاهو ترامب بعد زيارته للسعودية يزور حائط المَبكى، ويبكي أمامه مع ابنته، مؤديا طقوسًا يهودية بصحة حاخام، مرتديا القلنسوة اليهودية، وهو أوّل رئيس أمريكي يفعل ذلك، وأول مَنْ يعترف عمليًّا بالقدس عاصمة للكيان وبالمستوطنات، وسيادته على الجولان السوري (الذي كاد حافظ الأسد يحرّره كله عام 1973 لولا خذلان السادات، كما جاء في وثائق هيكل)... وفي ذلك تسبب في إراقة دماء جديدة للشعب الفلسطيني، وتكريس للتدمير الأمريكي الشامل للوطن الفلسطيني والوطن العربي والإسلامي منذ عام 1948... وهاهو تْرامْب ينظر إلى السماء في 22/8/2019 قائلا: «أنا الشخص المختَار من الرب ليواجه الصّين» (بِي بِي سِي نيوز).
إنّ البروتستنتية الصهيونية تتبنى العهد القديم برمّته، وخاصة أسفاره التاريخية (إذ أنّ أسفاره الشعرية- العرفانية ليست عنصرية، بل تُدِينُ اليهودَ أحيانا كثيرة). فلقد بدأت الصهيونية بروتستنتية، قبل أن تنتشر لدى كثير من اليهود، ولدى بعض المسلمين. ولكنْ للصهيونية «المسيحية» و(حاشا مسيح الرحمة، ذلك الحكيم السوري العظيم أن يكون ذا عصبيّة عنصرية) كانت سبَّاقة بكثير من القرون على الصهيونية اليهودية. ولتلك الصهيونية «المسيحية» تغليب للعهد القديم على العهد الجديد، بل للأسفار التاريخية (التكوين، الخروج، يشوع، الملوك...) على الأسفار العرفانية (أيوب، المزامير، الأمثال، إرميا...).
وتلك الأسفار التاريخية أسفار تحمل عصبية عنصرية- تدميرية خطيرة، نستغرب إلى حدّ الآن من عدم تنصّل الكنيسة العربية منها، وخاصة الكنيسة الفلسطينية (أول كنيسة في التاريخ العالمي) وتبرّئِها منها. فكل فلسطين، حسب سفر يشوع «مَوْهوبة لبني إسرائيل» ، «من صحراء النقب في الجنوب إلى جبال لبنان في الشمال، ومن البحر المتوسط في الغرب إلى نهر الفرات في الشرق، بما في ذلك بلاد الحِثّيّين» .
وإنها لفضيحة أن لا يمزق المسيحي العربي تلك الصفحات إلى حدّ اليوم، فلماذا نلوم الدّولة العميقة الأمريكية على إيمانها بها؟!!
ودون ذنب جَنَتْهُ أرِيحَا (أقدم مدينة في العالَم) مع «بني إسرائيل»، قادَهم يَشوع في أبشع أسطورة بالعالم، «ودَمَّروا المدينة، وقضوا بحدّ السيف على من فيها من رجال ونساء وأطفال وشيوخ، حتى البقر والغنم والحمير»، ونهبوا «كل غنائم الفضة والذهب وآنية النحاس والحديد» . وكذلك كان الأمر بكل المدن الفلسطينية، مثل مدينة عاي التي «أحرقوها بالنار» و«قتلوا كل مَنْ فيها» ...وهذا كله لم يحدث في التاريخ السوري، فلمْ يدوِّنه أحد من المؤرخين السوريين في هذا العصر وما بَعْدَه، ولكنه يتحقق إذا آمن به اليهودي أو «المسيحي» الصهيوني. وها إنه تحقق أوّلاً مع دولة «الإسرائيل» الإنكليزية- السَكصونية (التي اصبح إسمها: الولايات المتحدة الأمريكية) ثم مع ابنتها «دولة إسرائيل» منذ عام 1948.
لقد شرب الپيوريتاني الأمريكي من دِماء البشر (ومنهم الفلسطينيون) في مخياله قرونًا عديدًا، ثم مَارَس ذلك قرونًا عديدة مع الهندي- الأحمر ومع الإفريقي الأسود، ثم مع الفلسطيني والعربي منذ عام 1948، وقبله الفيلپيني. فلماذا لا يشرب اليوم من دم الصيني ودم الإيراني (الذي هدّد الرئيس المؤمن ترامپ قبل بضعة أشهر بشرب دم مقاماته الدينية، فكان شُرْبُ كورونا من دم الوافدين إلى قُمْ بعد زمن وجيز) «حتى تدرك جميع الشعوب أنّ يد الرّبّ [ربّ أمريكا] قوية» ، الذي يقول لـ«يشوع» الأمريكي: «ولن يقدر أحدٌ أن يُقاوِمك كل أيام حياتك، لأني سأكون معك» .
فلتُعْلن الولايات المتحدة الأمريكية براءتها من سفر «يشوع» ومن الصهيونية حتى لا نشك في أنها أرادت قتل الشعبين الصيني والإيراني بالكورونا، فأفلت منها الفيروس وانتشر في جميع أنحاء العالَم!!
2- الولايات المتحدة تدمِّر الشعب «الهندي الأحمر» بالحرب الوبائية لكي تتحقق:
يجب أن نعترف بأننا لم نتواصَل بَعْدُ مع هذا الشعب النبيل. ومن أبرز الأدّلة على ذلك أننا لا نعرف إلى حدّ الآن ماذا سمَّى هذا الشعب نفسه، بل نُسمّيه ونَصفُه بما سمَّاه و وَصَفه المحتل المدمِّر الأوروبي.
باعتبار أنّ أمريكا هي «أورشليم» الجديدة، فلقد أباحها إله إسرائيل المتعطش للدم «الكنعاني» (أي للدم غير «الإسرائيلي»)، للإسرائليين الجُدُد، أي للبيض المستوطنين للقارّة. وهذا «رسول الحرية» الرئيس جِفَّرْسون يقول عن هؤلاء الحمر: «سنفنيهم ونمحوا آثارهم من هذه الأرض» في ترديد لصوت إله «إسرائيل» وهو يحرّض «يسّوع» الأمريكي.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية وريثة «إسرائيل» أعظم ممارس للدمار الشامل في التاريخ البشري. «فلقد أبادت 400 شعب أحمر، أي قرابة 112 مليون إنسان، بواسطة التقتيل المَّادي، والترحيل بالقوّة تحت الثلوج وعلى الصخور وعلى امتداد أميال سحبًا، وبواسطة التجويع والمحاصرة، والغدر، والقَنْص، والتدمير الاقتصادي (إتلاف المحاصيل...)، وخاصة سلاح الدمار الشامل الخطير: السلاح الجرثومي» . وذلك بنشر الأوبئة بين «الهنود الحُمْر» نشر الجدري، ببطّانيّات وملابس و«هدايا» من مستشفيات البيض التي تؤوي مرضى الجدري...وهكذا دفعت أمة الحُمْر الثمن غاليا لوداعتها وجنوحها للسلام باستمرار، فحتى حربهم كانت شريفة إذ كانت الحرب في دينهم الفطري- التوحيدي – الأرواحيّ حربًا استعراضية، أي كانت من أجل إثبات التفوّق؛ كما دفعت الثمن غاليا لتحالف بعضها مع البيضِ ضد بعْضها الآخر.
لقد تفطّن الحُمر إلى هذا السلاح الجرثومي عديد المرات، ولكن ثقافتهم المفرطة في التسامُحية كانت دائما «توقِعهم» في «خطئهم» السابق. وفي السبعينيات من القرن العشرين اكتشفت الطبيبة «الهندية- الحمراء» كُوني أُوري في سجلات المستشفى الذي تعمل فيه نسبة مرتفعة جدّا من نساء جنسها الذين أُخْضَعن للتعقيم بعد يوم أو يومَيْن من وَضْعِهن . يقول جيمس بولدين، النائب بالكنغرس بين 1934 و1939: «إنّ قدر الهندي الذي يواجه الإنكلو- سَكْصُونيّ هو نفسه قدر الكنعاني الذي يواجه الإسرائيليَّ».
هاهي الولايات المتحدة تسمّي أسلحتها : «هوك» و«أپاتْشي» باسم الزعماء الهنود الذين قهرتهم وقتلتهم. وهاهخي تُسمِّي «سياتل» باسم الزعيم الذي أطردَتْ قبيلتِهِ مِن ذلك الفضاء. وهاهو المناضل الهندي- الأحمر إيغل يقول عام 1996 عن الإبادة الصهيونية في فلسطين: «هذه واحدة من الإبادات الكثيرة التي واجهناها وسيواجهها الفلسطينيون (....). إنّ جلادنا المقدّس واحد» .
ولم يكن توطين السود بالولايات المتحدة إلاّ تعويضًا عن هنودٍ حمرٍ رفضوا أن يكونوا عبيدًا لدولة «إسرائيل» الجديدة. ولم يكن وصول إفريقي واحد إلى الشاطئ الأمريكي إلا مقابل مقتبل مائات من السود أو غرقهم أو موتهم من الوباء على الطريق، من ساحة القتال على الأرض الإفريقية إلى جزيرة غورو السّينغالية فأمواج الأطلسي المظلمة.
3- الولايات المتحدة تنتصر على الثورة الفيلپينية بالحرب الوبائية:
مِن مُفَارقات الدهر الإمبريالي أنّ المستعمِر يقتل المستعمَر ثم يمشي في جنازته، سواءًا كان إسمه فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا أو هولندة...
هذه الولايات المتحدة الأمريكية تُواجَهُ بمقاوَمة «فيلپّنية» بين عَامي 1899 و1902، كادت تنتصر، وفي لحظة إمكانية انسحاب القوّة الأمريكية المحتلة، كان قرار الإدارة الأمريكية عام 1900 بـ«هجوم مدمِّر للهَيْضة [الكوليرا] والجدري والدُّوزنطارِيا والمَلاريا والسل، وغيرها من الأمراض المميتة (..)» . لم يكُنْ المنكوب المستعمَرُ ليعْلَم ذلك «إلاّ مِن تحت اللْحُود» (كما يقول الأديب محمود الدُّوعاجيّ)، أي لما أفرج الأرشيف الأمريكي عن هذا السّرّ في الخمسينيات من القرن العشرين.
والأدْهَى، أنّ المستعمِرَ الأمريكي بَعْد أن كان محلّ حقد الشعب «الفيلِپّيني»، أصبح محل عشق (وليس محلّ حب عادي)، إلى درجة تناسِي لغة المستعمر السابق (الإسبانية) والإقبال على لغة المستعمِر/«الصديق العظيم» الجديد، بل تَخَلِّي منطقة أمان الله (مَانيلاَّ) وغيرها عن دينها السابق، والإقبال على دين المستعمِر/«الصديق العظيم»: الپروتستنتيّة التي أصبحت دين الأكثرية، بعد أن كان دين «أمان الله» السابق هو دين محمد. وذلك أن القاتل، بَادَر في نفس الوقت إلى مدّ السكان بالدّواء واللّقاح المناسِبَيْن الناجعيْن مستدخلاً لأوّل مرّة الطبابة الأوروبية الحديثة ليتخلى المقتول طوعًا عن طبابته التقليديّة، الموروثة، إذْ أصبحت «كلها» في تمثله «غير صالحة». وبذلك أصبح القاتل، محييًا للموتى، إلاهًا قديرًا، أخرج الفيلِپّينيين من «الخرافة» و«التخلف»، مُدخلاً إيّاهم في عصر «العقل والعلم»، كما يرى المؤرخِون والمثقفون الفيلپّنيّون الحَداثيّون ، في تمثّل مطلق لمذكّرات القائد الأمريكي «وُرْشِسْتر»، الذي بَعْد أن وصف الثورة عام 1899 بـ«البسالة» و«الجرأة» و«الدهاء العسكري» و«الروح الانتصارية»، أصبح يصفها عام 1900 بـ«الأدوات المسرحية» يُحركها «مُخرج» أمريكي «يتقهقرون في فوضى هائلة» ، ثم انبرى ليصف قيادته المظفرة لحربه ضدّ الهيضة «المسرحية»- «القَرَهْ- قُوزِيَّة». عندها «أصبح» المقاوِمُ «عدوًّا» لشعبه الفيلپّيني، بينما «أصبح» المحتل الأمريكي «صديقًا عظيمًا» شافيا ومنقذا، في عيون الفيلِپينيين.
فمالم يستطيع المحتل الأمريكي أن ينجح فيه، حققته الهيضة، فرَّ سكان «أمان الله» (مانيلاَّ) إلى الغابات، هربًا من الوباء، ودخلت القوّات المحتلة إلى المدينة دخول المنتصرين، ولكن إلى مدينة دون سكان. وكانت قبضة الوباء أكثر كثافة وفتكا بالأراضي التي يهيمن عليها رجال المقاومة . وهنا أعلن زعيم المقاومة (ميكائيل مَلْوار)، الاستسلام دون شروط، فالمجاعة فتكتب بشعبه ورجاله، وكذلك الموت المتسارع، بل إن أصابع اتّهام الكثيرين من شعبه أصبحت متجهةً إليه، إذ قَبِلوا في ذلك الإشاعات الأمريكية.
مدَّ العسكريُّ الأمريكيُّ الفيلپّينيَّ، الجائع الموبوء، بالدّواء والطعام معًا، وكانت دهشة الفيلپّني عظيمة أمام نجاعة الأمريكيّ و«كرمه» و«ذكائه الإلهي». لم يكن الجيشُ الأمريكيُّ وحده متجاهلاً قامعًا لطبّ الشعب الفيلپّيني الموروث ، وقد كانت بعض الأدوية العلاجية الموروثة ناجعة نسبيّا، كالمستخلصة من شجرة «لَلْما تُونِج» ، بل إنّ الشعب نفسه قد انصاع لهذا التجاهل، مع ما يعني ذلك من انطماس الكثير من الخِبرات التاريخيّة التي ليسها لها آثار جانبيّة كالطّب الأوروبي الحديث. ولم يكن الحجر الصحي الأمريكي المفروض، مجرد إجراء استشفائي، بل كان أيضا في الوقت نفسه، حظر تجوال على شعب مقاوِم، ذكيّ جدّا في مقاومته. وكان أيضا عمليّة إعادة تهيئة نفسية وثقافية وجسدية لشعب «آخر»، حتى يصبح شعبا «ذليلا»، «مِطواعًا»، قاطعًا مع أصوله الثقافية؛ وخاصة نخبته، وطال التدمير حتى أسلوب العِمارة والسّكن، بتعلّة القضاء على الوباء. وقد قَمع القائد العسكري «وُرْشُسْتِر» الأطبّاء التقليديين بعنف، والذين أصابوا الكثيرَ من النجاحات عام 1905، وخاصة المَلِكة الطبِيبَة في منطقة «تَيْتَاي» .
4- العالَم ما بعد الكورونا ليس كما قبله: نريد بشرية متسامحة متضامنة اليوم:
- أيها السادّة! لِتَكن إيطاليا بعد تعافيها من الكورونا ليست إيطاليا قبلها، وإلا فستكون غبيّة. ها قد وجدت الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة لا يلتفتون إليها، وهاهي تجد روسيا والصين وكوبا صديقات لها. سيكون الإيطاليون أغبياء إذا تركوا القواعد الأمريكية على أراضيهم وإذا بقوا منخرطين في حلف شمال الأطلسي وإذا بقوا مُعادين أغبياء لروسيا والصين وأمريكا الجنوبية المقاوِمة ولإيران ولفلسطين المصْلوبة منذ الاحتلال البريطاني.
- أيها السادّة!.. ليَكن المسلمون بعد تعافيهم مِنْ هذه الأزمة غير المسلمين قبلها. ليتخلوا عن أفكارهم المتعصبة ضدّ الأديان والمذاهب الأخرى. ليتخلوا عن عصبياتهم التي مزقتهم أشلاءًا. لِيَتخلَّ الإخوان المسلمون عن تحالفهم مع السلفيّة الجهادية التي بَنَتْ كِيانات أپارْثايدْ في سوريا والعراق، متسبِّبين بذلك التحالف في دمارٍ شامل لَنْ تندمل جراحه بين يوم وليلة. ليعُدْ المسلمون (متديّنين وعلمانيين) فهمَهم للإسلام دين «الرحمة للعالمين» و«الجنوح للسلم» و«الأمْر بالعَدْل والإحسان» و«الدخول في السلم كافّة» (حتى في سورة الغضب: سورة التوبة)! ليتخل المسلمون عن تبعيتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية وليقتدوا بالأمم العظيمة (كوريا، الصين، إيران، روسيا، كوبا...) التي رغم جراحاتها لم تكن عدوانية وانتقامية دون إسقاطات عنصرية ومذهبية و«دينية، بل بادَرتْ إلى نجدة الملهوفين في إسبانيا وإيطاليا!
- أيها السادّة! لِيتحلَّ المسيحيون في العالَم، وخاصة العرب منهم (لأنهم هُم الذين كانوا أتباع المسيح الأوائل) بالشجاعة، ولينظفوا كتابهم المقدَّس من كل دَنَسِ العصبية العنصرية التدميرية، وإلا لا حق لهم في الانخراط في حرب المقاومة الشعبية في «أريحا» والوطن الفلسطيني! أخرجوا كيان «إسرائيل» من الكتاب المقدّس قبل إخراجه من الأرض! فوجودُهُ «المقدّس» في ذلك الكتاب هو الذي صنع فيروسات التدمير الشامل الأمريكي لشعوب العالم...
لنقرأ معًا، بخشوع المتدينين كلمات الزعيم الهندي الأحمر (سياتل) عام 1845:
«يقول السيد الأبيض [الأمريكي] إن الزعيم الكبير في واشنطن يُهدي إلينا تحيّات الصداقة والنوايا الطيبة، (..) ليست به حاجة إلى صداقتنا، فأبناء شعبه كثيرون (..) أمّا أبناء شعبي [فقد أصبحوا] قليلين مثل شجرات متناثرة في سهل كنسته العاصفة.
وقد بعث الزعيم الأبيض العظيم (..) إلى شعبي رغبته في شراء أرضنا مقابل أن يوفر لنا عيشا مريحًا، وهذا يبدو عادلا في الحقيقة، لأن الإنسان الأحمر لم يعد له حق يستحق الصون (..) ولأننا لم نعد في حاجة إلى أراضٍ فسيحة (..)، ونحن أيضًا قَمِيئون باللوم (..). عندئذ سيكون [الزعيم الأمريكي أبًا حقا، ونحن سنكون أبناءه. ولكنْ أيمكن لمثل هذا أن يحدث؟! [لا]... فربّكم ليس ربنا. إنّ ربكم يحب شعبكم ويكره شعبي. إنّ ربكم يجعل شعبكم أقوى يومًا بعد يوم، وقريبًا ستملؤون المدى. أمّا أبناء شعبي فيضمحلّون مثل مَدٍّ ممعن في الانحسار(..) فكيف لنا أن تكون إخوةً إذن؟! (..) ربما يكون زمان أُفُولكم لما يزل بعيدًا، لكنه قادم دون ريب (..) فحتى الإنسان الأبيض لن يَقْوَ على القدر المشترك. وربما سنصبح إخوّة [آنئذ] بعد كل شيء (...) ».
ولنرتل معًا ما قاله سياتل لشعبه: «بعث الرئيس من واشنطن رسالة يعلمنا فيها عن رغبته في شراء أرضنا، ولكنْ كيف يمكن شراء السّماء أو الأرض أو بيعهما؟! هذه الفكرة غريبة علينا. كل جزء من هذه الأرض مقدّس عند شعبي (..) نحْن جزء من هذه الأرض، وهي جزء منا. الأزهار العَطرة إخوتنا. والدببة والغزلان والنسور إخواننا. كل خيال في مياه البحيرات الصافية تخبر عن ذكريات في تاريخ شعبي. ورقرقة المياه صوت أجدادي».
لنرتل معًا ما ختم به سياتل : «حافظوا في أذهانكم على ذاكرة الأرض، كما كانت عندما استلمتموها. حافظوا على الأرض لجميع الأطفال وأحبّوها كما يحبّنا الله جميعا. نحن واثقون من أمْرٍ واحد، أنّ الله واحد (..) لذلك نحن إخوّة في نهاية المطاف».
أيها الموسيقون، ألا تستحق كلماتُه أنْ تُلَحَّنَ في سنفونية عظيمة! رحِمهُ الله تعالى!!
خاتمــــة:
1- هذه الأرض ذاهبة في تاريخ الانقراض، وهذه البشرية التي عليها كذلك، بسبب تعاظم غطرسة الإمبريالية التي طال أمدها كثيرًا جدّا، وبسبب قصور الشعوب النائمة التي طال نومها وتبعيّتها كثيرًا جدّا.
2- لتكن الكورونا موقظةً لنا. فنتحد جميعًا، من أجل عالَم تضامني، عَدَالي، إنساني، ومن أجل أديان ومذاهب تسامحية، تحب الله إلاهها الواحد وإنسانه المكرَّم.
3- اتضحت الصورة. كما قال الشاعر الأمريكي الأسود: إمامُو بَرَكة، «أمريكا- هذه- يجب أن تسقط». وذلك بثقافة جديدة، متجددة، ثقافة الوحدة الإنسانية، ثقافة التبرّئ من الإمبريالية والصهيونية والتفاوت الاجتماعي ورأسمالية النهب والقتل والابتزاز وأخلاقية القهروالكوارث. لنقُلْها جميعًا، كل شعوب الأب آدَمَ التي وحّدتها الكورونا: «أمريكا يَكفي! نحن آتّحدنا!!».
د. عادل بن خليفة بِالكَحْلة
(باحث أنثروبولوجي، الجامعة التونسية)