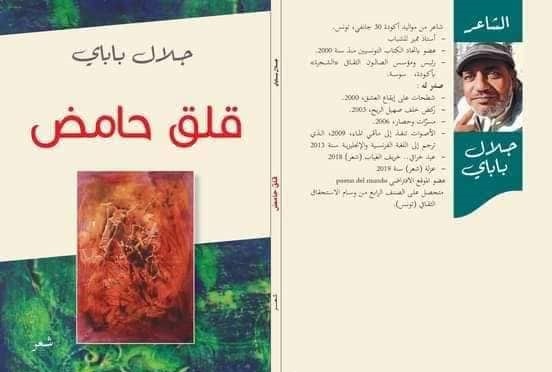شهادات ومذكرات
زينب محمود الخضري.. رائدة الفرنكوفونية في مصر
 من معين نهر النيل العذب نغرف وجهاً عربياً مضيئاً في سماء عالمنا العربي المعاصر، الذي خبت نجومه، وقلت شموسه، وتقلصت رموزه، ولكن الخير كل الخير في البقية الباقية من الرواد العظام الذين لا ينساهم التاريخ أبداً، ومن هؤلاء الرواد نحاول في هذا المقال أن نتطلع إلي نموذج نسائي نهتدي عبر طريقه، وشخصية استطاعت أن تحفر في صخور صماء منعت المرأة خلال فتراتها من حقها في تعلم اللغة الفرنسية واللاتينية، لتتجاوز هذا المنع وتصل بعلمها وتراثها الفكري مبلغ الرجال، تلك هي الدكتورة "زينب محمود الخضيري" (ابنة أستاذنا الكبير محمود الخضيري، وهو من هو في مجال الدراسات الفلسفية عامة، وابن سينا وديكارت علي وجه الخصوص)؛ فهى تلك الزهرة التي نمت فى صخرة، وتلك الفتاة التي استجمعت كل ميراث بيت العلم والثقافة فاتخذته منهاجاً، ثم باحثة فى الفلسفة الإسلامية وفلسفة العصور الوسطي، وكاتبة لا يشق لها غبار في كثير من الصحف، وعاشقة شفافة العاطفة، استطاعت أن تخطو بثبات نحو القمة لتصبح رائدة بعد أستاذها ومعلمها الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور (رحمه الله) رائدة الفضل العربي علي الفلاسفة اللاتين، حيث استطاعت زينب الخضيري المضي قدما في دراسة الفلسفة الإسلامية في ثوبها اللاتيني؛ حيث درست اللغتين- الفرنسية واللاتينية، وقرأت بتمعن فلاسفة العصور الوسطي، لتكون واحدة من أهم وأبرز الأساتذة المصريين الذين تمكنوا من التجديف عبر بحورها ذات الأمواج الصعبة، ولم تقف بطموحها الفكري عند هذا الحد، بل وقفت في وجه الحركات المسمومة التي حاربت الفلسفة الإسلامية (من أمثال أفكار رينان) وتصدت لها بكل صلابة وقوة.
من معين نهر النيل العذب نغرف وجهاً عربياً مضيئاً في سماء عالمنا العربي المعاصر، الذي خبت نجومه، وقلت شموسه، وتقلصت رموزه، ولكن الخير كل الخير في البقية الباقية من الرواد العظام الذين لا ينساهم التاريخ أبداً، ومن هؤلاء الرواد نحاول في هذا المقال أن نتطلع إلي نموذج نسائي نهتدي عبر طريقه، وشخصية استطاعت أن تحفر في صخور صماء منعت المرأة خلال فتراتها من حقها في تعلم اللغة الفرنسية واللاتينية، لتتجاوز هذا المنع وتصل بعلمها وتراثها الفكري مبلغ الرجال، تلك هي الدكتورة "زينب محمود الخضيري" (ابنة أستاذنا الكبير محمود الخضيري، وهو من هو في مجال الدراسات الفلسفية عامة، وابن سينا وديكارت علي وجه الخصوص)؛ فهى تلك الزهرة التي نمت فى صخرة، وتلك الفتاة التي استجمعت كل ميراث بيت العلم والثقافة فاتخذته منهاجاً، ثم باحثة فى الفلسفة الإسلامية وفلسفة العصور الوسطي، وكاتبة لا يشق لها غبار في كثير من الصحف، وعاشقة شفافة العاطفة، استطاعت أن تخطو بثبات نحو القمة لتصبح رائدة بعد أستاذها ومعلمها الأستاذ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور (رحمه الله) رائدة الفضل العربي علي الفلاسفة اللاتين، حيث استطاعت زينب الخضيري المضي قدما في دراسة الفلسفة الإسلامية في ثوبها اللاتيني؛ حيث درست اللغتين- الفرنسية واللاتينية، وقرأت بتمعن فلاسفة العصور الوسطي، لتكون واحدة من أهم وأبرز الأساتذة المصريين الذين تمكنوا من التجديف عبر بحورها ذات الأمواج الصعبة، ولم تقف بطموحها الفكري عند هذا الحد، بل وقفت في وجه الحركات المسمومة التي حاربت الفلسفة الإسلامية (من أمثال أفكار رينان) وتصدت لها بكل صلابة وقوة.
تنتمي زينب محمود الخضري إلى رعيل المفكّرات العربيات اللواتي يُشهد لهنّ بالموهبة والكتابات النوعيّة في مجال الفلسفة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، لقد قدّمت إنتاجاً قيّما متفرّداً في الفكر بشكل عام وفي الفلسفة الإسلامية وفلسفة العصور الوسطي وفلسفة التاريخ بشكل خاص. وكان من تجليّات التلاحُم بين شخصيتها وثقافتها من جهة وما تؤمن به وما تكتبه من جهة أخرى، أن أظهرت إبداعاً لافتاً يكشفُ عن مقدرة متميّزة. كانت الفلسفة مُلْهمة لها ومعيناً لا يَنْضب للتأليف والإبداع الفكري والترجمة إلى اللغة العربيّة، لقد أتقنت الكتابة بلغة الضادّ كما تمكّنتْ من عدّة لغات أجنبيّة تحدّثا وكتابة، فكان حصيلة ذلك تراثاً إنسانيّاً يستحقّ الاهْتمام.
وقد ولدت بالمنيل في 23 سبتمبر عام 1943 بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية، وسافرت مع والداها الدكتور محمود الخضيري (الذي عينه الرئيس جمال عبد الناصر مستشاراً ثقافياً المصري ثم سفيرا لمصر بالفاتيكان) إلي إيطاليا لتدخل مدارس الليسية في مرحلة التعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، وعندما عادت أصرت أن تدخل كلية الآداب بقسم الفلسفة بجامعة القاهرة، وكانت الأولي علي دفعتها، حيث تم تعيينها معيدة بقسم الفلسفة، ثم مدرسا مساعدا، بعد أن حصلت علي درجة الماجستير في موضوع بعنوان " فلسفة التاريخ عند ابن خلدون "، ثم بعد ذلك عُينت مدرساً بعد أن حصلت أيضاً علي الدكتوراه في موضع بعنوان " أثر ابن رشد فى فلسفة العصور الوسطى"، وذلك تحت إشراف أستاذنا المرحوم الدكتور " يحيي هويدي"، ثم تدرجت في الترقيات حتي حصلت علي أستاذ مساعد وأستاذ في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم.
وللدكتورة زينب محمود الخضيري مؤلفات عديدة نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر : لاهوت التاريخ عند القديس أوغسطين، وفلسفة التاريخ عند ابن خلدون، وأثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى، وابن سينا وتلاميذه اللاتين، ودراسة فلسفية لبعض الفرق الشيعية، وأبو حيان التوحيدي والبحث عن السعادة، ...الخ، علاوة علي مقالاتها الرائعة التي أثرت بها حياتنا الثقافية، ومن تلك المقالات نذكر : الاستشراق في الفلسفة، دراسة - الحياة.. الموت / البعث عند توفيق الحكيم، والفلسفة الإسلامية في مؤتمر الفلسفة في هلسنكي، واعترافات القديس أوغسطين، والدين في فكر توينبي، وأبو حيان التوحيدي والبحث عن السعادة...الخ.. علاوة علي ترجماتها الرائعة والتي من أهمها وأشهرها كتاب فى قلب الشرق : قراءة معاصرة لأعمال لويس ماسينون.
والدكتور زينب الخضيري من أشد المؤمنين بالفرنكوفونية ؛ حيث تري أن هناك تبادل ثقافي قوي ما بين الشرق والغرب، والغرب والشرق، وبالتالي فإنها تؤمن أنه في مجال الفكر الإنساني عبر عصوره المتلاحقة ثمة ظاهرة ضمن ظواهر عديدة تسترعى النظر وتجذب الانتباه، ألا وهى ظاهرة التأثير والتأثر القوي بين الأجيال المتعاقبة، بحيث يؤثر الجيل السابق في الجيل اللاحق، ويتأثر هذا بذلك تأثرا تتعدد أبعاده أحيانا وتختلف مجالاته وتتفاوت درجاته بين طرفى الظاهرة، أعنى بين المؤثر والمتأثر، فتارة يكون التأثير من جانب السابق في اللاحق تأثيراً قوياً عميقاً، وعلى درجة من الشمول، تكاد تذهب باستقلالية المتأثر وهويته العلمية، ومن ثم تظهر العلاقة بين الطرفين في صورة علاقة تابع بمتبوع ومقلد بمبدع، وتارة يكون التأثير ضعيفًا في درجته محدودًا في مجاله؛ بحيث يظل كل من الطرفين المؤثر والمتأثر محتفظًا بفردانيته، واستقلال نظرته وفكره، ومن ثم تتوارى معدلات التأثير، فلا تكاد تظهر .
وإن كان الأمر كذلك، فإن لهذه الظاهرة في نظر زينب الخضيري دلالات تسمح لها بالقول (من خلال كتاباتها) بأنها ظاهرة إيجابية مفيدة ومثمرة بدرجة تجعلنا نعدها عاملًا فاعلًا في تحقيق ما أنجزه الفكر الإنسانى من تطور وازدهار على أصعدته كلها ؛ وخاصة على الصعيدين : الثقافى والحضارى للشعوب، والأمم التى سجل لها التاريخ ضربًا أو أكثر من ضروب التقدم والازدهار .
ولعل من أهم الدلالات التي تحملها هذه الظاهرة في طياتها تأكيد فعاليات العقل الإنسانى، وطاقاته المتجددة، ومبادراته الخلاقة، وهو ما يخول لزينب الخضيري الإيمان، بأن "العقل قد أوتى من القوة ما يمكنه من أن يأتى أفعالاً على درجة من التباين تكشف عن تعدد طاقاته وتنوعها . فهو في مجالنا هذا يتأثر ويؤثر، وينفعل عن عقول، ويفعل في غيرها، ويأخذ ويعطى ويستقبل ويرسل، ويستوعب الماضى ويتمثله بوعى واقتدار دون أن يفقد وعيه بالواقع إلى حيث هو جزء منه، ثم يتجاوز ذلك إلى حيث المستقبل ورؤاه المستقبلية التى تؤثر بدرجة أو بأخرى في ذلك المستقبل".
ولذلك نجد زينب الخضيري تؤكد في كتابها عن أثر ابن رشد في العصور الوسطي، هو ضرورة القراءة ليس فقط لتأثير ابن رشد على الفلاسفة الغربيين في العصور الوسطى، بل لفلسفته هو أيضا. وفلسفته تتحدد عند متلقيه بموقفه من أرسطو، وابن رشد عندها هو حامل لواء العقلانية في العصور الوسطى، الذي كان عليه أن يتحمل وحده كل الهجوم الذي يثيره دائما في كل عصور ذلك الاتجاه الذي يضع العقيدة في المرتبة الأولى، ويجعل دور العقل في خدمة تلك العقيدة والدفاع عنها . لقد كان من الممكن فيما ترى زينب الخضيري أن تتجاهل العصور الوسطى المسيحية ابن رشد، إلا أنها أقبلت على قراءته واستقبلته باعتباره أعظم شراح أرسطو ؛ أي أن قراءة ابن رشد للمعلم الأول كانت "تأشيرة" دخول ابن رشد إلى أوروبا، وقد أعطيت له هذه "التأشيرة" لأنه فعل لأرسطو ما لم يفعله المؤلفون المسلمون إلا للقرآن (وذلك حسب قول د. أحمد عبد الحليم : زينب الخضيري واركيولوجيا القراءة ضمن أوراق فلسفية).
وتحدد لنا زينب الخضيري مصادر قراءتها أو الدراسات الممهدة لهذه القراءة أو قل بدقة القراءات الأولى، التي تواصلها وتخالفها تارة وتعدلها تارة وتتجاوزها تارة أخرى؛ حيث تذكر لنا زينب الخضيري قراءة أرنست رينان في كتابه "ابن رشد والرشدية" ومونك في كتابه "أمشاج من الفلسفة اليهودية والعربية"؛ ثم تقدم لنا الخضيري مبررات قراءتها وفي مقدمتها وأهمها هو أن استقبال وتلقي أوربا لفلسفة ابن رشد وبلوغها الذروة في القرن الثالث عشر في باريس أهم مرحلة في تاريخ الرشدية اللاتينية، "فهو يمثل العصر الذي حدثت فيه ما يشبه الصدمة للفكر المسيحي، تلك الهزة التي ساهمت إلى حد كبير في خلق الفكر المسيحي الفلسفي المنفصل عن الفكر اللاهوتي.
وبناءً على ذلك تحدد لنا زينب الخضيري كما يقول د. أحمد عبد الحليم مبررات اختيار الفلاسفة الذين شملتهم بقراءتها والقضايا الفلسفية موضوع هذه القراءة وهي: التوفيق بين الفلسفة والدين، ومشكلة العالم، ومشكلة النفس العاقلة عند كل من : البيرت الكبير، وتوما الأكويني، وسيجر دي برابانت، وموسى بن ميمون، وإسحق البلاغ. ومبررات اختيارها لألبرت الكبير كما يقول د. أحمد عبد الحليم هو أنه أول من أراد استيعاب أرسطو في علم اللاهوت المسيحي ومن هنا تأثر بالشارح الأعظم لتحقيق هذا الغرض . ولا تنفصل فلسفة الأكويني عن فلسفة البيرت الكبير فهي مكملة لها، وأثر ابن رشد في فكر الأكويني، ما يزال موضع خلاف بين الباحثين، ومن البداية تؤكد أن القديس توما لم يكن فيلسوفا، بل عالم لاهوت مخلص لديه، رأى كنوز الأرسطية يقدمها له ابن رشد فأخذ منها ما يخدم دينه ويفسره تفسيرا عقليا وهاجم ما يتعارض مع عقيدته، وهي ترى أنه على الرغم من اختلاف فكر فيلسوف قرطبة ومتفلسف المسيحية الأعظم تسللت حلول الرشدية للمشاكل المختلفة في فكر الأكويني.
وتحدد لنا قراءتها للاكويني بأن فلسفته بفضل تأثير ابن رشد كما يؤكد ماكسيم جورس في كتابه "ذروة الفكر في العصور الوسطى" تجاوزت النمط الفكري السائد وقت ذلك المتمثل في أعمال بونافنتور أو البيرت الكبير وموسى ابن ميمون فحقق بذلك اتجاهًا تجريبياً مادياً أرسطيا – رشديا.
وتظهر القراءة المركبة الجدلية في بيانها استقبال وتلقى سيجر دي برابانت "الذي يعتبره الجميع الفيلسوف الرشدي الصميم" متابعة التطور الذي طرأ على فلسفة سيجر نتيجة لتصاعد الضغط الديني الكبير في عصره وقد هدفت من دراسته تفسير ما إذا كان التغير الفكري الذي طرأ على فلسفته تغيراً حقيقياً أم تغيراً ظاهرياً دفعت إليه ظروف الحياة الفكرية التي سيطرت عليها الكنيسة.
ويتحدد إذن موقف فلاسفة اللاتين في العصر الوسيط من ابن رشد عبر محاولته تجاوز ما بين حقائق الدين وحقائق الفلسفة من تعارض واختلاف. لقد كانت مهمة المشائين على اختلاف أديانهم التوفيق بين أرسطو والعقيدة، وكان توفيق ابن رشد بينهما في قراءة زينب الخضيري يصلح للمسلمين كما يصلح للمسيحيين ولليهود، لذا فإن محاربة رجال الكنيسة في القرنين 13، 14 هذا التوفيق وتحريم كتب ابن رشد وقتل من يتمسك بقضاياه لم يكن سوى تعصباً من جانبهم فالدين لا يتعارض في القراءة التي تقدمها مع التوفيق الفلسفي الذي يحترم حقائق الأديان الأساسية .
نجد لدى زينب الخضيري معياراً رشدياً عقلانياً نقدياً كما يقول د. أحمد عبد الحليم تقدم على أساسه القراءات المختلفة الذي تتناولها وبناء على ذلك فإن قراءة اسحق البلاغ أقرب إلى نصوص ابن رشد من قراءة ابن ميمون الكلامية وقراءة سيجر دي برابانت الرشدي مختلفة عن قراءة توما الأكويني الأقرب إلى ابن سينا مني إلى ابن رشد.
وحتى تكتمل قراءة الخضيري للقراءات اللاتينية لفلاسفة المسيحية للفلسفة الإسلامية في العصور الوسطى تقدم قراءتها لفلسفة ابن سينا وتلاميذه اللاتين؛ حيث تشير زينب الخضيري ابتداء من الصفحة الأولي لكتابها إلي مشكلة هامة، كانت وما زالت موضع اهتمام كثير من الباحثين في الفلسفة السينوية، وهي مشكلة حقيقة الفلسفة الشرقية عند ابن سينا، بل إن زينب الخضيري قد بحثت في هذه المشكلة بحثا مستفيضا في أكثر فصول كتابها، وذلك لكي تبين أن بعض المفكرين الغربيين بعد ابن سينا لم يكن تأثرهم بابن سينا المتابع للفلسفة الأرسطية المشائية، بل كان منهم، كروجرز بيكون مثلا، من تأثر بالفلسفة الخاصة لابن سينا والتي لم يكن منها مجرد متابع لأرسطو، بل كانت له شخصيته الخاصة، ونقصد بتلك الفلسفة الخاصة، والفلسفة التي يطلق عليها ابن سينا، الفلسفة المشرقية .
بالإضافة إلي أن زينب الخضيري تريد من وراء ذلك، تصحيح بعض الأخطاء التي شاعت عند بعض المستشرقين ومن بينهم رينان والتي تتمثل في القول بأن الفلسفة العربية ما هي إلا الفلسفة اليونانية مكتوبة بحروف عربية تقول زينب الخضيري : دراستي هذه إثبات لخطأ رينان الذي شاع بين الباحثين بحيث بات كالمقولة العقلية وأعني بهذا الرأي كون الفلسفة الإسلامية ما هي إلا موسوعة الفلسفة اليونانية وقد كتبت بحروف عربية ؛ فها هو ابن سينا يعرض في فلسفته المشرقية عن الفلسفة اليونانية جملة، مُقلا من شأنها وإذا كان ثمة حرص علي إبراز مشائية ابن سينا، فلا بد أن يكون ثمة حرص مقابل من جانبنا نحن الباحثين العرب علي إبراز " مشرقية " ابن سينا، وأن نعني بتحقيق ونشر طبيعيات وإلهيات الفلسفة المشرقية ومخطوطاتها الموجودة في خزانة مكتبات تركيا تنتظر من يخرجها إلي النور".
ومهما يكن من الأمر فإن تقديم الحكمة المشرقية لا يمكن تقديم رأي قاطع حوله، وذلك كما أشارت زينب الخضيري، طالما أن هناك احتمالات بوجود أقسام للحكمة الطبيعية والإلهية من كتاب الحكمة المشرقية، لم تحقق بعد ولم يخرج إلي النور .
وإذا كانت زينب الخضيري قد حللت تحليلاً فلسفياً رائعاً أثر بعض فلاسفة العرب؛ وخاصة ابن سينا وابن رشد في بلورة العديد من الأفكار التي قال بها جيوم روخرني وتوما الأكويني وروجرز بيكون، فإنه كان من الأفضل الوقوف بطريقة أكثر تفصيلاً حول قضية التأثر والتأثير .
وأقول مع أستاذي الدكتور عاطف العراقي نظراً لأنه ليس من الضروري إذ وجدنا مجموعة من الأفكار قال بها أحد الفلاسفة، إرجاع هذه الأفكار إلي تأثره أو ثقله أفكاراً عن فلاسفة سبقوه، وقد نجد فكرة واحدة عند اثنين من الفلاسفة، ومع ذلك توصل كل فيلسوف منهما إليها بمفرده ودون التأثر بفكرة الفيلسوف السابق عليه . وكما أسرفنا في عقد مقارنات بين الغزالي وديفيد هيوم، بين الغزالي وديكارت، بين الغزالي وكانت، بين ابن سينا وديكارت. بين الغزالي وهيوم في مجال السببية، والغزالي وديكارت في مجال الشك، والغزالي وكانت في مجال النقد، وابن سينا وديكارت في مجال النفس، أو الكوجيتو الديكارتي : أنا أفكر فأنا موجود (أنظر: عاطف العراقي : ابن سينا وتلاميذه اللاتين ضمن عالم الكتاب).
هذا الإسراف في عقد المقارنات والتي لا نجد لأكثرها أي مبرر من المبررات، لا نجده في كتاب " ابن سينا وتلاميذه اللاتين للدكتورة زينب الخضيري، لقد ناقشت موضوع المقارنات بطريقة منطقية هادئة ورجعت في سبيل ذلك إلي حشد من الكتب العربية ومن الكتب غير العربية، وذلك إن دلنا علي شئ فإنما يدلنا علي حس فلسفي واضح عند زينب الخضيري. إنها قد تجنبت المبالغات والأسلوب الخطابي الإنشائي في دراستها لإمكانية أو احتمالية تأثر هذا الفيلسوف أو ذاك من فلاسفة الغرب في العصور الوسطي أو في عصر النهضة، بفيلسوف أو أكثر من فلاسفة العرب من أمثال ابن أو ابن رشد وليرجع القارئ العزيز لصفحات الكتاب وسيتبين له مدي دقة المؤلفة في حديثها عن موضوع التأثر والتأثير . إنها تضع الفروض والاحتمالات ولا تلجأ كما قلنا إلي لغة القطع، لغة الخطابة والبلاغة . إنها تلجأ إلي الحوار الهادئ مع نفسها تارة ومع القارئ تارة أخري . وكم نحن في أمس الحاجة إلي هذا الحوار وهذه المناقشة الموضوعية الهادئة وذلك بعد أن غلبت علي أكثر بحوثنا الفلسفية الحالية لغة الصوت العالي، لغة الصراخ، لغة الخطابة المنبرية، لغة الطبل، وإن كان طبلاً أجوف، ولكن أكثر لا يعلمون (وذلك حسب قول الدكتور عاطف العراقي في المقال السالف الذكر).
علي كل حال لسنا نستطيع في مقال كهذا، أن نزعم بأننا قادرون علي تقديم رؤية ضافية شاملة ومستوعبة لكل مقدمات شخصية الدكتور زينب الخضيري بأبعادها الثرية، وحسبنا هذه الإطلالة السريعة الموجزة علي الجانبين الإنساني والعلمي لمفكرة مبدعة في الفلسفة، ونموذج متفرد لأستاذه جامعية نذرت حياتها بطولها وعرضها لخدمة الفلسفة والثقافة العربية، وأثرت حياتنا الفكرية بكل ما قدمته من جهود.
تحيةً مني للدكتورة زينب الخضيري التي لم تستهوها السلطة، ولم يجذبها النفوذ ولكنها آثرت أن تكون صدى أميناً لضمير وطني يقظ وشعور إنساني رفيع، وسوف تبقى نموذجاً لمن يريد أن يدخل التاريخ من بوابة واسعة متفرداً . بارك الله لنا في زينب الخضيري قيمة جميلة وسامية في زمن سيطر عليه "أشباه المفكرين" (كما قال أستاذي عاطف العراقي)، وأمد الله لنا في عمرها قلماً يكتب عن أوجاعنا، وأوجاع وطنناً، بهدف الكشف عن مسالب الواقع، والبحث عن غداً أفضل، وأبقاها الله لنا إنسانة نلقي عليها ما لا تحمله قلوبنا وصدورنا، ونستفهم منها عن ما عجزت عقولنا عن فهمه.
د. محمود محمد علي