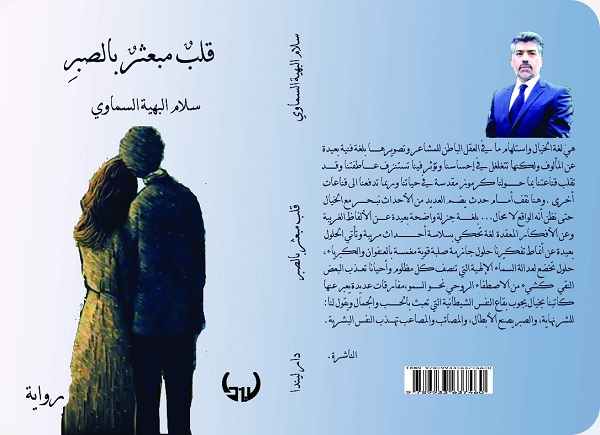شهادات ومذكرات
الشيخ حمزة فتح الله وحقوق المرأة في الإسلام
 مَصَابيحٌ في دائرة الظِّل
مَصَابيحٌ في دائرة الظِّل
يصنف المعنيون بدراسة الفكر العربى الحديث، أعلامه واتجاهاتهم إلى محافظين ومجددين ومتطرفين مبددين، وذلك تبعًا للنسق العام لخطاباتهم ووجهة مشروعاتهم وانطلاقاتهم وموقفهم من قضايا: التراث والتجديد والحرية والوعى والإصلاح.
غير أن هذا الدرب من التصنيف لا يصدق إلا على أصحاب المدارس الفكرية الكبرى، أعنى الاتجاهات النهضوية والمنابر التنويرية التى ظهرت فى مصر والشام وتونس منذ العقد الثالث من القرن التاسع عشر، أما المفكرون غير النسقيين فكانت موقفهم تتباين - إلى حد التناقض- وفقًا للقضايا المطروحة باعتبارها المحرك الأول للأفكار والآراء، فنجد من بين هؤلاء المفكرين من ينتمى إلى الاتجاه المحافظ فى تناوله قضايا الأدب واللغة، ونألفه ثائرًا متحمسًا لقضايا الحرية على النموذج الأوروبي، ونرى منهم من ينضوي تحت راية الليبراليين فى ميدان العقيدة والسياسة، وسرعان ما ينقلب على وجهته انتصارًا للعادات والتقاليد خلال مناقشته قضايا المرأة وحجابها، ويعنى ذلك أنه ليس من الغريب أن نجد من التقليديين المتشيعين للموروث والمنافحين عنه من يدافع عن قضايا العلم الحديث وضرورة الأخذ به للقضاء على الخرافة والبدع وتخليص العادات والتقاليد من الآفات التى أفسدها الجهل، بل انتحال بعض النظم والمناهج الغربية فى شتى الميادين -ما دامت لا تتعارض مع الثوابت الشرعية ومقاصدها- وينادى بتحرير المرأة ويدافع عن حقوقها التى سُلبت منها وحرمتها من إنسانيتها باسم الدين تارة والمجتمع الذكوري تارة ثانية وجهل المتعالمين تارة ثالثة، وأحسب مفكرنا الذى سوف نتحدث عنه على هذه الشاكلة، ومن هذا الصنف من المثقفين.
هو الأديب واللغوي والمتكلم والناقد والمحقق حمزة فتح الله حسين المصرى بن محمد التونسي «١٨٤٩ – ١٩١٨» ولد بالإسكندرية، وتلقى تعليمه الأولى فى مدارسها، ثم التحق بجامع «إبراهيم باشا» ومنه إلى الأزهر. وقد وجد مفكرنا -فور تخرجه فى الأزهر- ضالته فى الصحافة الأدبية.
وفى عام ١٨٨٢ عين مفتشًا للغة العربية فى وزارة المعارف، وفى عام ١٨٨٦ سافر إلى فيينا لحضور مؤتمر المستشرقين عن الحضارة العربية، وفى عام ١٨٨٩ سافر مبعوثًا من قبل الباب العالى لحضور مؤتمر المستشرقين عن الحضارة العربية أيضًا فى أستكهولم عاصمة السويد، وقد ألقى الشيخ حمزة فتح الله بحثًا بعنوان «باكورة الكلام على حقوق النساء فى الإسلام»، تناول فيه موقف الإسلام من العلم والعقل والمجتمع الإنساني، ثم انتقل إلى حقوق المرأة، وأوضح سبق الإسلام لتكريمها، والحث على تعليمها وعدم ممانعته لاندماجها فى المجتمع، فتعمل بجانب الرجال غير منفصلة عن الحياة وشئونها، بل كان لها الحق فى المشاركة فى أمور الحكم والمعارضة السياسية، والاشتراك فى الأمور الحياتية.
وفى عام ١٩١٠ عُين مفتشًا أول للغة العربية فى وزارة المعارف، وفى هذه الآونة كف بصره، غير أنه استمر فى القراءة والكتابة فى الصحف وداوم الحضور فى حلقات العلم والمنتديات الثقافية والأدبية.
وفى عام ١٩١٢ أحيل إلى المعاش مودعًا الوظيفة الحكومية فى ميدان التربية والتعليم، غير أن قلمه ولسانه لم يتوقفا عن إثراء الحياة الثقافية فى ميدان الأدب والعقيدة واللغة. وتشهد بذلك آثاره المنشورة والمخطوطة، ومن المؤسف أن هذا الرجل لم يأخذ حقه بين رصفاء اللغويين والأدباء، ولم يذكر اسمه من بين الداعين لحرية المرأة.
وأعتقد أن ذروة إبداعاته تتمثل فى ذلك الكتاب الذى يستحق به موقع الريادة ألا وهو كتاب «باكورة الكلام على حقوق النساء فى الإسلام» الذى لم يسبقه فى موضوعه سوى بعض المقالات كتبها أحمد فارس الشدياق وبطرس البستاني، ثم كتاب «المرشد الأمين» لرفاعة رافع الطهطاوي عام ١٨٧٢. وقد سبق كتاب الشيخ حمزة فتح الله كتاب قاسم أمين «تحرير المرأة» ١٨٩٩ أى بعشر سنوات.
وسوف نوجز فى السطور التالية أهم آراءه، التى تعد بدون أدنى شك سابقة لثقافة عصره، ومن هنا يأتي موطن المفارقة فى شخصية حمزة فتح الله ومواقفه من القضايا المطروحة فنجده يجمع بين ذروة التقليد فى اللغة والبلاغة والأدب وقمة التجديد فى قضايا الحرية والاجتماع.
وإذا ما انتقلنا إلى قضايا المرأة -كما تناولها مفكرنا- فسوف ندرك إلى أى حد كان هذا العالم مجددًا، فقد طرق العديد من الأبواب لم يسبقه أحد إليها، فبين أن الشريعة الإسلامية قد وضعت الأسس القويمة للعلاقة بين الرجل والمرأة بداية من مشروعية الحب بينهما وانتهاء بأسباب الطلاق ومضاره ومآلاته، وجاءت كتاباته -فى هذا المضمار- أقرب إلى النصائح والتحاذير والواجبات والمنفرات، والحلال الطيب والحرام المنهى عنه بوصفه شرًا فى ذاته أو فى عواقبه ومآلاته، وجميع ذلك مستمد من القرآن وسنة النبي.
فذهب إلى أن الحب والألفة والتراحم والقبول وطيب العشرة من أهم مقومات العلاقة بين الجنسين، وبين أن الحب ليس مرادفًا للشهوة الجسدية، ولا مبررًا للمطامع المادية، ولا مدفوعًا بمؤثرات خارجية، بل هو تآلف وقبول من قبل الاثنين، فإذا لم يحدث هذا القبول فلا ينبغي على ولى الأمر أن يدفع ببناته أو أخواته أو بمن يقعن تحت ولايته إلى زيجة طمعًا فى نسب أو مال أو عصبية. ونهى عن الزواج من الأقارب حتى لا تورث الجينات الضارة، واستشهد بحديث رسول الله الذى رغب فيه عن الزواج من غير العصب، كما بين مفكرنا أن الغاية من الزواج هو بناء أسرة سوية تبدأ بالتفاهم والانسجام بين القرينين، وتنتهى بحسن تربية الأبناء وتنشئتهم نشأة صالحة، وعليه نفر من زواج المصلحة وزواج الشهوة، ونصح الرجال والنساء أن يختاروا من يمتلك الباءة فى عقله وجسده وماله. ومن يراعى الله ويخافه فى دنياه ودينه، ودعا إلى عدم المغالاة فى المهور أو التسرع فى تخير الأزواج إلا بعد استقصاء وتقصٍ، كما حذر من الكذب من قبل المتحابين أثناء الخطبة أو إخفاء ما يكرهه أو يسئ إلى أحدهما بغية التجمل وستر العوائد المنفرة، الأمر الذى لا يحمد عواقبه عند كشف المخبي وفضح المحجوب، كما حث الرجال على أن يتطيبوا ويعتنوا بنظافة أجسادهم شأن النساء، وأن يكون كل منهما حريصًا على أن يبدو فى أكمل هيئة وأجمل صورة قبل الزواج وبعده وقبيل الجماع، مبينًا أنه لا يليق أن تتجمل المرأة وتتهيأ لرجل لم يراعِ شعورها وأحاسيسها ومزاجها ورغباتها، لا سيما قبل العلاقة الحميمة.
كما حث الرجال إذا ما غابوا عن زوجاتهم ألا يعاودهن فجأة أو يطلبهن للفراش عنوة، بل يجب عليهم إبلاغهن بموعد اللقاء حتى تتمكن المرأة من تهيئة نفسها نفسيًا وجسديًا، كما حذر من أنانية الرجل فى الفراش فيأتي زوجته حتى ينال مأربه ثم يتركها دون ذلك كوطأ البهائم.
كما على الزوج الغلظة فى الحوار والشدة فى التوجيه، والشح فى المال، والتهديد والوعيد طلبًا فى الطاعة، ونهاهم أيضًا عن تعدد الزوجات دون حاجة، شريطة الباءة والعدل، ونفر من الرجل المطلاق الغضوب العجول، ومن المرأة التى لا تسأل زوجها عن مصدر ماله إن كان حلالًا أو حرامًا، وأن تكون حريصة على ألا تثقل على كاهله من النفقات ما لا يطيق، كما حذر الرجال من هجر زوجاتهم أو الإساءة إليهن باللسان أو اليد، والتلاعب بشرع الله، فالهجر أو الضرب لا يرمى إلى الإيذاء بل إلى التعبير عن الغضب والكراهة، وأن يتجنب ما يضايقهن، وأن يرفق بهن فيما يطلب منهن من أعمال، وأن يساعدهن فى الأعمال المنزلية، وألا يجامعهن إلا فى مكان مناسب بمنأى عن عيون الأغراب والأبناء، وأن يراعى فى ذلك آداب الجماع وخلق الفراش، كما وردت فى الخبر والسنة النبوية.
كما نبه النساء بخطورة إفساد سر الأسرة والمخادع وإهدار مال الرجل وحسد الجيران، والخروج دون استئذان، والغيرة المفرطة، وكثرة اللوم والمعايرة وتكرار العبارات المثبطة، واختتم نصائحه فى هذا السياق بهذه الكلمات: «انهِ عن المظالم وأكل أموال الناس بالباطل، والاكتساب من غير حلِ، وذلك ابعث على العمران وإنماء النفس بالمال، فإذا الأمة آمنت فى سربها (أى مجتمعها) وضحت فى جسمها، وأيقنت أنها لا تظلم ولا تُظلم، ووطنت نفسها على هذا الأمر فحسن النظام وازداد العمران».
حول المصابيح العشرة:
لم يكن مقصدي من محاولة إخراج أكابر التنويريين - الذين كان لهم الأثر الأكبر فى تقويم وإصلاح ما فسد فى حياتهم الثقافية - من دائرة الظل إلى دائرة البحث والدرس المعاصرة فى ثقافة قد خلت من أضرابهم ومن صاروا على شاكلتهم، إلا لكى يقتدى بهم شبيبتنا الذين كفروا بالقدوة وارتابوا فى أصحاب الأقلام وتشككوا فى معارفهم وتهكموا على حججهم ومنطقهم وحكمتهم المستمدة من مشخصاتهم العقدية وانتماءاتهم الوطنية.
نعم أردنا من خلال أحاديثنا عن تلك المصابيح إحياء قيمة الصدق والأمانة العلمية فى جُل ما صنفوه، وقيمة الحب والإخلاص والوفاء للرسائل التى حملتها خطاباتهم ومشروعاتهم التى تنزهت عن الأغراض الشخصية والاتجار بالشعارات الثورية، والأكاذيب التى زيفت وعى الرأى العام وصرفته عن إيجاد الإجابة المناسبة للسؤال المطروح دومًا أمام الأمم والمجتمعات التى تسعى للنهوض ثانية بعد الكبوات والأزمات والانكسارات الكبرى التى ألقت بها فى ركام التخلف حيث الجهل والفساد والتطرف والتعصب والإباحية والعنف، أعنى السؤال الذى لا غنى عنه لنضعه أمام أعيننا قبل أن نشرع فى التخطيط ونبدأ فى التنفيذ ونتخير القيادات ونشرع القوانين (من نحن؟ وماذا نريد؟ ولماذا؟) فالمقطع الأول يرمى إلى تحديد الهوية التى كادت أن تطمس فى ظل عشرات الشعارات الجوفاء، وإذا قال بعضنا إن هذا المقطع لا يضعه إلا البلهاء، لأن الهوية نكتسبها بالمواطنة فنتساءل ثانية ما المواطنة؟ هل هى الارض؟ أم ثقافة المجتمع بما فى ذلك اللغة والعقيدة، أو المصالح المشتركة؟ وهل كل ولاءاتنا وانتماءاتنا وسلوكنا وأقوالنا تعبر عن ذلك؟ وهل نحن مصريون حقًا؟ فلماذا الجحود إذن؟ ولماذا نتصارع انتصارًا لولاءات دونها ونتآمر عليها لانتماءات غيرها؟ وهل نحن فى حاجة لإعادة تنشئة أطفالنا على حبها؟ وأين أولئك القادة الذين يفلحون الأرض لإنبات أزاهير الحب فى قلوب أطفالنا فى مناهجهم الدراسية وإعلامهم وأغانيهم؟
أجل نحن فى أزمة -تهيمن على العقل الجمعى-، لأن الولاء لا يكبر إلا بالعطاء، ولا يترسخ إلا بالعدل، ولا يقوى إلا بالحرية، ولما كانت الأم عاجزة عن أن تفي بواجبات الأمومة، فمن العسير أيضًا مطالبة الأبناء بالتقاني فى عشقها وهم على هذا النحو من الشعور بالجوع والجور واليأس من طلوع فجرٍ لغدٍ أفضل.
ويأتي المقطع الثانى من السؤال (ماذا نريد؟) فهل حقًا لنا إرادة؟ أم نسبح كغيرنا من الأقزام فى أفلاك الكبار الذين يضعون الخطط وينظمون العالم ويقسمون الدول؟ وهل فى مقدورنا الاعتماد على أنفسنا لتحقيق ما نريد؟ وهل نعى معنى وحدة الإرادة؟ وهل اجتماعنا عليها وعيًا، قهرًا، قدرًا؟ وهل لدينا الحنكة لترتيب أولويات ما نريد تبعًا لاحتياجات الواقع؟ وهل سواعدنا تقوى وحدها لتحقيق اختياراتنا ومطامحنا؟ وهل لدينا من العزائم ما يؤهلنا لتحدى الصعوبات فى الداخل والخارج بداية من المتشككين ونهاية بالمتآمرين؟
تصرخ الواقعات مؤكدة أننا فى طور الهرج والمرج، وأن منابر «مسيلمة» أعلى صوتًا، وسيوف الخوارج أقوى أثرًا، وأقلام المتلاعبين بالعقول أعلى كعبًا، والحفنة المتبقية من المستنيرين قد أصيب نفر منهم بالخرص، والتزم الآخرون بالسكوت، وانزوى المتبقي منهم خارج المشهد خوفًا من السقوط.
أما المقطع الثالث فموقعه فى القمة التى لا يصل إليها إلا الأشداء والعقلاء، الذين يمتلكون القدرة على التبرير والإتيان بالحجج والعلل التى تدعم غاية مشروعاتهم وتبرر اختياراتهم. ومن المؤسف أننا نفكر بمنطقً معكوس، فنسارع فى إيجاد الآليات، وتطبيق القرارات، وترديد الشعارات، وإنشاء المؤسسات، دون أن نكلف أنفسنا التفكير فى العلة أو الغاية التى تدفعنا لتنفيذ ما نُؤمر به.
والأمثلة لا يمكن إغفالها من كثرتها، فعندما نتساءل عن التعليم. نبدأ بكيف نتعلم؟ والصواب. أن نتساءل لماذا نتعلم؟ فهل حاجتنا للتعليم لمحو الجهل؟ أو لسد حاجة المجتمع؟ لأصحاب الدربة والدراية لحل مشكلات واقعية، وهل ما نقدمه من برامج فى المدارس والمعاهد والجامعات وكذا استيراد البرامج والتوسع فى بناء الجامعات الأجنبية والأهلية مطموسة المعالم والمآلات يؤهلنا لبلوغ تلك الغاية المفقودة؟
الحق أن ما قدمناه من نماذج أو مصابيح ما زالت خير مثال للإجابة النموذجية عن تلك التساؤلات. ويرجع ذلك إلى أن أولئك المستنيرين كانوا يخططون ويعملون تبعًا لغايات آمنوا بها، وتيقنوا أنها العلاج الأنسب لواقعهم المعيش، فنشروا ثقافة التسامح فى الرأى العام التابع، فحالوا بين انتشار التعصب والفتن الطائفية، وصالحوا بين المعقول والمنقول، وفتحوا أبواب الاجتهاد حتى لا يكون الدين «أفيون» للشعوب أو حجر عثرة أمام التقدم أو سيف ظالم على رقاب أحرار الفكر والاعتقاد.
وجعلوا الحوار والتثاقف أداة لاختيار الأصلح والأقوى من الخطابات والمشروعات، وآليات عاقلة لدرء الخلاف حول القضايا المطروحة، وأنشأوا الأحزاب السياسية القوية، وجعلوا على رؤوسها أكابر المستنيرين، وأشد المخلصين للوطن، وذلك للعمل من أجل صالح الجمهور من جهة، والحد من استبداد الحاكم إن جار من جهة ثانية، ونشر السلام والمحبة بين طبقات المجتمع من جهة ثالثة.
أجل أردت إحياء خطابات نسيناها أو تجاهلناها لأنها تفضح: ما نحن فيه من عبثية فى التفكير، وتهافت الرؤى، ورجعية الآراء. فقد برهنت كتابات أولئك المستنيرين على أن معظم القضايا التى نتشدق بطرحها ونتصارع حول الفصل فيها قد وضعها قادة الفكر منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا على مائدة النقد والتحليل، وقدموا حلولا لها أقرب إلى الموضوعية والواقعية منها إلى الشطط والخيال. فمن المؤسف أن نجد من بين مثقفينا من يتحدث عن مدى أحقية أهل الكتاب فى بناء الكنائس والمعابد فى دار الإسلام، ومن يتحاور حول جواز وطء الدواب ونكاح الوداع وإرضاع الكبير، ومن يناقش قضية كفر أهل الكتاب وحرمانهم من دخول الجنة، ومن عارض كل الكتابات التى تؤكد أن السياسة الشرعية الإسلامية لا تختلف عن السياسة المدنية إلا إذا هدمت الأخيرة «ثابت عقدي» أو نقدت مقصدًا شرعيًا من مقاصدها.
ولم يبق لي إلا البحث عن مصابيح على شاكلة ما أوردنا فى حياتنا المعاصرة لنخرجهم من دوائر الظل ونقتفى أثرهم بمنطق الإيقاظ وعقلية النقاد وتسامح المختلفين فى الوسائل والمتفقين فى الغايات.
بقلم: د. عصمت نصار