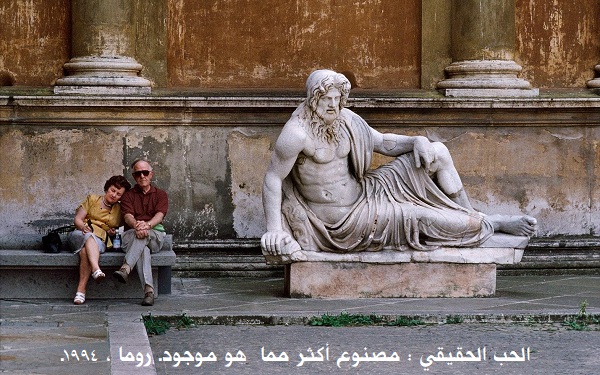صحيفة المثقف
الحملة على الإلحاد والدفاع عن حرية الاعتقاد
 لقد شغلت قضية الإيمان والإلحاد، أو إن شئت قلت التدين والعلمانية حيزًا كبيرًا على مآدب المثقفين في مختلف العصور وفي شتى الثقافات. وما أكثر المناظرات والمساجلات التي دارت بين رجالات الدين والمنكرين للربوبية والجاحدين للدين السائد والمرتابين في المقدسات والكافرين للألوهية وغيرهم من الزنادقة والمجدفين واللا أدريين والجانحين وأهل الشطط والغلو والشرك.
لقد شغلت قضية الإيمان والإلحاد، أو إن شئت قلت التدين والعلمانية حيزًا كبيرًا على مآدب المثقفين في مختلف العصور وفي شتى الثقافات. وما أكثر المناظرات والمساجلات التي دارت بين رجالات الدين والمنكرين للربوبية والجاحدين للدين السائد والمرتابين في المقدسات والكافرين للألوهية وغيرهم من الزنادقة والمجدفين واللا أدريين والجانحين وأهل الشطط والغلو والشرك.
وقد تباينت لغة حوار المتناظرين والمتثاقفين تبعاً للقدر المتاح من حرية الفكر والتسامح العقدي من جهة، والتعصب والعنف من جهة ثانية، والسلطات السائدة المهيمنة على العقل الجمعي من جهة ثالثة. ويعني ذلك أن التساجل حول الإيمان والإلحاد يرد في العصور وقد وصل إلى حرية البوح والتمرد على المألوف من الأفكار والمعتقدات.
غير أن الواقع يشهد بأن الحوار والتساجل حول هذه القضية لم يتحول إلى تصارع وتصاول وعراك وتدافع إلا مع ظهور ما نطلق عليه سلطة الاستبداد التي اتخذت من العنف والقهر سبيلاً لفرض الرأي عوضاً عن الحجة والبرهان أو النصح والإرشاد.
ويعد إخفاق معظم الأنبياء والمرسلين والمصلحين في إقناع مخالفيهم عن طريق الحوار والنقاش الهادئ، خير دليل على ما تقدّم.
وأعتقد أن مطالبة أفلاطون - في الكتاب العاشر من محاورة القوانين - الرأي العام القائد بقمع الملحدين ونفيهم دفاعًا عن الدين السائد وحماية لأمن وسلام المدينة يرجع إلى قناعته بأن سلطة الدين السائد -بغض النظر عن سلامته وصلاحه- لا يمكن للعقل مجابهتها بالعلم أو بالفلسفة، وتأكيده أيضاً بأن ديكتاتورية معتقد الكثرة لم تفلح دوماً حكمة النبهاء والأدباء في تغييره دفعة واحدة، وتسليمه بأن الجدل حول الإيمان والإلحاد مغامرة غير مأمونة العواقب لأن العنف يحيط بالمتناظرين من كل جانب في ظل سجن الحرية بأمر الأقوى القابض على سيف الاعتقاد، (فقد اعتبر أفلاطون الإلحاد جريمة ومن ثم ينبغي على القانون معاقبة مرتكبها اقتناعها منه بأن العقيدة الدينية شديدة الصلة بالسلوك الفاضل ومن ثم فأي مساس بها أو إضعافها أو التشكيك في مصداقيتها يصبح خروجاً عن القانون الأخلاقي.
وعليه؛ يجب على المشرعين سن قانون رادع لمعاقبة المارقين الذين يكفرون بوجود الإله وقدرته على معاقبة الأشقياء ومجازاة الفضلاء الأتقياء، فالعدالة والأمن والاستقرار والانتماء سوف تمسي ألفاظًا غير فاعلة وقيمًا بائدة في غياب التدّين، وأن الظلم والشقاق والاغتراب والتطرف والعنف وغير ذلك من الرذائل لا تتفشى في مجتمع إلا بتحريض من الإلحاد والمروق، فالقانون الحقيقي والدستور الأمثل هو الناطق بصوت الإله).
وعلى الرغم من ذيوع حديث أفلاطون عن ضرورة احترام الدين وتقديس تعاليمه بين المثقفين والحكماء والفضلاء، فإن المساجلات والمناظرات لن تتوقف حول هذه القضية. ولعل أعنف المصاولات التي دارت بين أرباب الديانات ومنتقديها هي تلك التي سادت العصر الوسيط بعد الحملة التي شنها آباء الكنيسة على الفلسفة والفلاسفة والعلماء –بداية من القرن التاسع الميلادي- وقد عقب هذا العنف مئات السنين من الاضطهاد في معظم الثقافات بدرجات متفاوتة حتى عصر النهضة –في القرن السادس عشر- ثم حركة التنوير –في القرن الثامن عشر- التي كفرت بدين الكنيسة وأعلت من شأن العقل والعلم دون اللاهوت وظهرت عشرات المؤلفات التي تسخر من الكتب المقدسة وتتهكم على مضامينها ومعارفها وتعاليمها.
أمّا الثقافة العربية الإسلامية فلم تكن بمنأى عن هذه السنة أيضًا، أعني أن استقرار الإيمان لم يكن وليد التحاور الهادئ والجدل المحمود فحسب في معظم الأحايين، فمع تسامح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مع الأغيار في أمور العقيدة والقدر الموفور من حرية الإيمان والاعتقاد إلا أن السلطات القائمة في حقب متباينة من تاريخ الدولة الإسلامية قد جنحت إلى التعصب والتشدد والعنف مع المخالفين في أمور الدين، الأمر الذي دفع الجانحين من المتشككين والرافضين لغياب العقل في حضرة النصوص المقدّسة إلى اتهام بنية العقيدة الإسلامية بما ليس فيها مثل الجمود ومناهضة العلم والاعتداء على الحريات وتطرقوا كذلك للشك في النبوة والنصوص المقدسة وما حوته من غيبيات، وتشهد بذلك الكتابات التي حقرت من فرقة المعتزلة واتهام العقليين منهم بالكفر والمتفلسفة بالزندقة وتحريض الفقهاء للخلفاء والأمراء على الفلاسفة ودفع العوام لإحراق مصنفاتهم والترويج للمؤلفات الناقضة لأفكارهم.
وتشهد الواقعات التاريخية أن عصور الاضطهاد في الثقافة الإسلامية كانت محدودة إذا ما قورنت بعصور الظلام في الثقافة الغربية وأن سجن التسامح وتقييد الحريات لم يكن سوى مظهراً من مظاهر التخلف الحضاري والجمود الفكري الذي تولد من خلط أمور الدين برغبات السّاسة حيث المطامع والمطامح والسلطان والحفاظ على المكانة والكيان، وظل الأمر على هذا النحو في الثقافتين الغربية والإسلامية حتى أخريات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر، أقصد تلك الحقبة التي كانت بمثابة مرحلة الإعداد للمواجهة بين دعاة التدين والإيمان بالكتب المقدسة والتعاليم الربانية وأنصار الإلحاد واللا أدرية والعلم والعلمانية وفصل الدين بالكلية عن الأمور الدنيوية.
تلك كانت الصورة التي قد استقرت في أذهان المجددين في الثقافة العربية الحديثة ومنهم محمد فريد وجدي، وقد أوجزناها في السطور السابقة ليشاركنا القارئ في الحكم على محاولة فريد وجدي المشاركة في تلك المساجلات التي دارت في منتصف القرن العشرين بين المحافظين والتغريبين حيال نفس القضية التي للأسف لم نجد فيها سوى ترديد لطعون المستشرقين والجمعيات الإلحادية الغربية على لسان دعاة الإلحاد.
وقد صرّح وجدي بذلك قبل تصديه لهذه القضية ومناقشته إسماعيل أدهم وما تضمّنته رسالته لماذا أنا ملحد عام 1937م، فقد كتب محمد فريد وجدي في مقدمة مثاقفته (لماذا هو ملحد؟) ما يؤكد أنه لم يشارك في هذه المعركة الفكرية إلا لتبيان الحقيقة والدفاع بالحجة والبرهان عما يؤمن به ويثبت في الوقت نفسه تهافت معتقد مناظره وفساد رأيه، وأن كل ما دفع به خصمه لا يرقى لمستوى اليقين أو المعرفة العلمية الدقيقة، ويقول وجدي: "إن انتشار العلوم الطبيعية وما تواضعت عليه الأمم المتمدنة من إطلاق حرية الكتابة والخطابة للمفكرين في كل مجال من مجالات النشاط العقلي استدعت أن يتناول بعضهم البحث في العقائد، فنشأت معارك قلمية بين المثبتين والنافين تمحصت بسببها حقائق، وتبينت طرائق وآمن من آمن عن بينة، وألحد من ألحد على عهدته.
ونحن الآن في مصر وفي بحبوحة الحكم الدستوري، نسلك من عالم الكتابة والتفكير هذا المنهاج نفسه فلا نضيقن به ذرعاً ما دمنا نعتقد أننا على الحق المبين وأن الدليل معنا في كل مجال نجول فيه، وإن هذا التسامح الذي يدّعى أنه من ثمرات العصر الحاضر هو في الحقيقة من نفحات الإسلام نفسه ظهر به آباؤنا الأولون أيام كان لهم السلطان على العالم كله فقد كان يجتمع المتباحثون في مجلس واحد بين سنيّ ومعتزلي ومُشبّه ودهري إلخ فيتجاذبون أطراف المسائل المعضلة، فلم يزدد الدين حيال هذه الحرية العقلية إلا هيبة في النفوس وعظمة في القلوب وكرامة في التاريخ".
فقد ذهب وجدي إلى أن الكاتب - يقصد إسماعيل أدهم - لم يدفعه إلى ما ذهب إليه من تجديف وتطرف إلا أمرين، أولهما : فقدانه اهتمام الأبوين بتقويم مداركه ومشاعره وإهمال تربيته وجدانيا وعقليا، الأمر الذي جعله يشعر بأنه مجبر على قبول أشياء لم يتربى عليها في صغره وتعاليم لم يفهمها ويعي مقاصدها في صباه، في حين أن الأغيار من أقاربه لم يكلَفوا بما فُرض عليه من حفظ لكلمات لم يفطن إلى معناها وآيات لم يعي مغزاها.
وثانيهما: انجذابه للكتب الفلسفية الوضعية والنظريات العلمية المنافية لما كان يكره والموافقة لما رغب فيه. ومقصود وجدي من ذلك هو توضيح أهمية التنشئة الإسلامية على أذهان الأطفال وتنبيه التربويين على ضرورة تفهيم الصبية معاني ما يحفظونه من القرآن ومقاصد التعاليم التي يدفعونهم إليها دفعًا حتى يتضح لهم علة الترغيب والترهيب فيما يلقى عليهم من دروس ويؤمرون به من سلوك.
(٢)
حريُّ بي قبل أن أستأنف الحديث عن ما تضمّنته مثاقفة محمد فريد وجدي مع إسماعيل أدهم، أن أقوم بتحليل الواقعات المحيطة وتصريح أدهم بإلحاده وموقف رصفائه (رفقائه) محافظين كانوا أو محدثين من آرائه الصادمة وتصريحاته المجترئة. وذلك للكشف عن القدر الموفور من الحرية آنذاك لعقد مثل هذه المثاقفات، فعلى الرغم من حملة معظم المشاركين في هذه المثاقفة على الإلحاد والاجتراء على المعارف المقدّسة، إلا أن كل منهم قد التزم بأخلاقيات التناظر واحترام حرية المخالف والحرص على تطبيق الأصول الفلسفية والقواعد المنطقية للجدل، ولم يتعرّض أحد منهم للإيذاء المادي أو المعنوي إلا المتعصّبون، الأمر الذي نفتقده في جل مناظرتنا ومثاقفتنا حول أبسط المسائل التي تمس الموروث بوجه عام والمسائل الخلافية في الفقه والسياسة الشرعية والتربية الإسلامية على وجه الخصوص.
فقد وجّه إسماعيل أدهم حديثه على صفحات مجلة الإمام إلى أحرار الفكر الذين ضاقوا بالعقائد الموروثة والمعتقدات البالية والكتب المقدّسة التي حالت بين عقولهم والعلم والاستنارة والتفكير الحر والنقد والإبداع، شأنه في ذلك شأن الكتاب الغربيين الذين صاروا على نهج ديدرو (1713-1784م) وهولباخ (1723-1789م) وغيرهم من المجدفين الغربيين في جحد الدين، وشبلي شميل (1850-1917)م وعبد الحميد الزهراوي (1855-1916)م وجميل صدقي الزهاوي (1863-1936)م وفرح أنطون (1874-1922م) وسلامة موسى (1887-1958)م ومحمود عزمي (1889-1954)م وكامل الكيلاني (1897-1959)م وحسين فوزي السندباد (1900-1988)م وأضرابهم من الكتّاب العرب المجترئين، ذلك فضلا عن المفكرين الماسونيين من أمثال: أحمد زكي أبو شادي (1892-1955م)، علكسان الأرمني (؟)، فرانسيس مراش (1836-1873م)، عمر عنايت (؟)، وشاهين ماكريوس (1853-1910م)، وأمين الريحاني (1876-1940م)، الجانحين.
وها هي كلماته التي صدّر بها أول مؤلفاته (من مصادر التاريخ الإسلامي) الذي صدر عام 1936م (إلى أحرار الفكر إلى الذين حرروا الفكر من قيوده .. وجاهدوا في سبيل تحرير العقل الإنساني والمزاعم الوطنية، والذين أخذوا بيد الجماعات الإنسانية الى الحياة الصحيحة، أهدى هذا الكتاب لعلهم يجدوا فيه نظرة حرة).
ويعني ذلك أن أدهم قد أعلن انضواءه تحت مظلة العلمانيين والهراطقة والمرتابين في الدين، أي أن إعلان إلحاده لم يكن عارضاً أو وليد اضطراب وشك عقدي قد دفعته إليه بعض الكتابات الرجعية أو المفاهيم الجامدة والمعارف المكذوبة، والجدير بالإشارة في هذا السياق أن أدهم قد تدرّب على يد بعض المستشرقين الروس في إحدى الجمعيات الإلحادية السرية التي انتشرت في الغرب في الفترة من (1776 إلى 1789) تلك التي تخرج فيها معظم المروجين للفلسفات المادية في تركيا والشرق الأوسط على وجه الخصوص ولاسيما عقب ذيوع الشيوعية في روسيا عام 1917م وقبيل سقوط الخلافة العثمانية. وحسبنا ألا نستفيض في الحديث عن الملابسات والبواعث التي أحاطت بإلحاد إسماعيل أحمد أدهم، وقد تحدثنا بتوسع عن ذلك في كتابنا ثقافتنا العربية بين الإيمان والإلحاد الذي ظهرت طبعته الثالثة عام 2006.
والذي يعنينا في هذا المقام هو أن محمد فريد وجدي لم يشارك في النقود والردود التي وُجهت لرسالة إسماعيل أدهم (لماذا أنا ملحد) التي ظهرت عام 1937م للطعن فيما جاء فيها من أغاليط أو النيل من شخص كاتبها الذي تعمّد التشكيك في الثوابت العقدية، بل شرح وتوضيح علة ظاهرة الإلحاد التي تسللت إلى مصر عقب ظهور الكتابات التوراتية التركية ولاسيما كتاب قابيل آدم عن كمال أتاتورك وثورته المادية، ثم توالى ظهور الجمعيات السريّة الإلحادية بين شباب المثقفين المتشيعين للفلسفات المادية والأفكار الماركسية، ولعلّ أشهر هذه الجمعيات هي التي أطلقت على نفسها رابطة الأدب الجديد وكان مقرها مجلة العصور عام 1928.
ومن أشهر المفكرين العرب الذين قاموا بالرد على إسماعيل أدهم: أبو هاشم الصادق جابر (؟)، عبد المتعال الصعيدي، محمد عبدالغني حسن (1907-1985م)، صديق شيبوب، شارل شميل، عبداللطيف النشار (1895-1972م)، يوسف الدجوي (1870-1946م)، سامي محمد شهاب.
ويعني ذلك أن الهدف الرئيس لمقال محمد فريد وجدي (لماذا هو ملحد؟) الذي ظهر على صفحات مجلة الأزهر عام 1937م هو إلقاء الضوء على تلك الظاهرة، وإثبات أنها لم تنبت في بنية الفكر المصري، فهي في رأيه عرض لمرض لو تركناه لتفشى بين الشبيبة التي عزفت عن القراءة وتقصي الحقائق وكشف الأغاليط وفضح الأكاذيب، وهو عين الداء الذي نعاني منه الآن، وتبيان أن كل ما جاء به أدهم لم يكن سوى ترديدا لأقوال غلاة المستشرقين الذين دأبوا على محاربة الأديان بعامة والطعن في الدين الإسلامي بخاصة، وأن الإسلام ليس قيداً للعقول أو سجناً لحرية البوح بل هو ضد الأكاذيب والافتراءات التي يروج لها البعض ويتخذ منها مبرراً للمروق والتطاول على المقدّس.
فقد ذهب وجدي إلى البحث عن علة إلحاد أدهم بين الأسباب التي أفصح عنها، وأكد أنها الدافع الرئيس لكفره وارتيابه في الدين فاستشهد بكلماته عن العلم والفلسفة باعتبارهما أهم المصابيح التي أضاءت له ظلمة الغيبيات والجهالات التي كان يعيش فيها عقله قبل إعلان إلحاده، والملاحظ أن وجدي لم يناقش أدهم في علة انتصاره للعلم أو الفلسفة بل أكد على أن العلم والفلسفة ليس من موضوعاتهما الحكم على الدين، ومن ثم فمن الخطأ البحث عن الحقائق الدينية في ميادين مغايرة تماماً لطبيعته وبنيته المعرفية ومصدره، ويقول وجدي في ذلك: (إن قوله –أي أدهم- أن الأسباب التي دفعته للتخلي عن الإيمان منها ما هو علمي ومنها ما هو فلسفيّ ومنها ما هو بين بين)، قول لا نراه وجيهاً، فقد اعترف العلماء أن العلم يعجز عن إقامة دليل على نفي الصانع، وليس من وظيفة العلم البحث فيما وراء المحسوسات، والحكم بوجود شيء أو نفيه مما وراءها إلا إذا كان له في تلك المحسوسات أثر يستهدى به.
أمّا الفلسفة وهي تناول الأمور بالنظر والتفكير، فهي كما تكون سبباً في الإلحاد، تكون سبباً في الإيمان، ناهيك أن أعلام الفلاسفة أكثرهم مؤمنون".
ثم يعود وجدي إلى التأكيد ثانية على أن علة إلحاد أدهم لا تُرد في المقام الأول إلى معارفه المشوشة، بل إلى دوافع سيكولوجية ومفاسد تربوية فإهمال أبيه له وأثر إخوته المسيحيات المتهكمات على المقدس والاجتراء على المعارف الدينية من جهة، وشدة خاله في تلقينه تعاليم الإسلام وإجباره على استيعاب ما لا يطيق سوف يظل في رأي وجدي هو علة وجود هذه الظاهرة عند أدهم وتفشيها في الثقافات الرجعية، ويقول وجدي: (أمّا ما عبّر عنه الكاتب بأحوال البيئة والظروف وبأسباب سيكولوجية فهي في نظرنا هي الأسباب الحقيقة في تكوين فكرة الإلحاد عنده)، فإنه ذكر في تاريخ حياته أن أباه كان مسلماً محافظاً وأن أختيه كانتا تلقنانه الدين المسيحي وفي الوقت نفسه كانتا تهزآن بخوارق الكتب المسيحية وبخلود الروح في الحياة الآخرة، وأن زوج عمته كان يرغمه على الصلاة وحفظ القرآن. فهذه كلها عوامل تقذف بنفسية الطفل من الشذوذ إلى مكان بعيد، ولا عجب لنفس يحكم عليها أن تكون في وسط هذا التناقض ولا تشعر بانقباض شديد يحملها على طلب المخرج منه. فلما آتته نظرية الإلحاد وجد فيها الراحة التامة لضميره والثلج الكلي لصدره، فأخذ بها وتحمس لها".
كما أن قول أدهم (بأن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته، لا يمكن أن يعدو كونه رأيا، ولما كان الدكتور يكلمنا وهو في مجال العلم, فإنا نسأله كيف يمكن في عرف العلم أن يولد الرأى إيماناً راسخاً لا يقبل المناقشة؟)
وقد أستشهد وجدى برأي السير وليم كروكس الكيميائي الانجليزي (1832م إلي 1919م)، الذى صرح أثناء رئاسته للمجمع العلمي بلندن (أن الكون كله على ما ندركه نتيجة الحركات الذرية، وهذه الحركات تنطبق كل الانطباق على ناموس حفظ القوة، ولكن ما نسميه ناموساً طبيعياً هو في الحقيقة مظهر من مظاهر الاتجاه الذي يعمل على موجبة شكل من أشكال القوة، ونحن نستطيع أن نعلل الحركات الذرية كما نعلل حركات الأجرام الجسمية، ونستطيع أن نكتشف جميع النواميس الطبيعية للحركة، ولكنا مع ذلك لا نكون أقرب مما كنا عليه إلى حل أهم مسألة وهى أى نوع من أنواع الإرادة والفكر يمكن أن يوجد خلف هذا الحركات الذرية، مجبراً لهذه الحركات على اتباع طريق مرسوم لها من قبل؟
وما هى العلة العاملة التى تؤثر من خلف هذه الظواهر، وأي ازدواج من الإرادة والفكر يقود الحركة الآلية الصرفة للذرات خارجاً عن نواميسنا الطبيعية بحيث يحملها على تكوين هذا العالم المادي الذى نعيش فيه؟ ).
وقد أراد وجدى بذلك إثبات تهافت الزعم الذي تبناه أدهم بأن الكون مولد ذاتياً أو نتيجة عشوائية تحكمها المصادفة، وأستشهد كذلك بقول العالم الرياضي الفرنسي هنرى بوانكاريه (1854م إلي 1912م)، الذى أكد أن النظريات العلمية والقوانين الفيزيقية لا يمكن إدراجها ضمن اليقين المطلق بل يمكن نقدها والشك فيها تبعا للاكتشافات العلمية الأحدث.
أمّا استشهاد أدهم بإنكار الفيلسوف الألماني كانط (1724م إلي 1804م), لوجود الله وأن العقل لا يستطيع إثبات وجوده فيرى وجدى أن هذا الرأى مردوداً عليه لأن لا أدرية كانط جاءت في سياق حديثه عن العقل الخالص الذى لا يعترف إلا بالمحسوسات والموجودات التى يقبلها العقل التجريبي أما خلال حديثه عن الأخلاق والدين قد أثبت وجود الله وأهمية الإيمان وذلك عند حديثه عن العقل العملي وكذا في كتابه الدين في حدود العقل وحده.
وعقب وجدى على لسان أدهم الذى اجتزاء حديث كانط من سياقه ليوهم القارئ بأن هذا الرأى خلاصة ما أنتهي إليه كانط قائلا: (الواقع الذى ألمسه أن فكرة الله فكرة أولية، وقد أصبحت من مستلزمات الجماعات منذ ألفي سنة، ومن هنا يمكننا بكل اطمئنان أن نقول إن مقام فكرة الله الفلسفية أو مكانها في عالم الفكر الإنساني لا يرجع لما فيها من عناصر القوة الإقناعية الفلسفية وإنما يعود لحالة يسميها علماء النفس التبرير، ومن هنا فإنك لا تجد لكل الأدلة التى تقام لأجل إثبات وجود السبب الأول قيمة علمية أو عقلية. ونحن نعلم مع علماء الأديان والعقائد أن أصل فكرة الله تطورت عن حالات بدائية، وأنها شقت طريقها لعالم الفكر من حالات وهم وخوف وجهل بأسباب الأشياء الطبيعية، ومعرفتنا بأصل فكرة الله تذهب بالقدسية التى نخلعها عليها).
يضيف وجدى أن هذا الاستشهاد باطل ولا يخلو من التدليس والتقوّل وذلك لأن هذا الزعم لا يصدر عن لسان عالم فقد أثبتت الدراسات الجيولوجية أنه لا يوجد حضارة منذ أقدم العصور تنكر وجود إله أو تجحد أثر الدين على الأخلاق والسلوك:
(إنّ الأحجار المنقوشة في الهند والصين ومصر وغيرها تدل على أن تلك الأمم قبل ستة ألاف سنة كانت متدينة على أشدّ ما يمكن أن يكون، وكان للدين السلطان المطلق عليها حتى كان الحكم فيها قبل نشوء الملكية للكهنة والرهبان).
أما زعم أدهم بأن فكرة الله لا تتضمن قوة إقناعية فإن إيمان معظم العلماء والفلاسفة بوجود الله خير رداً على ذلك. كما أن الفلسفات المادية لم تستطع تقديم برهان يقيني على مزعمها تجاه وجود مدبر للكون .
وهل يعقل أن أفلاطون وبرجسون وغيرهما من مئات الفلاسفة لم يفطنو أن فكرة الله وهم كما يدعي أصحاب الفلسفات المادية والجمعات الإلحادية؟
(وللحديث بقيّة)
بقلم : د. عصمت نصّار