قراءة في كتاب
وسام حسين العبيدي: قراءة النصوص الدينية في سياق الكرامة والحرية في كتاب: الدين والظمأ الأنطولوجي

لعلَّ كثرة المقالات، التي تجاوزت 200 مقالة حتى اليوم، ودار كتّابها ولهى حول كتاب: «الدين والظمأ الأنطولوجي»، بوصفه من الكتب التي أمتعتْ وأفادت قارئيها، في قراءة المسألة الدينية قراءة معاصرة، لم تدع المزيد من القول لمن يريد الكتابة عن هذا الكتاب، فما يُراد أن يُقال، قد قيل فيها، ولعلَّ هذا التصوُّر صحيح، في ما لو تمّت مراجعتها بدقّة، ففيها الكثير من التوصّلات التي اتّفق أصحابها عليها بشأن هذا الكتاب ومؤلفه عبد الجبار الرفاعي. وقد لا أجد ثمّة موجبا لي يسوِّغ الكتابةَ عن هذا الكتاب، إلا إذا أردتُ الانطلاق من مُمهِّدات تُتيح لي مخرجا من هذا المأزق، من حيث التلقّي، بوصفهِ يتغايرُ من شخصٍ لآخر، حسب المرجعيات المعرفية التي تُحدِّد جنس النص المقروء، وترسيم حدوده الأجناسية بما يُميِّزُه عن سواه.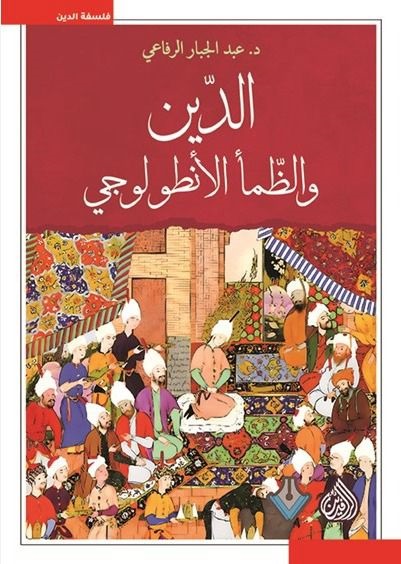
ومن هنا أجد في هذا الكتاب، منطلقات تسمح لي أنْ أصِف متنَ هذا الكتاب، بأنه يمثِّل نصّا في الرحلة، بمعنى أنَّه يدخل ضمن «أدب الرحلة»، ذلك الأدب الذي يدور حول مشاهداتٍ ينقلها لنا الرحّالة عبر مدوّناتهم، والرفاعي في كتابه «الدين والظمأ الأنطولوجي» كان رحّالة لا على النحو المعتاد عند الرحّالة، إذ يدوّنون لنا مشاهداتهم في الأماكن التي حلّوا فيها، أو التي ارتحلوا إليها، ينقلون لنا عادات وتقاليد وقيم الجماعات التي اختلطوا بها، بل كان رحّالة يجوب في فضاء الذات، وأقاليم المعرفة التي حطَّ فيها ركابه، مستخلصا لقارئه في كلِّ تلك الرحلات الذاتية والمعرفية، دروسا يضعها بين يدي قارئه، عسى أنْ يستفيد منها، ولا يعيد الكرّة التي هدرت من عمر المؤلِّف الرفاعي الكثير، فكان له أنْ يجوب في طيات الذاكرة، في مواقف كانت له في مراحل مختلفة من حياته، منذ نعومة أظفاره، وصولا إلى ما انتهى إليه، وقد لا يُخفي ضيق ذرعه مما كان عليه في السابق من تجارب ومواقف لمن مرّ بهم من أشخاص أو مؤسسات، كان لها الأثر في تحجيم الذات وتقييد إرادتها، ما جعله يُمهِّد لهذا الموقف النقدي من تلكم التجارب في حديثه في بداية كتابه عن (نسيان الذات) محترزا ومتحرِّزا في بداية هذا الفصل من سوء الفهم الذي يطال تحديد دلالة الذات، بما يريد الحديث عنه، وهي الذات الفردية «التي هي قوام الحياة الباطنية للكائن البشري، فمن دونها يفتقد كل إنسان ذاته، ويصير نسخة مكرَّرة متطابقة مع نموذجٍ مُحدَّدٍ مُصاغٍ سلفا، وتجري (نمذجة) الكل في سياق صفات ذلك النموذج وسماته وخصائصه، وكأنَّ الجميع يُسكَبون في قوالب مُتماثلة، تُلغى فيها اختلافاتهم وتمايزاتهم، وتُمحى البصمةُ الشخصية لكلٍّ منهم. هنا يتنازل الفرد عن ذاته، ولا يكون سوى بوقٍ يتردَّدُ فيه صدى أصواتِ الآخرين، فيما يختفي صوتُهُ الخاص». في هذا التوضيح أراد الرفاعي من ورائه إيصال رسالةٍ معرفيةٍ توجز كل ما قطعه من أسفار معرفية خاضها في حياته، وهي الحرّية التي ينبغي لها أنْ تتحقّقَ فيها الذات، الذات لا يرى لها وجودا ولا صيرورة إلا عبر ما تُحقِّقهُ من حرِّيةٍ وتتحقّقَ فيه، وهي في منظوره ليست أمرا ناجزا يمكن أنْ يأخذ أثره بمجرّد التعرّف عليه نظريّا؛ لأنَّ «وجود الحرية يعني ممارستها. الحرية لا تتحقّق بعيدا عن مسؤولية الفرد تجاه ذاته. لحظة تنتفي الحرية تنتفي الذات، إذ لا تغتني الذات وتتّسع وتتكامل إلا بالحرّية». وهو إذ يؤكِّد ما للحرية من أثرٍ في تحقيق الذات، فإنه يُدرك في الوقت نفسه ما للعبوديةِ من هيمنةٍ على مسيرة الإنسان بصورةٍ عامة، في جعله مُكبّلا في مواقفه وآرائه لآخرين، معبّرا عن تلك العلاقة الضِدِّية بالجدل الذي لا ينتهي بين المقولتين، إلا أنَ الطريف في نظرته لتلك الجدلية العقيمة، أنّه ذهب إلى ما ورائها، باستنتاجه «أنَّ هذا الجدل هو مصدر الحركة، ومولِّد الطاقة لاستمرار الحياة. وكأنَّ هذا الكائن مجبورٌ في حرّيته، بقدر ما هو مجبورٌ في عبوديّته، ذلك أنَّ الكائن البشري في توقٍ أبديٍّ للحرية، فهو لا يكون إلا بالحرية. لو لم تطارده عبوديته على الدوام فلن يتطلع للحرية، الحريةُ بطبيعتها في صراعٍ أبديٍّ مع العبوديّة»، هذه النظرةُ الإيجابية للعبودية بوصفها واقعا تاريخيّا مر على البشرية وما زال، لا يعني الارتهان إليه، بمقدار الانطلاق منه إلى ما يُحقِّق للذات وجودا وهويّة، وأعني به الحرّية. وهي تُذكِّرنا بالنظرة الإنسانية التي أشار لها الكثير من المدوّنات في الأديان السماوية أو الوضعية، ولعل واحدة من مقولات شمس الدين التبريزي وهي: (لولا المرض ما عرفنا الصحة، ولولا الظلام ما عرفنا النور، ولولا المعاناة ما عرفنا السعادة، ولولا الفراق ما عرفنا الحب)، تُذكِّرنا بفحوى ما أشار إليه الرفاعي في نظرته الإيجابية لتلك العلاقة الجدلية بين مقولتي الحرية والعبودية، إلا أنه لا يكتفي في بيان هذه النظرة الإيجابية، فيضع لنا اشتراطات الحرّية وما ينبغي تمهيده لتحقيقها، وما تؤدِّي إليه من مآلات، وكأنه ينفي مسبقا سوء الفهم لمن يتصوَّر عبر هذه الجدلّية أنَّ كلا المقولتين متوازنتان قوّة وتمثّلا وتأثيرا، وذلك في قوله: «الحريةُ أشَقُّ من العبوديّة؛ ذلك أنّها: إرادةٌ، وحضورٌ، واستقلالٌ، وشجاعةٌ، ومسؤوليةٌ، وخيارٌ إيمانيٌّ، وموقفٌ حيال الوجود. أنْ تكون حُرّا فهو يعني أنَّكَ تُواجهُ العالمَ كلَّهُ، وتتحمَّلُ كلَّ شيءٍ وحدَكَ، العبوديّةُ: هشاشةٌ، وغيابٌ، واستقالةٌ، وخضوعٌ، وانقيادٌ، وتفرُّجٌ، وتبعيَّةٌ، ولا موقف، ولا أباليّةٌ، ولا مسؤوليةٌ. أنْ تكونَ عبدا يعني أنَّكَ لستَ مسؤولا عن أيِّ شيءٍ، حتّى عن نفسِكَ». هذه اللغة البيانية الشفيفة التي تذكِّرنا بخطاب الفرنسي إيتيان دو لابوسي في كتابه الشهير: «مقالة العبودية الطوعية» وهو يفرِّق بين الحرِّية والعبودية، من حيث أثر كلِّ واحدٍ منهما على من يتمثّلهما سلوكا وموقفا في حياته، بقوله: «إنَّ الشجعان لا يهابون الخطر أبدا في سبيل نيل الخير الذي يبتغون، ولا يرفض ذوو الفطنة مكابدة المشقَّة مطلقا، أما الجُبناء والخاملون، فلا يعرفون مكابدة الألم ولا السعي إلى الخير، فيقفون من المكارم عند التمنِّي، أما فضيلة الإرادة فمنتَزَعةٌ منهم بسبب تخاذلهم. وأَمَّا الرغبةُ في الخيرِ فتظلُّ لديهم بفعل الطبيعة، تلك الرغبة، بل تلك الإرادة المشتركةٌ بين الحكماء والأغبياء، وبين الشجعان والجبناء، للتوق إلى كلِّ الأشياء التي تجعلهم، باكتسابها، سعداء ومغتبطين: يبقى شيءٌ واحدٌ لا يقوى الناس على تمنِّيه، ولا أدري لماذا؟ إنه الحرِّية، وهي نعمةٌ كبيرةٌ ومُمتِعةٌ جدّا، فإذا فُقِدَت تتوالى الويلات، وتفقد النِعَمُ بعدها كلَّ طعمها ومذاقها، لأنَّ العبوديّةَ أفسَدَتها».
وعودة إلى ما انتهى إليه الرفاعي أعلاه، نجده يُلخِّص بإيجاز، سبب اختيار العبودية، على ما فيها من مآلات وخيمة على الذات، تعصف بوجودها الواعي المُدرَك، بأنَّ «الناس بطبيعتهم ينفرون من التفكير، ومن كلِّ ما يُوقظ العقلَ من سُباته، لذلك يُفتِّشونَ على الدوام عمَّن يُفكِّرُ عنهم بالنيابة، فيعودونَ في كلِّ شيءٍ يسيرٍ أو خطيرٍ في حياتهم إلى منْ ينوبُ عن عقلهم. من لا يُدرِّبُ عقلَهُ على التفكير لن يتعلَّمَ الاستقلالَ في التفكير. لا نتعلمُ التفكيرَ إلا بالإدمانِ على التفكير»، وهي الحقيقة التي أراد الرفاعي استظهارها في كلِّ ما خاضَ فيه من مواقف وتجاربَ عبر محطّات حياته التي يعرفُها من خبرَ سيرته عن قرب، ما جعله وفقا لتلك النتيجة أنْ يخرجَ من طوق الجماعات التي آمنَ بطروحاتها في المرحلة العمرية المبكرة من حياته، محافظا على ما تبقّى من ذاته، بل مُعيدا صياغتها وفقا لتراكمٍ من التجارب الثريّة بالدروس، مرتحلا إلى خطابٍ إنسانيٍّ داخل المنظومة القيمية الإسلامية، أرحبَ من خطاب تلكم الجماعات، وهو خطابٌ يرحِّلُ فكرة الجماعة/ المذهب/ الفرقة الناجية، إلى غير رجعة من منطلقات أفكاره التي يسعى لترويجها الآن، في ما صدر عنه من مؤلفات، لأنَّه لا يرى في أدبيات الجماعات والأحزاب مهما اختلفت توجّهاتها سوى نسخةٍ واحدةٍ تتكرّر من حيث المضمون الذي يُكرِّس ذوبان الذات في الجماعة: «أما قيمة الفرد، ومكانتُهُ، وحاجاتُه الذاتية، الروحيّة، والعاطفية، والوجدانيّة، والعقليّةُ، فلا أهميّةَ لها، إلا في سياق تموضعها في إطار هذا المركَّب، الذي هو الجماعة ومتطلّباتُها»، وهذا ما يسعى الرفاعيِّ إلى مناهضته بكلِّ ما أوتِيَ من ثراءٍ معرفيٍّ أتاح له الخوضُ بعُمقٍ ودراية في مثابات متنوِّعة في مجالاتها المعرفية لكشفِ الباطن النفسي، والتمظهر الاجتماعي عند ممثِّلي تلك الجماعات في القديم والحديث، فضلا عن استعراض مواقف من سيرته تكشف لنا ما كان لتلك السيرة من أثرٍ عميق في تشكيل الذات وصياغتها، بما جعل كتابه رحلة تجمع بين المعرفيِّ والجغرافي منها، ويُقدِّمُ لنا من خلالها ضروبا من الخلاصات الضرورية لقراءة الدين ونصوصه في سياق يحفظ كرامة الإنسان وحريته، ولا يسحق الذات في التخندق الهويّاتي بعيدا عن روح الدين. لعل هذه الفكرةَ هي الأساس في هذا الكتاب.
***
د. وسام حسين العبيدي
أكاديمي عراقي، أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة بابل في العراق.







